الميزان في تفسير القرآن سورة البقرة 153 – 157
18 سبتمبر,2018
القرآن الكريم, صوتي ومرئي متنوع
2,234 زيارة
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)
بيان
خمس آيات متحدة السياق، متسقة الجمل، ملتئمة المعاني، يسوق أولها إلى آخرها و يرجع آخرها إلى أولها، و هذا يكشف عن كونها نازلة دفعة غير متفرقة، و سياقها ينادي بأنها نزلت قبيل الأمر بالقتال و تشريع حكم الجهاد، ففيه ذكر من بلاء سيقبل على المؤمنين، و مصيبة ستصيبهم، و لا كل بلاء و مصيبة، بل البلاء العمومي الذي ليس بعادي الوقوع مستمر الحدوث، فإن نوع الإنسان كسائر الأنواع الموجودة في هذه النشأة الطبيعية لا يخلو في أفراده من حوادث جزئية يختل بها نظام الفرد في حياته الشخصية: من موت و مرض و خوف و جوع و غم و حرمان، سنة الله التي جرت في عباده و خلقه، فالدار دار التزاحم، و النشأة نشأة التبدل و التحول، و لن تجد لسنة الله تحويلا و لن تجد لسنة الله تبديلا.
و البلاء الفردي و إن كان شاقا على الشخص المبتلى بذلك، مكروها، لكن ليس مهولا مهيبا تلك المهابة التي تتراءى بها البلايا و المحن العامة، فإن الفرد يستمد في قوة تعقله و عزمه و ثبات نفسه من قوى سائر الأفراد، و أما البلايا العامة الشاملة فإنها تسلب الشعور العمومي و جملة الرأي و الحزم و التدبير من الهيأة المجتمعة، و يختل به نظام الحياة منهم، فيتضاعف الخوف و تتراكم الوحشة و يضطرب عندها العقل و الشعور و تبطل العزيمة و الثبات، فالبلاء العام و المحنة الشاملة أشق و أمر، و هو الذي تلوح له الآيات.
و لا كل بلاء عام كالوباء و القحط بل بلاء عام قربتهم منها أنفسهم، فإنهم أخذوا دين التوحيد، و أجابوا دعوة الحق، و تخالفهم فيه الدنيا و خاصة قومهم، و ما لهؤلاء هم إلا إطفاء نور الله، و استيصال كلمة العدل، و إبطال دعوة الحق، و لا وسيلة تحسم مادة النزاع و تقطع الخلاف غير القتال، فسائر الوسائل كإقامة الحجة و بث الفتنة، و إلقاء الوسوسة و الريبة و غيرها صارت بعد عقيمة غير منتجة، فالحجة مع النبي و الوسوسة و الفتنة و الدسيسة ما كانت تؤثر أثرا تطمئن إليه أعداء الدين فلم يكن عندهم وسيلة إلا القتال و الاستعانة به على سد سبيل الحق، و إطفاء نور الدين اللامع المشرق.
هذا من جانب الكفر، و الأمر من جانب الدين أوضح، فلم يكن إلى نشر كلمة التوحيد، و بث دين الحق، و حكم العدل، و قطع دابر الباطل وسيلة إلا القتال، فإن التجارب الممتدة من لدن كان الإنسان نازلا في هذه الدار يعطي أن الحق إنما يؤثر إذا أميط الباطل، و لن يماط إلا بضرب من أعمال القدرة و القوة.
و بالجملة ففي الآيات تلويح إلى إقبال هذه المحنة بذكر القتل في سبيل الله، و توصيفه بوصف لا يبقى فيه معه جهة مكروهة، و لا صفة سوء، و هو أنه ليس بموت بل حياة، و أي حياة! فالآيات تستنهض المؤمنين على القتال، و تخبرهم أن أمامهم بلاء و محنة لن تنالوا مدارج المعالي، و صلاة ربهم و رحمته، و الاهتداء بهدايته إلا بالصبر عليها، و تحمل مشاقها، و يعلمهم ما يستعينون به عليها، و هو الصبر و الصلاة، أما الصبر: فهو وحدة الوقاية من الجزع و اختلال أمر التدبير، و أما الصلاة: فهي توجه إلى الرب، و انقطاع إلى من بيده الأمر، و أن القوة لله جميعا.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلوة إن الله مع الصابرين الآية، قد تقدم جملة من الكلام في الصبر و الصلاة في تفسير قوله: «و استعينوا بالصبر و الصلوة و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين»: البقرة – 45 و الصبر من أعظم الملكات و الأحوال التي يمدحها القرآن، و يكرر الأمر به حتى بلغ قريبا من سبعين موضعا من القرآن حتى قيل فيه: «إن ذلك من عزم الأمور»: لقمان – 17، و قيل: «و ما يلقيها إلا الذين صبروا و ما يلقيها إلا ذو حظ عظيم»: فصلت – 35، و قيل: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»: الزمر – 10.
و الصلاة: من أعظم العبادات التي يحث عليها في القرآن حتى قيل فيها: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر»: العنكبوت – 45، و ما أوصى الله في كتابه بوصايا إلا كانت الصلاة رأسها و أولها.
ثم وصف سبحانه الصبر بأن الله مع الصابرين المتصفين بالصبر، و إنما لم يصف الصلاة، كما في قوله تعالى: و استعينوا بالصبر و الصلوة و إنها لكبيرة الآية، لأن المقام في هذه الآيات، مقام ملاقات الأهوال، و مقارعة الأبطال، فالاهتمام بأمر الصبر أنسب بخلاف الآية السابقة، فلذلك قيل: إن الله مع الصابرين، و هذه المعية غير المعية التي يدل عليه قوله تعالى: «و هو معكم أينما كنتم»: الحديد – 4، فإنها معية الإحاطة و القيمومة، بخلاف المعية مع الصابرين، فإنها معية إعانة فالصبر مفتاح الفرج.
قوله تعالى: و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء و لكن لا تشعرون الآية، ربما يقال: إن الخطاب مع المؤمنين الذين آمنوا بالله و رسوله و اليوم الآخر و أذعنوا بالحياة الآخرة، و لا يتصور منهم القول ببطلان الإنسان بالموت، بعد ما أجابوا دعوة الحق و سمعوا شيئا كثيرا من الآيات الناطقة بالمعاد، مضافا إلى أن الآية إنما تثبت الحياة بعد الموت في جماعة مخصوصين، و هم الشهداء المقتولون في سبيل الله، في مقابل غيرهم من المؤمنين، و جميع الكفار، مع أن حكم الحياة بعد الموت عام شامل للجميع فالمراد بالحياة بقاء الاسم، و الذكر الجميل على مر الدهور، و بذلك فسره جمع من المفسرين.
و يرده أولا: أن كون هذه حياة إنما هو في الوهم فقط دون الخارج، فهي حياة تخيلية ليس لها في الحقيقة إلا الاسم، و مثل هذا الموضوع الوهمي لا يليق بكلامه، و هو تعالى يدعو إلى، الحق و يقول: «فما ذا بعد الحق إلا الضلال»: يونس – 32، و أما الذي سأله إبراهيم في قوله «و اجعل لي لسان صدق في الآخرين»: الشعراء – 84، فإنما يريد به بقاء دعوته الحقة، و لسانه الصادق بعده، لا حسن ثنائه و جميل ذكره بعده فحسب.
نعم هذا القول الباطل، و الوهم الكاذب إنما يليق بحال الماديين، و أصحاب الطبيعة، فإنهم اعتقدوا: مادية النفوس و بطلانها بالموت و نفوا الحياة الآخرة ثم أحسوا باحتياج الإنسان بالفطرة إلى القول ببقاء النفوس و تأثرها بالسعادة و الشقاء، بعد موتها في معالي أمور، لا تخلو في الارتقاء إليها من التفدية و التضحية، لا سيما في عظائم العزائم التي يموت و يقتل فيها أقوام ليحيا و يعيش آخرون، و لو كان كل من مات فقد فات لم يكن داع للإنسان و خاصة إذا اعتقد بالموت و الفوت أن يبطل ذاته ليبقى ذات آخرين، و لا باعث له أن يحرم على نفسه لذة الاستمتاع من جميع ما يقدر عليه بالجور ليتمتع آخرون بالعدل، فالعاقل لا يعطي شيئا إلا و يأخذ بدله و أما الإعطاء من غير بدل، و الترك من غير أخذ، كالموت في سبيل حياة الغير، و الحرمان في طريق تمتع الغير فالفطرة الإنسانية تأباه، فلما استشعروا بذلك دعاهم جبر هذا النقص إلى وضع هذه الأوهام الكاذبة، التي ليس لها موطن إلا عرصة الخيال و حظيرة الوهم، قالوا إن الإنسان الحر من رق الأوهام و الخرافات يجب عليه أن يفدي بنفسه وطنه، أو كل ما فيه شرفه، لينال الحياة الدائمة بحسن الذكر و جميل الثناء، و يجب عليه أن يحرم على نفسه بعض تمتعاته في الاجتماع ليناله الآخرون، ليستقيم أمر الاجتماع و الحضارة، و يتم العدل الاجتماعي فينال بذلك حياة الشرف و العلاء.
و ليت شعري إذا لم يكن إنسان، و بطل هذا التركيب المادي، و بطل بذلك جميع خواصه، و من جملتها الحياة و الشعور، فمن هو الذي ينال هذه الحياة و هذا الشرف؟ و من الذي يدركه و يلتذ به؟ فهل هذا إلا خرافة؟.
و ثانيا: أن ذيل الآية – و هو قوله تعالى: و لكن لا تشعرون، – لا يناسب هذا المعنى، بل كان المناسب له أن يقال: بل أحياء ببقاء ذكرهم الجميل، و ثناء الناس عليهم بعدهم، لأنه المناسب لمقام التسلية و تطييب النفس.
و ثالثا: أن نظيرة هذه الآية – و هي تفسرها – وصف حياتهم بعد القتل بما ينافي هذا المعنى، قال تعالى: «و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»: آل عمران – 196، إلى آخر الآيات و معلوم أن هذه الحياة حياة خارجية حقيقية ليست بتقديرية.
و رابعا: أن الجهل بهذه الحياة التي بعد الموت ليس بكل البعيد من بعض المسلمين في أواسط عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن الذي هو نص غير قابل للتأويل إنما هو البعث للقيامة، و أما ما بين الموت إلى الحشر – و هي الحياة البرزخية – فهي و إن كانت من جملة ما بينه القرآن من المعارف الحقة، لكنها ليست من ضروريات القرآن، و المسلمون غير مجمعين عليه بل ينكره بعضهم حتى اليوم ممن يعتقد كون النفس غير مجردة عن المادة و أن الإنسان يبطل وجوده بالموت و انحلال التركيب، ثم يبعثه الله إلى القضاء يوم القيامة، فيمكن أن يكون المراد بيان حياة الشهداء في البرزخ لمكان جهل بعض المؤمنين بذلك، و إن علم به آخرون.
و بالجملة: المراد بالحياة في الآية الحياة الحقيقية دون التقديرية، و قد عد الله سبحانه حياة الكافر بعد موته هلاكا و بوارا في مواضع من كلامه، كقوله تعالى: «و أحلوا قومهم دار البوار»: إبراهيم – 28، إلى غير ذلك من الآيات، فالحياة حياة السعادة، و الإحياء بهذه الحياة المؤمنون خاصة كما قال: «و أن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون»: العنكبوت – 64، و إنما لم يعلموا، لأن حواسهم مقصورة على إدراك خواص الحياة في المادة الدنيوية، و أما ما وراءها فإذا لم يدركوه لم يفرقوا بينه و بين الفناء فتوهموه فناء، و ما توهمه الوهم مشترك بين المؤمن و الكافر في الدنيا، فلذلك قال: في هذه الآية، بل أحياء و لكن لا تشعرون أي: بحواسكم، كما قال في الآية الأخرى: لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي باليقين كما قال تعالى: «كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم»: التكاثر – 6.
فمعنى الآية – و الله أعلم – و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، و لا تعتقدوا فيهم الفناء و البطلان كما يفيده لفظ الموت عندكم، و مقابلته مع الحياة، و كما يعين على هذا القول حواسكم فليسوا بأموات بمعنى البطلان، بل أحياء و لكن حواسكم لا تنال ذلك و لا تشعر به، و إلقاء هذا القول على المؤمنين – مع أنهم جميعا أو أكثرهم عالمون ببقاء حياة الإنسان بعد الموت، و عدم بطلان ذاته – إنما هو لإيقاظهم و تنبيههم بما هو معلوم عندهم، يرتفع بالالتفات إليه الحرج عن صدورهم، و الاضطراب و القلق عن قلوبهم إذا أصابتهم مصيبة القتل، فإنه لا يبقى مع ذلك من آثار القتل عند أولياء القتيل إلا مفارقة في أيام قلائل في الدنيا و هو هين في قبال مرضاة الله سبحانه و ما ناله القتيل من الحياة الطيبة، و النعمة المقيمة، و رضوان من الله أكبر، و هذا نظير خطاب النبي بمثل قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الآية، مع أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أول الموقنين بآيات ربه، و لكنه كلام كني به عن وضوح المطلب، و ظهوره بحيث لا يقبل أي خطور نفساني لخلافه.
نشأة البرزخ
فالآية تدل دلالة واضحة على حياة الإنسان البرزخية، كالآية النظيرة لها و هي قوله: «و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»: آل عمران – 169، و الآيات في ذلك كثيرة.
و من أعجب الأمر ما ذكره بعض الناس في الآية: أنها نزلت في شهداء بدر، فهي مخصوصة بهم فقط، لا تتعداهم إلى غيرهم هذا، و لقد أحسن بعض المحققين: من المفسرين في تفسير قوله: و استعينوا بالصبر و الصلاة الآية، إذ سئل الله تعالى الصبر على تحمل أمثال هذه الأقاويل.
و ليت شعري ما ذا يقصده هؤلاء بقولهم هذا؟ و على أي صفة يتصورون حياة شهداء بدر بعد قتلهم مع قولهم: بانعدام الإنسان بعد الموت و القتل، و انحلال تركيبه و بطلانه؟ أ هو على سبيل الإعجاز: باختصاصهم من الله بكرامة لم يكرم بها النبي الأكرم و سائر الأنبياء و المرسلين و الأولياء المقربين، إذ خصهم الله ببقاء وجودهم بعد الانعدام، فليس ذلك بإعجاز بل إيجاد محال ضروري الاستحالة، و لا إعجاز في محال، و لو جاز عند العقل إبطال هذا الحكم على بداهتها لم يستقم حكم ضروري فما دونه؟ أم هو على نحو الاستثناء في حكم الحس بأن يكون الحس مخطئا في أمر هؤلاء الشهداء؟ فهم أحياء يرزقون بالأكل و الشرب و سائر التمتعات – و هم غائبون عن الحس – و ما ناله الحس من أمرهم بالقتل و قطع الأعضاء و سقوط الحس و انحلال التركيب فقد أخطأ في ذلك من رأس، فلو جاز على الحس أمثال هذه الأغلاط فيصيب في شيء و يغلط في آخر من غير مخصص بطل الوثوق به على الإطلاق، و لو كان المخصص هو الإرادة الإلهية احتاج تعلقها إلى مخصص آخر، و الإشكال – و هو عدم الوثوق بالإدراك على حاله، فكان من الجائز أن نجد ما ليس بواقع واقعا و الواقع ليس بواقع، و كيف يرضى عاقل أن يتفوه بمثل ذلك؟ و هل هو إلا سفسطة؟.
و قد سلك هؤلاء في قولهم هذا مسلك العامة من المحدثين، حيث يرون أن الأمور الغائبة عن حواسنا مما يدل عليه الظواهر الدينية من الكتاب و السنة، كالملائكة و أرواح المؤمنين و سائر ما هو من هذا القبيل موجودات مادية طبيعية، و أجسام لطيفة تقبل الحلول و النفوذ في الأجسام الكثيفة، على صورة الإنسان و نحوه، يفعل جميع الأفعال الإنسانية مثلا، و لها أمثال القوى التي لنا غير أنها ليست محكومة بأحكام الطبيعة: من التغير و التبدل و التركيب و انحلاله، و الحياة و الموت الطبيعيتين، فإذا شاء الله تعالى ظهورها ظهرت لحواسنا، و إذا لم يشأ أو شاء أن لا تظهر لم تظهر، مشية خالصة من غير مخصص في ناحية الحواس، أو تلك الأشياء.
و هذا القول منهم مبني على إنكار العلية و المعلولية بين الأشياء، و لو صحت هذه الأمنية الكاذبة بطلت جميع الحقائق العقلية، و الأحكام العلمية، فضلا عن المعارف الدينية و لم تصل النوبة إلى أجسامهم اللطيفة المكرمة التي لا تصل إليها يد التأثير و التأثر المادي الطبيعي، و هو ظاهر.
فقد تبين بما مر: أن الآية دالة على الحياة البرزخية، و هي المسماة بعالم القبر، عالم متوسط بين الموت و القيامة، ينعم فيه الميت أو يعذب حتى تقوم القيامة.
و من الآيات الدالة عليه – و هي نظيرة لهذه الآية الشريفة – قوله تعالى: «و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم و لا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله و فضل و أن الله لا يضيع أجر المؤمنين»: آل عمران – 171، و قد مر تقريب دلالة الآية على المطلوب، و لو تدبر القائل باختصاص هذه الآيات بشهداء بدر في متن الآيات لوجد أن سياقها يفيد اشتراك سائر المؤمنين معهم في الحياة، و التنعم بعد الموت.
و من الآيات قوله تعالى: «حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون»: المؤمنون – 100، و الآية ظاهرة الدلالة على أن هناك حياة متوسطة بين حياتهم الدنيوية و حياتهم بعد البعث، و سيجيء تمام الكلام في الآية إن شاء الله تعالى.
و من الآيات قوله تعالى: «و قال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم و عتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة» و من المعلوم أن المراد به أول ما يرونهم و هو يوم الموت كما تدل عليه آيات أخر «لا بشرى يومئذ للمجرمين و يقولون حجرا محجورا. و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و أحسن مقيلا. و يوم تشقق السماء بالغمام و هو يوم القيامة و نزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن و كان يوما على الكافرين عسيرا: الفرقان – 26، و دلالتها ظاهرة.
و سيأتي تفصيل القول فيها في محله إن شاء الله تعالى.
و من الآيات قوله تعالى: «قالوا ربنا أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل»: المؤمن – 11، فهنا إلى يوم البعث – و هو يوم قولهم هذا – إماتتان و إحيائان، و لن تستقيم المعنى إلا بإثبات البرزخ، فيكون إماتة و إحياء في البرزخ و إحياء في يوم القيامة، و لو كان أحد الإحيائين في الدنيا و الآخر في الآخرة لم يكن هناك إلا إماتة واحدة من غير ثانية، و قد مر كلام يتعلق بالمقام في قوله تعالى: «كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتا فأحياكم»: البقرة – 28 فارجع.
و من الآيات قوله تعالى: «و حاق بآل فرعون سوء العذاب النار. يعرضون عليها غدوا و عشيا و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب»: المؤمن – 46، إذ من المعلوم أن يوم القيامة لا بكرة فيه و لا عشي فهو يوم غير اليوم.
و الآيات التي تستفاد منها هذه الحقيقة القرآنية، أو تومىء إليها كثيرة، كقوله تعالى: «تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم و لهم عذاب أليم»: النحل – 63، إلى غير ذلك.
تجرد النفس
و يتبين بالتدبر في الآية، و سائر الآيات التي ذكرناها حقيقة أخرى أوسع من ذلك، و هي تجرد النفس، بمعنى كونها أمرا وراء البدن و حكمها غير حكم البدن و سائر التركيبات الجسمية، لها نحو اتحاد بالبدن تدبرها بالشعور و الإرادة و سائر الصفات الإدراكية، و التدبر في الآيات السابقة الذكر يجلي هذا المعنى فإنها تفيد أن الإنسان بشخصه ليس بالبدن، لا يموت بموت البدن، و لا يفنى بفنائه، و انحلال تركيبه و تبدد أجزائه، و أنه يبقى بعد فناء البدن في عيش هنيء دائم، و نعيم مقيم، أو في شقاء لازم، و عذاب أليم، و أن سعادته في هذه العيشة، و شقاءه فيها مرتبطة بسنخ ملكاته و أعماله، لا بالجهات الجسمانية و الأحكام الاجتماعية.
فهذه معان تعطيها هذه الآيات الشريفة، و واضح أنها أحكام تغاير الأحكام الجسمانية، و تتنافى الخواص المادية الدنيوية من جميع جهاتها، فالنفس الإنسانية غير البدن.
و مما يدل عليه من الآيات قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يرسل الأخرى»: الزمر – 42، و التوفي و الاستيفاء هو أخذ الحق بتمامه و كماله، و ما تشتمل عليه الآية: من الأخذ و الإمساك و الإرسال ظاهر في المغايرة بين النفس و البدن.
و من الآيات قوله تعالى: «و قالوا أ إذا ضللنا في الأرض أ إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون»: السجدة – 11، ذكر سبحانه شبهة من شبهات الكفار المنكرين للمعاد، و هو أنا بعد الموت و انحلال تركيب أبداننا تتفرق أعضاؤنا، و تبدد أجزاؤنا، و تتبدل صورنا فنضل في الأرض، و يفقدنا حواس المدركين، فكيف يمكن أن نقع ثانيا في خلق جديد؟ و هذا استبعاد محض، و قد لقن تعالى على رسوله: الجواب عنه، بقوله: قل: يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم الآية، و حاصل الجواب أن هناك ملكا موكلا بكم هو يتوفاكم و يأخذكم، و لا يدعكم تضلوا و أنتم في قبضته و حفاظته، و ما تضل في الأرض إنما هو أبدانكم لا نفوسكم التي هي المدلول عليها بلفظ كم فإنه يتوفاكم.
و من الآيات قوله تعالى: «و نفخ فيه من روحه» الآية: السجدة – 9، ذكره في خلق الإنسان ثم قال تعالى: «يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي»: الإسراء – 85، فأفاد أن الروح من سنخ أمره، ثم عرف الأمر في قوله تعالى: «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء»: يس – 83 فأفاد أن الروح من الملكوت، و أنها كلمة كن ثم عرف الأمر بتوصيفه بوصف آخر بقوله: «و ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر»: القمر – 50، و التعبير بقوله: كلمح بالبصر يعطي أن الأمر الذي هو كلمة كن موجود دفعي الوجود غير تدريجية، فهو يوجد من غير اشتراط وجوده و تقييده بزمان أو مكان، و من هنا يتبين أن الأمر – و منه الروح شيء غير جسماني و لا مادي فإن، الموجودات المادية الجسمانية من أحكامها العامة أنها تدريجية الوجود، مقيدة بالزمان و المكان، فالروح التي للإنسان ليست بمادية جسمانية، و إن كان لها تعلق بها.
و هناك آيات تكشف عن كيفية هذا التعلق، فقد قال تعالى: «منها خلقناكم»: طه – 55، و قال تعالى: «خلق الإنسان من صلصال كالفخار»: الرحمن – 14 و قال تعالى «و بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين»: السجدة – 8، ثم قال: سبحانه و تعالى «و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين»: المؤمنون – 14، فأفاد أن الإنسان لم يكن إلا جسما طبيعيا يتوارد عليه صور مختلفة متبدلة، ثم أنشأ الله هذا الذي هو جسم جامد خامد خلقا آخر ذا شعور و إرادة، يفعل أفعالا: من الشعور و الإرادة و الفكر و التصرف في الأكوان، و التدبير في أمور العالم بالنقل و التبديل و التحويل إلى غير ذلك مما لا يصدر عن الأجسام و الجسمانيات، فلا هي جسمانية، و لا موضوعها الفاعل لها.
فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمره إلى إنشائها – و هو البدن الذي تنشأ منه النفس – بمنزلة الثمرة من الشجرة و الضوء من الدهن بوجه بعيد، و بهذا يتضح كيفية تعلقها بالبدن ابتداعا، ثم بالموت تنقطع العلقة، و تبطل المسكة، فهي في أول وجودها عين البدن، ثم تمتاز بالإنشاء منه، ثم تستقل عنه بالكلية فهذا ما تفيده الآيات الشريفة المذكورة بظهورها: و هناك آيات كثيرة تفيد هذه الحقيقة بالإيماء و التلويح، يعثر عليها المتدبر البصير، و الله الهادي.
قوله تعالى: و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات، لما أمرهم الله بالاستعانة بالصبر و الصلاة، و نهاهم عن القول بموت من يقتل منهم في سبيل الله بل هم أحياء بين لهم السبب الذي من أجله خاطبهم بما خاطب، و هو أنهم سيبتلون بما لا يتمهد لهم المعالي و لا يصفو لهم الأمر في الحياة الشريفة، و الدين الحنيف إلا به، و هو الحرب و القتال، لا يدور رحى النصر و الظفر على مرادهم إلا أن يتحصنوا بهذين الحصنين و يتأيدوا بهاتين القوتين، و هما الصبر و الظفر، و يضيفوا إلى ذلك ثالثا و هو خصلة ما حفظها قوم إلا ظفروا بأقصى مرادهم و حازوا الغاية القصوى من كمالهم، و اشتد بأسهم و طابت نفسهم، و هو الإيمان بأن القتيل منهم غير ميت و لا فقيد، و أن سعيهم بالمال و النفس غير ضائع و لا باطل، فإن قتلوا عدوهم فهم على الحياة، و قد أبادوا عدوهم و ما كان يريده من حكومة الجور و الباطل عليهم – و إن قتلهم عدوهم فهم على الحياة – و لم يتحكم الجور و الباطل عليهم، فلهم إحدى الحسنيين على أي حال.
و عامة الشدائد التي يأتي بها هو الخوف و الجوع و نقص الأموال و الأنفس فذكرها الله تعالى، و أما الثمرات فالظاهر أنها الأولاد، فإن تأثير الحرب في قلة النسل بموت الرجال و الشبان أظهر من تأثيره في نقص ثمرات الأشجار، و ربما قيل: إن المراد ثمرات النخيل، و هي التمر و المراد بالأموال غيرها و هي الدواب من الإبل و الغنم.
قوله تعالى: و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون، أعاد ذكر الصابرين ليبشرهم أولا، و يبين كيفية الصبر بتعليم ما هو الصبر الجميل ثانيا، و يظهر به حق الأمر الذي يقضي بوجوب الصبر – و هو ملكه تعالى للإنسان – ثالثا، و يبين جزاءه العام – و هو الصلاة و الرحمة و الاهتداء – رابعا فأمر تعالى نبيه أولا بتبشيرهم، و لم يذكر متعلق البشارة لتفخيم أمره فإنها من الله سبحانه فلا تكون إلا خيرا و جميلا، و قد ضمنها رب العزة، ثم بين أن الصابرين هم الذين يقولون: كذا و كذا عند إصابة المصيبة، و هي الواقعة التي تصيب الإنسان، و لا يستعمل لفظ المصيبة إلا في النازلة المكروهة، و من المعلوم أن ليس المراد بالقول مجرد التلفظ بالجملة من غير حضور معناها بالبال، و لا مجرد الإخطار من غير تحقق بحقيقة معناها، و هي أن الإنسان مملوك لله بحقيقة الملك، و أن مرجعه إلى الله سبحانه و به يتحقق أحسن الصبر الذي يقطع منابت الجزع و الأسف، و يغسل رين الغفلة.
بيانه أن وجود الإنسان و جميع ما يتبع وجوده، من قواه و أفعاله قائم الذات بالله الذي هو فاطره و موجده فهو قائم به مفتقر و مستند إليه في جميع أحواله من حدوث و بقاء غير مستقل دونه، فلربه التصرف فيه كيف شاء و ليس للإنسان من الأمر شيء إذ لا استقلال له بوجه أصلا فله الملك في وجوده و قواه و أفعاله حقيقة.
ثم إنه تعالى ملكه بالإذن نسبة ذاته، و من هناك يقال: للإنسان وجود، و كذا نسبة قواه و أفعاله و من هناك يقال: للإنسان قوى كالسمع و البصر، و يقال: للإنسان أفعال كالمشي و النطق، و الأكل و الشرب، و لو لا الإذن الإلهي لم يملك الإنسان و لا غيره من المخلوقات نسبة من هذه النسب الظاهرة، لعدم استقلال في وجودها من دون الله أصلا.
و قد أخبر سبحانه: أن الأشياء سيعود إلى حالها قبل الإذن و لا يبقى ملك إلا لله وحده، قال تعالى: «لمن الملك اليوم. لله الواحد القهار»: المؤمن – 16، و فيه رجوع الإنسان بجميع ما له و معه إلى الله سبحانه.
فهناك ملك حقيقي هو لله سبحانه لا شريك له فيه، لا الإنسان و لا غيره، و ملك ظاهري صوري كملك الإنسان نفسه و ولده و ماله و غير ذلك و هو لله سبحانه حقيقة، و للإنسان بتمليكه تعالى في الظاهر مجازا، فإذا تذكر الإنسان حقيقة ملكه تعالى، و نسبه إلى نفسه فوجد نفسه ملكا طلقا لربه، و تذكر أيضا أن الملك الظاهري فيما بين الإنسان و من جملتها ملك نفسه لنفسه و ماله و ولده سيبطل فيعود راجعا إلى ربه وجد أنه بالآخرة لا يملك شيئا أصلا لا حقيقة و لا مجازا، و إذا كان كذلك لم يكن معنى للتأثر عن المصائب الموجبة للتأثر عند إصابتها، فإن التأثر إنما يكون من جهة فقد الإنسان شيئا مما يملكه، حتى يفرح بوجدانه، و يحزن بفقدانه، و أما إذا أذعن و اعتقد أنه لا يملك شيئا لم يتأثر و لم يحزن، و كيف يتأثر من يؤمن بأن الله له الملك وحده يتصرف في ملكه كيف يشاء؟.
الأخلاق
اعلم أن إصلاح أخلاق النفس و ملكاتها في جانبي العلم و العمل، و اكتساب الأخلاق الفاضلة، و إزالة الأخلاق الرذيلة إنما هو بتكرار الأعمال الصالحة المناسبة لها و مزاولتها، و المداومة عليها، حتى تثبت في النفس من الموارد الجزئية علوم جزئية، و تتراكم و تنتقش في النفس انتقاشا متعذر الزوال أو متعسرها، مثلا إذا أراد الإنسان إزالة صفة الجبن و اقتناء ملكة الشجاعة كان عليه أن يكرر الورود في الشدائد و المهاول التي تزلزل القلوب و تقلقل الأحشاء، و كلما ورد في مورد منها و شاهد أنه كان يمكنه الورود فيه و أدرك لذة الإقدام و شناعة الفرار و التحذر انتقشت نفسه بذلك انتقاشا بعد انتقاش حتى تثبت فيها ملكة الشجاعة، و حصول هذه الملكة العلمية و إن لم يكن في نفسه بالاختيار لكنه بالمقدمات الموصلة إليه كما عرفت اختياري كسبي.
إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن الطريق إلى تهذيب الأخلاق و اكتساب الفاضلة منها أحد مسلكين: المسلك الأول: تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيوية، و العلوم و الآراء المحمودة عند الناس كما يقال: إن العفة و قناعة الإنسان بما عنده و الكف عما عند الناس توجب العزة و العظمة في أعين الناس و الجاه عند العامة، و إن الشره يوجب الخصاصة و الفقر، و إن الطمع يوجب ذلة النفس المنيعة، و إن العلم يوجب إقبال العامة و العزة و الوجاهة و الأنس عند الخاصة، و إن العلم بصر يتقي به الإنسان كل مكروه، و يدرك كل محبوب و إن الجهل عمى، و إن العلم يحفظك و أنت تحفظ المال، و إن الشجاعة ثبات يمنع النفس عن التلون و الحمد من الناس على أي تقدير سواء غلب الإنسان أو غلب عليه بخلاف الجبن و التهور، و إن العدالة راحة النفس عن الهمم المؤذية، و هي الحياة بعد الموت ببقاء الاسم و حسن الذكر و جميل الثناء و المحبة في القلوب.
و هذا هو المسلك المعهود الذي رتب عليه علم الأخلاق، و المأثور من بحث الأقدمين من يونان و غيرهم فيه.
و لم يستعمل القرآن هذا المسلك الذي بناؤه على انتخاب الممدوح عند عامة الناس عن المذموم عندهم، و الأخذ بما يستحسنه الاجتماع و ترك ما يستقبحه، نعم ربما جرى عليه كلامه تعالى فيما يرجع بالحقيقة إلى ثواب أخروي أو عقاب أخروي كقوله تعالى: «و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة»: البقرة – 150 دعا سبحانه إلى العزم و الثبات، و علله بقوله: لئلا يكون، و كقوله تعالى: «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا»: الأنفال – 46، دعا سبحانه إلى الصبر و علله بأن تركه و إيجاد النزاع يوجب الفشل و ذهاب الريح و جرأة العدو، و قوله تعالى «و لمن صبر و غفر إن ذلك لمن عزم الأمور»: الشورى – 43، دعا إلى الصبر و العفو، و علله بالعزم و الإعظام.
المسلك الثاني: الغايات الأخروية، و قد كثر ذكرها في كلامه تعالى كقوله سبحانه «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة»: التوبة – 111، و قوله تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»: الزمر – 10، و قوله تعالى: «إن الظالمين لهم عذاب أليم»: إبراهيم – 22، و قوله تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور و الذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات»: البقرة – 257، و أمثالها كثيرة على اختلاف فنونها.
و يلحق بهذا القسم نوع آخر من الآيات كقوله تعالى: «ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» فإن الآية دعت إلى ترك الأسى و الفرح بأن الذي أصابكم ما كان ليخطئكم و ما أخطأكم ما كان ليصيبكم لاستناد الحوادث إلى قضاء مقضي و قدر مقدر، فالأسى و الفرح لغو لا ينبغي صدوره من مؤمن يؤمن بالله الذي بيده أزمة الأمور كما يشير إليه قوله تعالى: «ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله و من يؤمن بالله يهد قلبه» فهذا القسم من الآيات أيضا نظير القسم السابق الذي يتسبب فيه إلى إصلاح الأخلاق بالغايات الشريفة الأخروية، و هي كمالات حقيقية غير ظنية يتسبب فيه إلى إصلاح الأخلاق بالمبادىء السابقة الحقيقية من القدر و القضاء و التخلق بأخلاق الله و التذكر بأسماء الله الحسنى و صفاته العليا و نحو ذلك.
فإن قلت: التسبب بمثل القضاء و القدر يوجب بطلان أحكام هذه النشأة الاختيارية، و في ذلك بطلان الأخلاق الفاضلة، و اختلال نظام هذه النشأة الطبيعية، فإنه لو جاز الاستناد في إصلاح صفة الصبر و الثبات و ترك الفرح و الأسى كما استفيد من الآية السابقة إلى كون الحوادث مكتوبة في لوح محفوظ، و مقضية بقضاء محتوم أمكن الاستناد إلى ذلك في ترك طلب الرزق، و كسب كل كمال مطلوب، و الاتقاء عن كل رذيلة خلقية و غير ذلك، فيجوز حينئذ أن نقعد عن طلب الرزق، و الدفاع عن الحق، و نحو ذلك بأن الذي سيقع منه مقضي مكتوب، و كذا يجوز أن نترك السعي في كسب كل كمال، و ترك كل نقص بالاستناد التي حتم القضاء و حقيقة الكتاب، و في ذلك بطلان كل كمال.
قلت: قد ذكرنا في البحث عن القضاء، ما يتضح به الجواب عن هذا الإشكال، فقد ذكرنا ثم أن الأفعال الإنسانية من أجزاء علل الحوادث، و من المعلوم أن المعاليل و المسببات يتوقف وجودها على وجود أسبابها و أجزاء أسبابها، فقول القائل: إن الشبع إما مقضي الوجود، و إما مقضي العدم، و على كل حال فلا تأثير للأكل غلط فاحش، فإن الشبع فرض تحققه في الخارج لا يستقيم إلا بعد فرض تحقق الأكل الاختياري الذي هو أحد أجزاء علله، فمن الخطإ أن يفرض الإنسان معلولا من المعاليل، ثم يحكم بإلغاء علله أو شيء من أجزاء علله.
فغير جائز أن يبطل الإنسان حكم الاختيار الذي عليه مدار حياته الدنيوية، و إليه تنتسب سعادته و شقاؤه، و هو أحد أجزاء علل الحوادث التي تلحق وجوده من أفعاله أو الأحوال و الملكات الحاصلة من أفعاله، غير أنه كما لا يجوز له إخراج إرادته و اختياره من زمرة العلل، و إبطال حكمه في التأثير، كذلك لا يجوز له أن يحكم بكون اختياره سببا وحيدا، و علة تامة إليه تستند الحوادث، من غير أن يشاركه شيء آخر من أجزاء العالم و العلل الموجودة فيه التي في رأسها الإرادة الإلهية فإنه يتفرع عليه كثير من الصفات المذمومة كالعجب و الكبر و البخل، و الفرح و الأسى، و الغم و نحو ذلك.
يقول الجاهل: أنا الذي فعلت كذا و تركت كذا فيعجب بنفسه أو يستكبر على غيره أو يبخل بماله – و هو جاهل بأن بقية الأسباب الخارجة عن اختياره الناقص، و هي ألوف و ألوف لو لم يمهد له الأمر لم يسد اختياره شيئا، و لا أغنى عن شيء – يقول الجاهل: لو أني فعلت كذا لما تضررت بكذا، أو لما فات عني كذا، و هو جاهل بأن هذا الفوت أو الموت يستند عدمه – أعني الربح أو العافية، أو الحياة – إلى ألوف و ألوف من العلل يكفي في انعدامها – أعني في تحقق الفوات أو الموت – انعدام واحد منها، و إن كان اختياره موجودا، على أن نفس اختيار الإنسان مستند إلى علل كثيرة خارجة عن اختيار الإنسان فالاختيار لا يكون بالاختيار.
فإذا عرفت ما ذكرنا و هو حقيقة قرآنية يعطيها التعليم الإلهي كما مر، ثم تدبرت في الآيات الشريفة التي في المورد وجدت أن القرآن يستند إلى القضاء المحتوم و الكتاب المحفوظ في إصلاح بعض الأخلاق دون بعض.
فما كان من الأفعال أو الأحوال و الملكات يوجب استنادها إلى القضاء و القدر إبطال حكم الاختيار فإن القرآن لا يستند إليه، بل يدفعه كل الدفع كقوله تعالى: «و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا و الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أ تقولون على الله ما لا تعلمون»: الأعراف – 28.
و ما كان منها يوجب سلب استنادها إلى القضاء إثبات استقلال اختيار الإنسان في التأثير، و كونه سببا تاما غير محتاج في التأثير، و مستغنيا عن غيره، فإنه يثبت استناده إلى القضاء و يهدي الإنسان إلى مستقيم الصراط الذي لا يخطىء بسالكه، حتى ينتفي عنه رذائل الصفات التي تتبعه كإسناد الحوادث إلى القضاء كي لا يفرح الإنسان بما وجده جهلا، و لا يحزن بما فقده جهلا كما في قوله تعالى: «و آتوهم من مال الله الذي آتاكم»: النور – 33، فإنه يدعو إلى الجود بإسناد المال إلى إيتاء الله تعالى، و كما في قوله تعالى: «و مما رزقناهم ينفقون»: البقرة – 3، فإنه يندب إلى الإنفاق بالاستناد إلى أنه من رزق الله تعالى، و كما في قوله تعالى: «فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا»: الكهف – 7، نهى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحزن و الغم استنادا إلى أن كفرهم ليس غلبة منهم على الله سبحانه بل ما على الأرض من شيء أمور مجعولة عليها للابتلاء و الامتحان إلى غير ذلك.
و هذا المسلك أعني الطريقة الثانية في إصلاح الأخلاق طريقة الأنبياء، و منه شيء كثير في القرآن، و فيما ينقل إلينا من الكتب السماوية.
و هاهنا مسلك ثالث مخصوص بالقرآن الكريم لا يوجد في شيء مما نقل إلينا من الكتب السماوية، و تعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم أجمعين، و لا في المعارف المأثورة من الحكماء الإلهيين، و هو تربية الإنسان وصفا و علما باستعمال علوم و معارف لا يبقى معها موضوع الرذائل، و بعبارة أخرى إزالة الأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدفع.
و ذلك كما أن كل فعل يراد به غير الله سبحانه فالغاية المطلوبة منه إما عزة في المطلوب يطمع فيها، أو قوة يخاف منها و يحذر عنها، لكن الله سبحانه يقول: «إن العزة لله جميعا»: يونس – 65، و يقول: «إن القوة لله جميعا»: البقرة – 165، و التحقق بهذا العلم الحق لا يبقى موضوعا لرياء، و لا سمعة، و لا خوف من غير الله و لا رجاء لغيره، و لا ركون إلى غيره، فهاتان القضيتان إذا صارتا معلومتين للإنسان تغسلان كل ذميمة وصفا أو فعلا عن الإنسان و تحليان نفسه بحلية ما يقابلها من الصفات الكريمة الإلهية من التقوى بالله، و التعزز بالله و غيرهما من مناعة و كبرياء و استغناء و هيبة إلهية ربانية.
و أيضا قد تكرر في كلامه تعالى: أن الملك لله، و أن له ملك السماوات و الأرض و أن له ما في السماوات و الأرض و قد مر بيانه مرارا، و حقيقة هذا الملك كما هو ظاهر لا تبقى لشيء من الموجودات استقلالا دونه، و استغناء عنه بوجه من الوجوه فلا شيء إلا و هو سبحانه المالك لذاته و لكل ما لذاته، و إيمان الإنسان بهذا الملك و تحققه به يوجب سقوط جميع الأشياء ذاتا و وصفا و فعلا عنده عن درجة الاستقلال، فهذا الإنسان لا يمكنه أن يريد غير وجهه تعالى، و لا أن يخضع لشيء، أو يخاف أو يرجو شيئا، أو يلتذ أو يبتهج بشيء، أو يركن إلى شيء أو يتوكل على شيء أو يسلم لشيء أو يفوض إلى شيء، غير وجهه تعالى، و بالجملة لا يريد و لا يطلب شيئا إلا وجهه الحق الباقي بعد فناء كل شيء، و لا يعرض إعراضا و لا يهرب إلا عن الباطل الذي هو غيره الذي لا يرى لوجوده وقعا و لا يعبأ به قبال الحق الذي هو وجود باريه جل شأنه.
و كذلك قوله تعالى: «الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى»: طه – 8، و قوله: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء»: الأنعام – 102، و قوله: «الذي أحسن كل شيء خلقه»: السجدة – 7، و قوله: «و عنت الوجوه للحي القيوم»: طه – 111 و قوله: «كل له قانتون»: البقرة – 116، و قوله: «و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه»: الإسراء – 23، و قوله: «أ و لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد»: فصلت – 53، و قوله: «ألا إنه بكل شيء محيط»: فصلت – 54، و قوله: «و أن إلى ربك المنتهى»: النجم – 42.
و من هذا الباب الآيات التي نحن فيها و هي قوله تعالى: «و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون» إلى آخرها فإن هذه الآيات و أمثالها مشتملة على معارف خاصة إلهية ذات نتائج خاصة حقيقية لا تشابه تربيتها نوع التربية التي يقصدها حكيم أخلاقي في فنه، و لا نوع التربية التي سنها الأنبياء في شرائعهم، فإن المسلك الأول كما عرفت مبني على العقائد العامة الاجتماعية في الحسن و القبح و المسلك الثاني مبني على العقائد العامة الدينية في التكاليف العبودية و مجازاتها، و هذا المسلك الثالث مبني على التوحيد الخالص الكامل الذي يختص به الإسلام على مشرعه و آله أفضل الصلاة هذا.
فإن تعجب فعجب قول بعض المستشرقين من علماء الغرب في تاريخه الذي يبحث فيه عن تمدن الإسلام، و حاصله: أن الذي يجب للباحث أن يعتني به هو البحث عن شئون المدنية التي بسطتها الدعوة الدينية الإسلامية بين الناس من متبعيها، و المزايا و الخصائص التي خلفها و ورثها فيهم من تقدم الحضارة و تعالي المدنية، و أما المعارف الدينية التي يشتمل عليها الإسلام فهي مواد أخلاقية يشترك فيها جميع النبوات، و يدعو إليها جميع الأنبياء هذا.
و أنت بالإحاطة بما قدمناه من البيان تعرف سقوط نظره، و خبط رأيه فإن النتيجة فرع لمقدمتها، و الآثار الخارجية المترتبة على التربية إنما هي مواليد و نتائج لنوع العلوم و المعارف التي تلقاها المتعلم المتربي، و ليسا سواء قول يدعو إلى حق نازل و كمال متوسط و قول يدعو إلى محض الحق و أقصى الكمال، و هذا حال هذا المسلك الثالث، فأول المسالك يدعو إلى الحق الاجتماعي، و ثانيها يدعو إلى الحق الواقعي و الكمال الحقيقي الذي فيه سعادة الإنسان في حياته الآخرة، و ثالثها يدعو إلى الحق الذي هو الله، و يبني تربيته على أن الله سبحانه واحد لا شريك له، و ينتج العبودية المحضة، و كم بين المسالك من فرق!.
و قد أهدى هذا المسلك إلى الاجتماع الإنساني جما غفيرا من العباد الصالحين، و العلماء الربانيين، و الأولياء المقربين رجالا و نساء، و كفى بذلك شرفا للدين.
على أن هذا المسلك ربما يفترق عن المسلكين الآخرين بحسب النتائج، فإن بناءه على الحب العبودي، و إيثار جانب الرب على جانب العبد و من المعلوم أن الحب و الوله و التيم ربما يدل الإنسان المحب على أمور لا يستصوبه العقل الاجتماعي الذي هو ملاك الأخلاق الاجتماعية، أو الفهم العام العادي الذي هو أساس التكاليف العامة الدينية، فللعقل أحكام، و للحب أحكام، و سيجيء توضيح هذا المعنى في بعض الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئك هم المهتدون الآية.
التدبر في الآية يعطي أن الصلاة غير الرحمة بوجه، و يشهد به جمع الصلاة و إفراد الرحمة، و قد قال تعالى: «هو الذي يصلي عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور و كان بالمؤمنين رحيما»: الأحزاب – 43، و الآية تفيد كون قوله: و كان بالمؤمنين رحيما، في موقع العلة لقوله: هو الذي يصلي عليكم، و المعنى أنه إنما يصلي عليكم، و كان من اللازم المترقب ذلك، لأن عادته جرت على الرحمة بالمؤمنين، و أنتم مؤمنون فكان من شأنكم أن يصلي عليكم حتى يرحمكم، فنسبة الصلاة إلى الرحمة نسبة المقدمة إلى ذيها و كالنسبة التي بين الالتفات و النظر، و التي بين الإلقاء في النار و الإحراق مثلا، و هذا يناسب ما قيل في معنى الصلاة: إنها الانعطاف و الميل، فالصلاة من الله سبحانه انعطاف إلى العبد بالرحمة و من الملائكة انعطاف إلى الإنسان بالتوسط في إيصال الرحمة، و من المؤمنين رجوع و دعاء بالعبودية و هذا لا ينافي كون الصلاة بنفسها رحمة و من مصاديقها، فإن الرحمة في القرآن على ما يعطيه التدبر في مواردها هي العطية المطلقة الإلهية، و الموهبة العامة الربانية، كما قال تعالى: «و رحمتي وسعت كل شيء»: الأعراف – 156، و قال تعالى: «و ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين»: الأنعام – 133، فالإذهاب لغناه و الاستخلاف و الإنشاء لرحمته، و هما جميعا يستندان إلى رحمته كما يستندان إلى غناه فكل خلق و أمر رحمة، كما أن كل خلق و أمر عطية تحتاج إلى غنى، قال تعالى: «و ما كان عطاء ربك محظورا: الإسراء – 20، و من عطيته الصلاة فهي أيضا من الرحمة غير أنها رحمة خاصة، و من هنا يمكن أن يوجه جمع الصلاة و إفراد الرحمة في الآية.
قوله تعالى: و أولئك هم المهتدون، كأنه بمنزلة النتيجة لقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة، و لذلك جدد اهتداءهم جملة ثانية مفصولة عن الأولى، و لم يقل: صلوات من ربهم و رحمة و هداية، و لم يقل: و أولئك هم المهديون بل ذكر قبولهم للهداية بالتعبير بلفظ الاهتداء الذي هو فرع مترتب على الهداية، فقد تبين أن الرحمة هدايتهم إليه تعالى، و الصلوات كالمقدمات لهذه الهداية و اهتداءهم نتيجة هذه الهداية، فكل من الصلاة و الرحمة و الاهتداء غير الآخر و إن كان الجميع رحمة بنظر آخر.
فمثل هؤلاء المؤمنين في ما يخبره الله من كرامته عليهم مثل صديقك تلقاه و هو يريد دارك، و يسأل عنها يريد النزول بك فتلقاه بالبشر و الكرامة، فتورده مستقيم الطريق و أنت معه تسيره، و لا تدعه يضل في مسيره حتى تورده نزلة من دارك و تعاهده في الطريق بمأكله و مشربه، و ركوبه و سيره، و حفظه من كل مكروه يصيبه فجميع هذه الأمور إكرام واحد لأنك إنما تريد إكرامه، و كل تعاهد تعاهد و إكرام خاص، و الهداية غير الإكرام، و غير التعاهد، و هو مع ذلك إكرام فكل منها تعاهد، و كل منها هداية و كل منها إكرام خاص، و الجميع إكرام.
فالإكرام الواحد العام بمنزلة الرحمة، و التعاهدات في كل حين بمنزلة الصلوات، و النزول في الدار بمنزلة الاهتداء.
و الإتيان بالجملة الاسمية في قوله: و أولئك هم المهتدون، و الابتداء باسم الإشارة الدال على البعيد، و ضمير الفصل ثانيا و تعريف الخبر بلام الموصول في قوله: المهتدون كل ذلك لتعظيم أمرهم و تفخيمه – و الله أعلم -.
يتبع…
2018-09-18
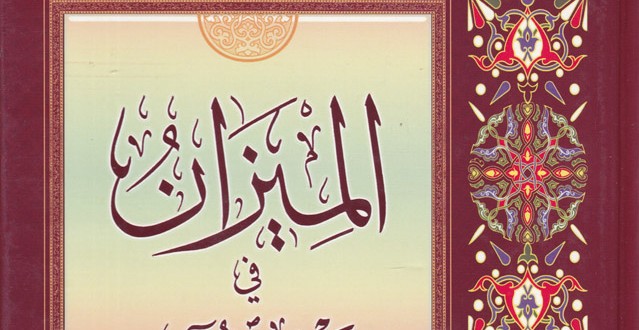
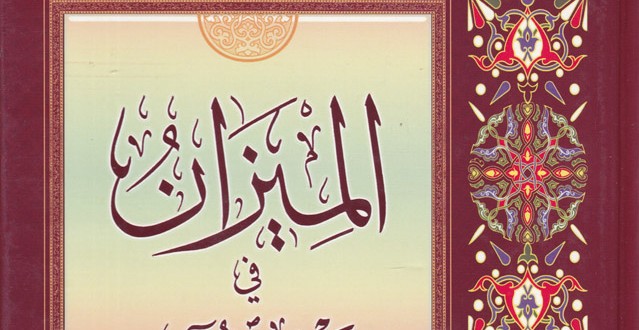
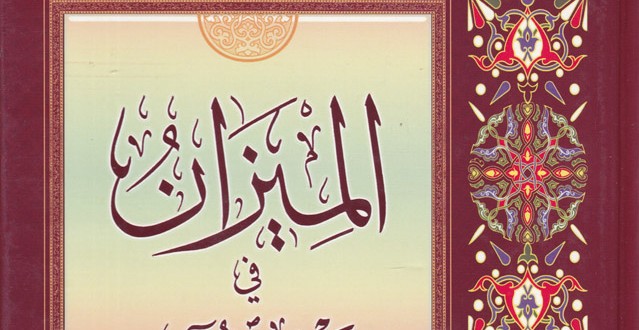
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
