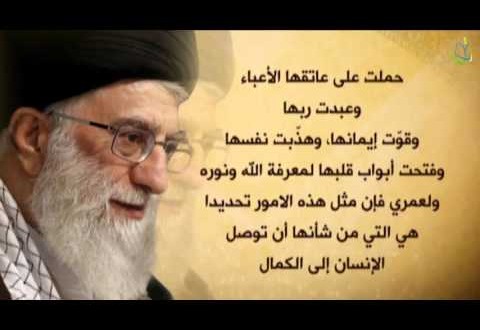تتمة-
البحث الثاني
حقيقة السر المستودع في فاطمة ( عليها السلام )
والغرض أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر بذلك وفعل بنفسه ، لأنه إذا أراد إيداع مثل هذه الأسرار في
قلوب أصحابه وخواصه كان يخلو بهم ويقول في آذانهم ، كما فعل بأمير المؤمنين
علي ( عليه السلام ) وأخبر عنه أمير المؤمنين بقوله ” تعلمت من رسول الله ألف باب من العلم ،
وفتح الله تعالى لي بكل باب ألف باب ” وإلى كتمانه وإخفائه بنفسه عن الأغيار أشار
أيضا بقوله ” اندمجت على مكنون علم ، لو أبحت به لاضطربتهم اضطراب الأرشية في
الطوى البعيدة ” .
وإلى ثمرة إظهاره – أعني من الفساد – أشار أيضا وقال ” والله لو شئت
أن أخبر بكل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت ولكني أخاف أن
يكفروا برسول الله ” وهذا أمر منه بإخفاء أسرار الله وكتمانها وكناية عن إخفائها ولهذا
لما قال له الخصم ” أنت تتكلم بالغيب ” قال ويحك ! أن هذا ليس بغيب ، ولكنه علم
تعلمت من ذي علم ” أراد به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وكما فعل بسلمان أيضا ، أي جعله صاحب سر وقال فيه : ” سلمان منا أهل البيت ” أي
من أهل بيت التوحيد والعلم والمعرفة والحكمة لا من أهل بيت النسوان والصبيان
والأهل والأولاد ، وقال تأكيدا لهذا المعنى : ” لو علم أبو ذر ما في بطن سلمان من الحكمة
لكفره ! ” وروي ” لقتله ! ” وكلاهما صحيح فأنظر إلى عظمة السر المودع عند سلمان ،
وعلى المبالغة في كتمان أسرار الله تعالى حيث عرفت أن كبار الصحابة كانوا يخفون
بعضهم عن بعض حتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولعظمة شأن سلمان وقربه إلى حضرة الرحمان قال
عليه السلام : ” الجنة أشوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنة ” وكذلك لجلالة قدر أويس
القرني ( رحمه الله ) لاطلاعه على أسرار الله تعالى كشفا وذوقا ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حقه حيث كان
يستنشق من طرف اليمن روائح أنفاسه الشريفة من حيث الباطن أو الظاهر : ” أني
لأستنشق روح الرحمن من طرف اليمن ” وورد ” من ناحية اليمن ” و ” من قبل اليمن ” وقد
سأله سلمان عن هذا الشخص فقال له ( عليه السلام ) : ” إن باليمن لشخصا يقال له : ” أويس القرني
يحشر يوم القيامة أمة وحده يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر ، ألا من رآه منكم
فليقرأه عني السلام ، وليأمره أن يدعو لي ” .
وإلى غلبة هذه الأسرار بالنسبة إليه في بعض الأوقات قال :
” لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ” والمراد أن لي مع الله
حالات وأوقات لا يمكن أن يطلع عليها أحد ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا
غيرهم من المخلوقات ، وكأنه يشير إلى أنه ما تنكشف عليه هذه الأسرار ولا تتجلى
له هذه الأنوار إلا عنده تجرده عن جميع التعلقات الروحانية والجسمانية – حتى النبوة
والرسالة – وعن جبرئيل وإبلاغه أيضا لقوله ( عليه السلام ) : ” لو دنوت أنملة لاحترقت “
وبالحقيقة المعراج عبارة عن هذا المقام ، إن أريد به المعراج المعنوي ، وإن أريد به
المعراج الصوري فهو ظاهر وقد عبر ( عليه السلام ) عن شدة تعلقه بالنبوة والرسالة ومنعهما من
الوصول إلى حضرة الحق جل جلاله وقال حين خلاصه عنهم لحظة ” لا يسعني فيه
ملك مقرب أي جبرئيل وإبلاغه ” ولا نبي مرسل ” أي النبوة ورسالتهما لأن الرسالة
إبلاغ ما حصل عن النبوة وإلى هذا المقام أشار – جل ذكره – ” ولن أجد من دونه
ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ” وأمثال ذلك كثيرة .
والغرض منه أن إخفاء أسرار
الله تعالى – خصوصا الأسرار المتعلقة بهم – واجب من غير أهلها لأنها لا زالت كذلك
أي مخفية عن غير أهلها ، مودعة عند أهلها ، وإذا عرفت هذا فلنرجع إلى قول
الأولياء ( عليهم السلام ) ونبين هذا بقول أعظمهم وأكملهم الذي هو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كما فعلنا
في الأنبياء أعني اكتفينا منهم بأعظمهم وأكملهم الذي هو نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومنها قول أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأقواله في هذا الباب كثيرة نذكر منها أحسنها
وألطفها ، وهو ما جرى بينه وبين كميل بن زياد النخعي ( رحمهم الله ) الذي كان من أخص
تلامذته وأعظم أصحابه وإليه تنسب خرقة الموحدين وطريقة المتحققين حين سأله
عن ” الحقيقة ” ، بقوله ” ما الحقيقة ! ” فقال له ( عليه السلام ) : ” ما لك والحقيقة ؟ ” يعني من أنت
والسؤال عن الحقيقة ولست بأهلها ! فقال كميل : ” أولست بصاحب سرك ؟
” قال :
” بلى ولكن يرشح عليك ما يطفح مني ” يعني أنت صاحب سري ومن أخص تلامذتي
ولكن لست بأهل لمثل هذا السر والاطلاع عليه لأنه ” يرشح عليك ما يطفح مني “
و ” إلا كان الأمر ” يضرك ويضرني لأن ظرفك لا يحتمل فوق قدرك ، وأنا مأمور
بوضع الشئ في موضعه ، فقال كميل : ” أو مثلك يخيب سائلا ؟ ” أي مثلك في العلوم
والحقائق والاطلاع على استعداد كل سائل ” يخيب سائلا ” أي يمنعه عن حقه ويجعله
محروما عن مراده ، خائبا عن مقصوده ، ساكتا عن جوابه ؟ لا والله بل يجب عليك
وعلى مثلك جواب كل واحد منهم بقدر استعداده وفهمه وإدراكه مطاوعة لقوله
تعالى : * ( أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ) * وأسوة نبيك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقوله
” كلموا الناس على قدر عقولهم ” . فشرع الإمام ( عليه السلام ) بعد ذلك في بيانه وقال : الحقيقة
كشف سبحات الجلال من غير إشارة ، فقال كميل : زدني فيه بيانا ، قال الإمام ( عليه السلام ) :
صحو الموهوم مع محو المعلوم .
قال كميل : زدني فيه بيانا ، قال الإمام ( عليه السلام ) : هتك السر لغلبة الستر . قال كميل : زدني
فيه بيانا . قال الإمام ( عليه السلام ) : نور يشرق من صبح الأزل ، فيلوح على هياكل التوحيد
آثاره . قال كميل : زدني فيه بيانا ، قال الإمام ( عليه السلام ) : أطف السراج ، فقد طلع الصبح .
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح طويل وبسط عظيم ، ولكن معنى الكلام الأخير أنه يقول : اسكت بعد ذلك أي بعد هذا البيان التام والإظهار الكامل والكشف الجلي ، عن
السؤال من لسان العقل ومقام القلب ومرتبة السلوك ، لأنه قد طلع تباشير شمس
الحقيقة وظهر شعاعها في الآفاق ، ولست أنت بعد ذلك ، محتاجا إلى السؤال من لسان
العقل الذي كالسراج بالنسبة للشمس .
والمراد أن الشخص إذا وصل إلى مقام المشاهدة والكشف فلا ينبغي له أن يطلب
المقصود من طريق المجادلة والمباحثة لأن الكشفيات والذوقيات غير قابلة للعبارة
والإشارة والسؤال والجواب كما أشار إليه أولا : ” كشف سبحات الجلال من غير
إشارة ” فكأنه أمره بالسكوت والصمت والتوجه إلى حضرته تعالى حتى يدرك
مقصوده بالذوق الذي هو أعلى مراتب الوصول إلى الله تعالى ، وعن هذا المقام قال
العارف : ” من عرف الله كل لسانه ” أي ” من عرف الله ” على سبيل المشاهدة والذوق
” كل لسانه ” عن العبارة والإشارة والغرض من هذا كله أن الإمام عليه السلام إذا كان
بإفشاء الأسرار الإلهية من أعظم خواصه وأكبر تلامذته بهذه المثابة ، فلا يجوز لغيره
إفشاؤها مع كل أحد من العوام والجهال ، فإذن عليك بكتمانها وإخفائها عن غير أهلها
اتباعا لله تعالى ولرسوله ولإمام المسلمين كافة .
ويروى عن كميل ( رضي الله عنه ) مثل ذلك أيضا وأبلغ في كتمان الأسرار وإخفائها ، كما هو مذكور
في نهج البلاغة ، وهو أنه قال ( رضي الله عنه ) : ” أخذ بيدي أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) فأخرجني إلى
الجبانة فلما أصحر ، تنفس الصعداء ثم قال لي : يا كميل بن زياد ! ” إن هذه القلوب
أوعية فخيرها أوعاها فأحفظ عني ما أقول لك : الناس ثلاثة : فعالم رباني ومتعلم
على سبيل نجاة ، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيؤا بنور
العلم ، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق .
يا كميل : العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والمال تنقصه النفقة ،
والعلم يزكو على الإنفاق وصنيع المال يزول بزواله ، يا كميل ! معرفة العلم دين يدان
به ، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته ، العلم حاكم
والمال محكوم عليه ، يا كميل بن زياد : هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون
ما بقي الدهر ، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة ؟ إن ههنا لعلما جما – وأشار
بيده إلى صدره – لو أصبت له حملة ! بلى ! أصبت لقنا غير مأمون عليه ، مستعملا آلة
الدين للدنيا ، ومستظهرا بنعم الله تعالى على عباده ، وبحججه على أوليائه ، أو منقادا
لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه ، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة : ألا !
لاذا ولا ذاك ، أو منهوما باللذة – سلس القيادة للشهوة ، أو مغرما بالجمع والادخار
ليس من رعاة الدين في شئ أقرب شئ شبها بهما الأنعام السائمة ، كذلك يموت العلم
بموت حامليه ، اللهم بلى : لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه ، إما ظاهرا مشهورا أو
خائفا مغمورا ، لئلا تبطل حجج الله وبيناته ، ولم ذا ؟ وأين أولئك – لا والله – الأقلون
عددا . والأعظمون عند الله قدرا ، بهم يحفظ الله تعالى حججه وبيناته ، حتى يودعوها
نظراءهم ، ويزرعوها في قلوب أشباههم ، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة ،
وباشروا ردح اليقين ، واستلانوا ما استوعره المترفون ، وأنسوا بما استوحش منه
الجاهلون ، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في
أرضه ، والدعاة إلى دينه ، آه ، آه ! شوقا إلى رؤيتهم ” .
وإذ فرغنا من كلامه في كتمان الأسرار والمبالغة فيه بقدر هذا المقام ، فلنشرع فيه من
كلام الأئمة المعصومين من أولاده ( عليهم السلام ) تأكيدا ومبالغة في هذه المقدمة ، وإن قيل : يكفي
في هذه المقدمة ما قدمتم من آية أو آيتين ، وخبر أو خبرين لأن المقصود يحصل منهما ،
فلا فائدة في التطويل وزيادة في الكلام ؟ أجيب عنه بأن المراد ليس نفس الإخفاء ولا
الكتمان ، بل هناك غرض آخر يفهم من البحث الآتي في آخر هذه العجالة وهو معرفة
حقيقة السر المستودع في فاطمة وهل هو ظاهر أم مستور ستره الله عن جميع البشر
إلا الأولياء الخلص ، وبقية الأغراض سوف تظهر من بعد ذلك .
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله