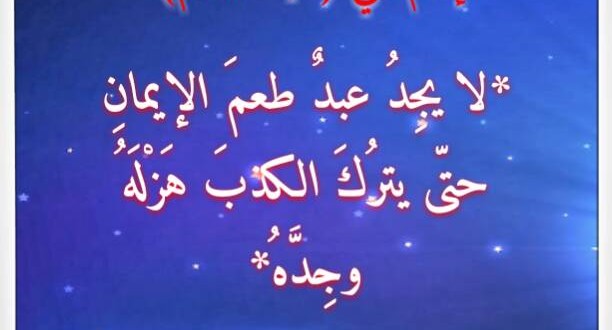المدخل
لقد نصب الله سلم اعتلاء الإنسان عند مهوى ومهبط الحيوانية، ليجلس الإنسان على قمة مقامه الأسمى منزلة من الملائكة، وقرن بينهما بنحو كلما اسرع الإنسان الخطى في ميدان المشتركات الحيوانية، ازداد غوراً في مستنقع الحيوانية. فما الفارق بين الإنسان والحيوان إذن؟ تلك وظيفة المحققين، ومحترفي العلم والتحقيق، نخبة البشر أن يكتشفوا الفوارق، ويدركوا المميزات، ويفكروا في الظفر بقيمتها.
لاريب أن التفكير والعبادة الواعية من أسمى الفوارق بين الإنسان والحيوان. والصلاة مثال التفكير، وقالب العبادة الواعية. التفكير في بداية الوجود، ومفيضه، وعلاقة هذا المفيض بنا يدعو الإنسان إلى حمد رب العالمين، والثناء عليه… التفكير في منتهى طريق هذه المسيرة يجرنا نحو الخضوع أمام مالك تلك النشأة ورائدها، لنحمده وحده، ونعفر جبين الخضوع والالتماس بتراب ساحته.
وبينما يدفع التحقيق الإنساني الإنسان نحو الحمد والخضوع في حضرة المعبود فـ (إنما يخشى الله من عباده العلماء)[1]، وتمنعه الغفلة الحيوانية من الامتثال الواله أمام الله سبحانه بدليل قوله: (اولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)[2] نجد لزاماً علينا أن نطلع ـ ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً ـ هذا الجيل المختار والمنتخب ونبصره المعارف والعلوم التي خلفها الراسخون في العلم وباقريه[3] لاسيما الصلاة التي تمثل أساس المعرفة الدينية[4].
وامتثالاً للواجب هذا، وتجاوباً مع اقتراح بعض اساتذة الحوزة والجامعة، أعد هذا الكراس ليكون الخطوة الأولى على طريق ايضاح معاني الصلاة للطلبة الجامعيين الأعزاء.
وأنا إذ أقدم هذا الكراس آمل أن تزول بفضل اقتراحات أساتذة العلوم والمعارف الإسلامية، وتصحيحاتهم نواقصه، وتنتفي نقائصه، ويتقلد وسام القبول في ساحة الواحد الأحد.
ولما كانت فكرة تدوين هذا الكراس قد بزغت ليلة ولادة عالم آل الطهارة والتقوى ـ الذين أدهش بصغره سنه كل ذوي المعارف وأدعياء العلم في عصره ـ جواد الأئمة (ع) فإني أهدي هذا الكتاب إلى حضرة ذلك الكوكب مقيم الصلة.
د. محمد رضا رضوان طلب
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله