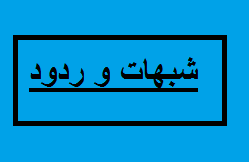أوائل المقالات في المذاهب والمختارات / الصفحات: ٣٤١ – ٣٦٠
(١٠١) قوله في القول ٧١ (لم يوفق للتوبة أبدا)
أقول: ما ذكره إشارة إلى الروايات الواردة في ذيل قوله (تعالى): ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. روى عن أبي جعفر (ع) في حديث طويل قال لما سمعه… وأنزل في بيان القاتل ومن يقتل مؤمنا… عظيما) ولا يلعن الله مؤمنا، قال الله عز وجل أن الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا الوسائل ج ١٩ ص ١٠ وعن أبي عبد الله (ع) في رجل قتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أي ميتة شئت، إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا (نفس المصدر) وعن أبي عبد الله (ع) سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟
فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، (المصدر).
وقد فسر العمد في بعض الروايات بأن يكون قتله لأجل إيمانه، لا العمد المصطلح بأن يقع بينها مشاجرة فقتله.
(١٠٢) قوله في القول ٧٢ (أن يكون اضطرارا)
أقول: الاضطرار في اصطلاح المتكلمين بمعنى الضرورة. وجه التسمية هو أن العلوم الاكتسابية مقدماتها باختيار الانسان بأن يرتب المقدمات التي توصل
منهم من يدعي الضرورة في التوحيد وإثبات الصانع (تعالى) مستدلا بظواهر آيات لم يفهمها مثل قوله (تعالى) ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله (تعالى) أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وغيرهما.
ومنهم من يدعي عدم حصول العلم من الدلائل العقلية وانحصار إفادة العلم بالدلائل النقلية مثل أكثر الأخباريين منا ومن العامة.
ومنهم الأشاعرة المنكرين للسببية والمسببية بين جميع الأسباب و المسببات الخارجية والذهنية فلا ملازمة بين النار والاحراق ولا بين الفكر والنتيجة العلمية.
ومنهم الذين يرون مجرد الالتفات والتوجه كافيين في حصول العلم لقولهم بأن العلم ليس إلا التذكر كما نسب إلى أفلاطون فلا يكون دخالة الفكر وترتيب المقدمات إلا لكونها سببا للتوجه والالتفات كما أشار إليه العلامة الزنجاني.
ومنهم من يرى كالجهمية أن المعارف الدينية يختلف فيها العباد، فيخلق الله في قلب بعضهم اليقين بالمعارف الدينية الصحيحة، وفي قلب بعضهم اليقين بالعقائد الباطلة، وفي قلب بعضهم الشك، وليس شئ منها باختيار المكلف ولا مترتب على بحثه أو تفكره، بل الله (تعالى) يخلق أفعال قلوبهم مثل
وما ذكره هنا هو قانون الأسباب والمسببات الثابت في عالم الكون على الأعم الدائم، ولا ينافيه الخروج عن هذا القانون في الموارد النادرة بسبب الاعجاز و خرق العادة، فإن ثبوت الاعجاز وخرق القوانين من قبل مقننها أيضا من جملة القوانين في باب النبوات والشرائع، إذ لا مانع من كون قانون إلهي حاكما على قانون إلهي آخر، وعليه فلا مانع من حصول علوم كثيرة أو علم في مورد خاص من غير طريق الاكتساب المذكور، كما إنه لا مانع من حصول الادراكات الحسية في بعض الموارد مع عدم اجتماع الشرائط المذكورة لها، ولكن لهما أيضا أسباب و علل أخرى مذكورة في محالها وليست جزافا.
(١٠٣) قوله في القول ٧٢ (ويخالف فيه البصريون من المعتزلة والمشبهة وأهل القدر والإرجاء)
أقول: أما البصريون من المعتزلة فجهة مخالفتهم مضافا إلى ما نقل عن الجاحظ ما نقله قاضي القضاة في المغني في ج ١٢ ص ٥٩ من إطلاقهم السمع والبصر على العلم.
وأما مخالفة المشبهة فلقولهم بإمكان رؤية الباري (تعالى) من دون وجود شرائط الادراك الحسى وأما أهل القدر والإرجاء فقد أشرنا إلى قولهم في الأسباب والمسببات وفي أفعال العباد من إنكارهم ذلك وقولهم بالجزاف.
(١٠٤) القول ٧٣
(١٠٥) قوله في القول ٧٤ (والعلم بذلك يرجع إلى المشاهدات في الوجود، وليس يتصور التعبير عن ذلك بالعبارة والكلام)
أقول: أما على النحو الكلي فقد بحث عنها علماء الأصول والكلام مثل عدم إمكان التواطؤ بالمكاتبة وبالمشافهة وسائر وسائل الارتباط، ثم عدم وجود الدواعي الباعثة إلى التواطؤ من الجوامع والمشتركات العقلائية، مثل كونهم جميعا أهل مذهب واحد، وكان فيما يروونه تأييدا لمذهبهم، مثل كونهم جميعا من قبيلة وكان المنقول ترويجا لها، ومثل كونهم أهل صنعة أو عمل و كانت الرواية في شأنهم مثل رواية القارئ في شأن القراء إلى غير ذلك مما ذكروه.
وأما على النحو الجزئي فالعلم بخصوصيات أحوال الرواة، والدواعي الموجودة فيهم لا يمكن إلا عن طريق المعاشرة والمخالفة أو الرجوع إلى أحوالهم الشخصية عن طريق تاريخ حياتهم وهذا هو مراد الشيخ قده من قوله (والعلم بذلك الخ).
(١٠٦) قوله (على الاضطرار)
أقول: قد أطال المتكلمون والأصوليون البحث عن إن المتواتر هل يوجب العلم على الاضطرار كما يقوله البصريون، أو بالنظر كما يدعيه الشيخ في العدة ومعتزلة بغداد، أو التوقف كما عليه السيد المرتضى في الذريعة؟
وفضلوا في الاستدلال والجواب بما لا مزيد عليه.
(١٠٧) قوله في القول ٧٥ (القول فيما يدرك بالحواس…)
أقول: راجع الجلد ١٢ من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار.
(١٠٨) قوله في القول ٧٦ (هل هم مأمورون الخ)
أقول: عنوان الباب لم يقيد بالعقل، فيوهم ابتداء إرادة الأوامر الشرعية، و عليه فيتحد مع ما بعده من البحث، ولكن سرعان ما يزول هذا التوهم بقوله (إن أهل الآخرة مأمورون بعقولهم بالسداد…) وقوله (وإن القلوب لا تنقلب عما هي عليه…) فإن التأمل في مجموع كلامه يوضح جليا أن المراد بالبحث هنا الأحكام العقلية أعني الحسن والقبح الثابتين في نفس الانسان وقلبه والأوامر التي يصدرها العقل أو يدركها لا الأحكام الشرعية التعبدية.
(١٠٩) قوله في القول ٧٧ (والصنف الآخر…)
ربما يتوهم من تصنيفهم بصنفين إنه يريد إثبات التكليف لصنف ونفيه عن الآخر، ولكن التأمل في عبارته يوضح أن تقسيمه وتصنيفه لتوقف استدلاله
(١١٠) قوله في القول ٧٨ (… أو مضطرون أو ملجأون على ما يذهب إليه أهل الخلاف).
أقول: الاضطرار واسطة بين الاختيار والالجاء، وذلك أن الالجاء مثل أن يشدوا يديه ورجليه ويلقواه في البحر فلا اختيار معه أصلا، والاضطرار أن يكون صدور الفعل عنه باختيار ولكن اختياره لا يكون عن اختيار بل لتهديد و نحوه.
وقد أطال العلامة الزنجاني في نقل كلام أبي الهذيل ودليله من بين ساير الأقوال وأدلتها.
(١١١) قوله في القول ٧٩ (لارتفاع دواعي فعل القبيح عنهم على كل حال)
أقول: لا خلاف بين الإمامية فيما ذكره إلا ما نقل عن السيد المرتضى قده فإنه في رسالته في أحكام أهل الآخرة مع حكمه بالاختيار في فعل الواجب والحسن، حكم بأن ترك القبيح على نحو الالجاء في الآخرة، وهذا مضافا إلى شذوذه ضعيف من جهة الدليل. قال، في مقام الاستدلال على قوله: والذي يدل على صحة ما اخترناه: إنه لا بد أن يكونوا مع كمال عقولهم ومعرفتهم بالأمور ممن يخطر القبيح بقلبه ويتصوره، وهم قادرون عليه لا محالة، ولا يجوز أن يخلى بينهم وبين فعله فلا يخلو: إما أن يمنعوا من فعل القبيح بأمر وتكليف، أو بإلجاء على ما اخترناه، أو بأن يضطروا إلى خلافه على ما قاله أبو الهذيل؟
أقول: خلاصة قوله قده الفرق بين ما يفعلون وبين ما يتركون فقال:
(فالالجاء إنما يكون فيما لا يفعلونه، فأما ما يفعلونه فهم فيه مخيرون، لأنهم يؤثرون فعلا على غيره…).
والجواب أولا بالنقض: وذلك فإن الدليل الذي استدل به يأتي في فعل الواجب العقلي وما يفعلونه كما أتى في ترك الحرام.
وتوضيحه: إن العبد المختار في الجنة يخطر بباله ترك الحسن فلا يخلو أن يمنع من الترك بالنهي والتكليف، أو بإلجاء، أو بأن يضطروا على الفعل والأول مناف لما ثبت من عدم التكليف في الآخرة، والثالث أعني الاضطرار باطل، لأنه تنغيص للعيش وتكدير للذة فيثبت الثاني وهو الالجاء على الترك.
ثانيا بالحل وخلاصته أن الفاعل لا ينحصر فعله أو تركه في الثلاثة بل هناك قسم رابع وهو أن يكون مختارا من دون تكليف ولا اضطرار ولا الجاء ومع ذلك يختار فعل الحسن دائما وترك القبيح كذلك لظهور الحسن عنده على نحو لا يمكن لعاقل مختار تركه وكذلك ظهور قبح القبيح على نحو لا يتصور صدور فعله من عاقل أصلا، كما إن المعصوم (ع) يفعل الحسن دائما ويترك القبيح دائما لا بإلجاء ولا باضطرار بل باختيار، وكما أن بعض الأمور المحبوبة دائمي الصدور مثل أكل ما يتوقف عليه الحياة وبعض الأمور المبغوضة دائمي الترك مثل أكل العذرة، ولا يتوقف شئ منهما على الاضطرار ولا الالجاء ولا توجه التكليف
وأما كلام العلامة الزنجاني فأقول: لقد أجاد فيما أفاد إلا أنه بقيت نكات أشير إليها.
ألف: أوضح أحكام الدار وأهمها الهجرة منه أو إليه فيجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام، ومن دار الاسلام إلى دار الإيمان لقوله (تعالى)… ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها…) النساء ٩٨ ب: قوله قده (من اعتبر مع الكثرة الغلبة) أكثر من اعتبر الغلبة لم يعتبرها مع الكثرة بل جعلها ملاكا مستقلا لعنوان الدار، فلو كانت الأكثرية مع الكفار عددا ولكن كانت السلطة والغلبة مع المسلمين، والقوانين المعمولة فيها إسلامية فهي دار إسلام، ولو كان بالعكس فبالعكس، ولو كانت السلطة والغلبة مع الشيعة، وكانت أكثرية العدد مع العامة فالدار دار إيمان، ولو كانت بالعكس فبالعكس.
نعم هناك جماعة اعتبروا كلا الأمرين الغلبة والكثرة، وظاهر كلام المفيد قده الأول.
ج: قوله قده (أو الكون في ذمة وجوار من مظهرهما) أقول: كون الغلبة والسلطة لطائفة معناه أن القوانين الجارية والأمور الكلية والعامة في داخل المملكة على طبق معتقداتهم أو ميولهم ولا يستلزم ذلك سلب الحرية عن البقية إلا بالنسبة إلى ما يزاحم حقوقهم لا بالكلية فتطبيق هذا القول على كلام المصنف قده بعيد، بل مختاره قده وجود الحرية التامة لأهل الدار وكونهم مسلطين على الأمور قاهرين غالبين فقط لا كونهم ظالمين.
وهنا نكات في عبارة المصنف قده أشير إليها.
١ – المراد بالإيمان هو التشيع بالمعنى الذي تعتقده الإمامية لقوله بعد ذلك
٣ – قوله (وقد تكون الدار عندي دار كفر ملة وإن كانت دار إسلام) المراد بكفر ملة ما ذكره في القول ٦ من قوله اتفقت الإمامية على إن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله (تعالى) من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار… وقال في كتاب الجمل في معنى كفر ملة (… ولم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الاسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة… وإن كانوا بكفرهم خارجين من الإيمان مستحقين اللعنة والخلود في النار…) الجمل ص ٣٠.
والمراد بإسلامهم الأحكام الفقهية الظاهرية التي عبر عنها الفقهاء بقولهم كفار محكومون ببعض أحكام الاسلام مثل الطهارة الظاهرية وحل الذبايح و نحوها.
وقد مر أن ما ذكره في كتاب الجمل مخالف لما هو من ضروريات فقه الشيعة من نجاسة الناصبي وكفره ظاهرا وباطنا، ومعلوم أن أنصب النواصب و أصلهم وإمامهم الذين أسسوا أساس ذلك وبنوا عليه بنيانه هم الذين غصبوا حقه وحاربوا أمير المؤمنين (ع) وقاتلواه ودعوا الناس إلى حربه، فمن أولى منهم
(١١٤) قوله في القول ٨٢ (ويخالف فيه الملحدون)
أقول: نسبة الجزء الذي لا يتجزي إلى الموحدين ونسبة القول بالتجزية إلى الملحدين مبني على ما تسالموا عليه تبعا للفلاسفة من انتهاء الأجسام إلى البسائط والعناصر: الاسطقسات على ما فرضوه من توقف القول بالتوحيد عليه، وإن إنكاره واختيار القول الآخر المنسوب إلى ذيمقراطيس المتهم بإنكار الصانع – وإن شكك فيه صاحب الأسفار – مستلزم لإنكار الصانع، وقد ثبت الآن في العلوم الطبيعية بطلان العناصر الأربعة والاسطقسات بالمعنى المذكور، بل جزؤا كلا من العناصر الأربعة إلى أجزاء كثيرة.
وثبت أيضا بطلان البناء بما ذكر في محله، وأنه يمكن إثبات الصانع على المباني العلمية الجديدة أحسن من المباني الثابتة في الفلسفة اليونانية.
وعليه فكل ما يذكر في هذه الأبواب من نسبة القول إلى إجماع الموحدين أو الملحدين فهو مبني على الملازمات المسلمة عندهم أو بالأقل عند الشيخ المفيد قده بحيث لم يحتمل الخلاف في الملازمة بين ما ذكره من المقدمات العقلية وبين النتائج الدينية الاعتقادية، فنسب الإجماع المنعقد من الموحدين على النتيجة إلى المقدمة، وإجماع الملحدين في زمانه على نقيض النتيجة إجماعا منهم على نقيض المقدمة، وإلا فلا معنى لدعوى الإجماع في المسائل العقلية المحضة في الأمور الغير الدينية.
(١١٥) قوله في القول ٨٣ (بما يختلف في نفسه من الأعراض)
والمهم أن الفلسفة الحديثة قد أبطلت كثيرا من المباني الثابتة في الفلسفة القديمة والكلام القديم بما يغني عن تضييع العمر في الدفاع عنها.
(١١٦) قوله في القول ٨٤ (وبه فارق معنى ما خرج عن حقيقته)
أقول: لا إشكال أن الجوهر بالمعنى الفلسفي أعم من الجسم المتحيز و يشمل الجواهر المجردة المستغنية عن المكان والحيز والزمان وساير الأعراض، و لكن قد أشرنا سابقا أن اصطلاح المتكلمين في الجوهر يختلف عن الحكماء، فهو عندهم بمنزلة العناصر والاسطقسات، بمعنى الأجسام البسيطة، فيشملها الأحكام الكلية للجسم ومنها التحيز وكونه زمانيا ومعروضا للعوارض وغيرها.
(١١٧) قوله في القول ٨٧ (والجبائي وابنه وبنو نوبخت الخ)
أقول: كلمة الجبائي عطف على أبي القاسم البلخي يعني أبا القاسم البلخي والجبائي وابنه وبنو نوبخت يذهبون إلى قبول جملة ما ذكرناه و يخالفوننا في سبب فنائها، وعليه فقوله (وإبراهيم النظام الخ) جملة مستأنفة.
ثم إنه يناسب الرجوع في شرح العبارات هنا إلى شرح المقاصد ج ٥ ص ٩٨.
(١١٨) قوله (وإبراهيم النظام يخالف الجميع ويزعم أن الله يجدد الأجسام حالا فحالا)
أقول: لا يبعد أن يكون مراده ما ذهب إليه صدر المتألهين من الحركة الجوهرية التي تقتضي دخول التدرج في ذوات الأشياء وخصوصية وجوداتها التي هي الجريان والسيلان والانوجاد والانعدام بل هذا هو الظاهر من كلامه.
أو يكون مراده ما ذهب إليه الفيلسوف الألماني إيناشتين من دخول الزمان في داخل ذوات الأشياء كالبعد الخامس على فرض صحته – ولو كان مراد إينشتاين عين ما ذهب إليه صدر المتألهين كما ادعاه البعض فلا مانع من نسبة قولهما إلى النظام أيضا.
وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا كما إن قوله في الجسم بأنه مركب من أجزاء صغار لطيفة مختلفة في الطبيعة يمكن تطبيقها على الآراء الحديثة في الألكترون والبروتون والله العالم.
ومن هنا تعرف ما في كلام العلامة الزنجاني في تعليقته من (أن العلم ببقاء الجواهر وما يتألف منها الأجسام يشهد به الضرورة ولا ينازع فيها إلا مكابر).
أقول: إن أراد البقاء الحسي فهذا واضح لما نرى من بقائها ظاهرا ولا ينافي ما ذكره صدر المتألهين وإيناشتين إذ ليس ما ذكروه بحثا عرفيا حسيا حتى يجاب بالحس ونحوه، بل عقلي يثبت أو ينفى بالبراهين المناسبة له.
(١١٩) قوله في القول ٨٩ (وقد ذكرت ذلك في الجواهر المنفردة)
(١٢٠) قوله (والتأليف عندي وسائر الأعراض لا تبقى)
عطف على قوله (فالأجسام من نوع ما تبقى) وعليه فالمعنى إن الجسم يبقى ولكن التأليف والأعراض لا تبقى وحينئذ يرد عليه أنه ليس الجسم إلا نتيجة تأليف الجواهر فكيف يبقى الجسم من دون تأليف إلا أن يحمل على تأليف الأجسام بعضها مع بعض.
ويمكن أن يكون (الواو) في (والتأليف) مصحف (في) من غلط النساخ والصحيح هكذا (فالأجسام من جنس ما يبقى وقد ذكرت ذلك في الجواهر المنفردة في تأليف عندي) ويكون جملة وساير الأجسام مستأنفة.
(١٢١) قوله في القول ٩٦ (وعلة سكونها أنها في المركز)
أقول: فكان الشيخ قده اعترف أن الأرض على فرض عدم كونها في المركز لا تكون ساكنة فإذا ثبت الآن أنها ليست في المركز بل هي من أقمار الشمس يثبت قهرا عدم سكونها بل حركتها وهذه أيضا مثل بقية الآراء التي أخذها المتكلمون من الحكماء وربما بنوا عليها آراء اعتقادية مع تبين فساد المبني خصوصا في زماننا هذا.
(١٢٢) قول المحشي في القول ٩٧ (كما صرح به الإمام فخر الدين الرازي في أربعينه)
الثاني إن دعوى اتفاق جمهور المتكلمين على ثبوت الخلا جزاف. نعم من رأى الملازمة بين ثبوت الخلا وبين المعاد الجسماني ربما يجعل الاتفاق على جسمانية المعاد اتفاقا على ثبوت الخلا، ولكنه باطل لعدم ثبوت الملازمة عند جميع المتكلمين.
الثالث نسبة القول بثبوت الخلا إلى المفيد ودعوى الغلط في عبارته بهذه السعة وعلى خلاف صريح العبارة ثم تصحيحها بما ذكره المحشي إهانة بالشيخ المفيد وبالنسخ الكثيرة المتفقة على عبارة واحدة لا داعي لها بل من باب إلزام ما لا يلزم. مضافا إلى عدم صحته في نفسه.
وحاصل ما ذكرنا أن الحق عدم ثبوت الخلا كما اختاره الشيخ قده أولا و عدم ابتناء مسألة المعاد به ثانيا وصحة العبارة المذكورة في المتن ثالثا.
أما أصل مسألة وهي عدم ثبوت الخلا فقد بحث عنه مفصلا في الأسفار ج ٤ ص ٤٩ و ٣٤.
وأما عدم ابتناء مسألة المعاد عليه فخلاصة الجواب أن الالتزام بالخلا ينشأ من طلب المكان للجنة والنار وأنهما أو أحدهما لو حصل فوق العالم الذي كانوا يعبرون عنه بمحدد الجهات يلزم أن يكون في اللا مكان مكان وفي اللا جهة جهة، وإن كان في داخل طبقات السماوات والأرض فيلزم إما التداخل وإما
مع أن أصل إثبات المكان على هذا الوجه للجنة والنار باطل، وذلك لما أشار إليه في الأسفار من (أن عالم الآخرة عالم تام لا يخرج عنه شئ من جوهره وما هذا شأنه لا يكون في مكان كما ليس لمجموع هذا العالم أيضا مكان يمكن أن يقع إليه إشارة حسية وضعية من داخله أو خارجه لأن مكان الشئ إنما يتقرر بحسب نسبته إلى ما هو مباين له في وضعه خارج عنه في اضافته، وليس في خارج هذا الدار شئ من جنسه وإلا لم يوجد بتمامه، ولا في داخله ما يكون مفصولا عن جميعه، فلا إشارة حسية إلى هذا العالم إذا أخذ أخذا تاما لا من داخله ولا من خارجه فلا يكون له أين ولا وضع، ولهذا المعنى حكم معلم الفلاسفة بأن العالم بتمامه لامكان له فقد اتضح أن ما يكون عالما تاما فطلب المكان له باطل، والمغالطة نشأ من قياس الجزء بالكل والاشتباه بين الناقص و الكامل إلى أن قال فقد ثبت وتحقق أن الدنيا والآخرة مختلفتان في جوهر الوجود غير منسلكين في سلك واحد فلا وجه لطلب المكان للآخرة…).
أقول: وإذا كان طلب المكان للآخرة لعدم احتواها ودركها كان الالتزام بالخلا وغيره من المحالات لتصحيحه من باب الفرار من المطر إلى الميزاب كما صدر من إمام المشككين في أربعينه وفي غيره. مضافا إلى بطلان الآراء المذكورة في الأفلاك.
(١٢٣) قوله (لما صح فرق بين المجتمع والمتفرق من الجواهر والأجسام)
(١٢٤) قوله في القول ٩٨ (وإنه لا يصح تحرك الجوهر إلا في الأماكن)
قد تكرر نظير هذه العبارة من الشيخ في هذا الكتاب، ومراده ليس تخصيص حركة الجواهر بالأماكن بل الحركة في الزمان وغيره أيضا لا ينكره، بل مراده تخصيص احتياج الجواهر بالمكان بحال حركتها، وإنها لا تحتاج إلى المكان إلا من حيث كونها متحركة كما صرح به سابقا.
(١٢٥) قوله في القول ٩٩ (وعلى هذا القول ساير الموحدين)
أقول: أصل البحث عن الزمان ثم تفسيره على نحو لا يشمل الفلك فما فوقها، ثم جعله قولا للموحدين إشارة إلى أن تصريح المتكلمين بالحدوث الواقعي للعالم في مقابل الفلاسفة القائلين بالحدوث الذاتي لا يستلزم الحدوث الزماني، بل هو جمع بين إثبات الحدوث الحقيقي في متن الواقع وبين إنكار الحدوث الزماني بهذا المعنى إلا أن يفسر الزمان بمعنى آخر.
(١٢٦) قوله في القول ١٠٠ (يتهيأ بها الفعل للانفعال)
(١٢٧) قوله (ومن أجله ما أمكن بها الاحراق)
ظاهر العبارة يفيد خلاف المقصود، فإنه يفيد أن الطبيعة من أجلها لا يمكن الاحراق وإن طبيعة النارية تمنع من الاحراق، وعليه إما تكون كلمه (ما) زائدة في (ما أمكن) أو تبديل كلمة (من أجله) بكلمة (من دونه) وأما احتمال كون (ما) موصولة فلا يرفع الركاكة عن اللفظ وإن صحح المعنى.
(١٢٨) قوله (وإن ما يتولد بالطبع فإنما هو لمسببه بالفعل في المطبوع وإنه لا فعل على الحقيقة لشيئ من الطباع)
أقول: صرح الشيخ أولا بتأثير الطبيعة في تهيأ المحل لقبول الأثر وإن الطبيعة لها سنخية مع الأثر الخاص بها مثل الإحراق مع النار ونحو ذلك.
وعليه فيجب تفسير عبارته هنا بما لا ينافي ما ذكره أولا فيكون مراده من كون ما يتولد بالطبع لمسببه لا لها، الإشارة إلى أن من أشعل نارا وأحرق شيئا ينسب الاحراق إليه لا إلى النار، وهذا بحث عرفي لا فلسفي. بخلاف البحث الذي أشار إليه في أول الفصل وهو مدخلية الطبيعة في ترتب الأثر ووجود سنخية بين الطبايع وآثارها إذ هو بحث معنوي واقعي وقع بين الأشاعرة وبين
ومن غريب ما صدر من العلامة الزنجاني أنه نسب قول العدلية إلى الفلاسفة الطبيعيين وفسره على نحو ينطبق تماما على عقيدة جميع العقلاء و منهم الشيعة إذ ليس فيه ما ينافي التوحيد إلا على مذهب الأشاعرة المنكرين للأسباب والمسببات أو الوهابيين الذين يرون إثبات الأفعال لغير لله (تعالى) منافيا للتوحيد، ولكنه غلط واضح منهم إذ كما أن إثبات الأفعال الاختيارية للعباد لا ينافي التوحيد، كذلك إثبات الأفعال الطبيعية للطبائع، بل كلها من أدلة التوحيد.
ومن الغريب أنه قده ذكر أولا مذهب أكثر الموحدين على نحو لا ينطبق إلا على مذهب الأشاعرة، ثم نسب ما هو عقيلة الشيعة وسائر العدلية إلى الطبيعيين، ثم ذكر مذهب الأشاعرة أخيرا على نحو لا يوجد فرق معنوي بينه و بين ما جعله مذهب أكثر الموحدين إلا في ذكر كلمة (عادة الله) في هذا دون ذلك وهذا لا أثر له بعد ما فرضنا أن افعال الطبايع لا تستند إليها أصلا بل هي من فعل الله (تعالى) فحينئذ يلازم هذان الالتزام بأن عادة الله جرت على خلق هذه الآثار بعد هذه الطبايع.
فالطبيعيون جعلوها ذاتية لها مستغنية عن مسبب الأسباب والموحدون يجعلونها منتهية إلى الفاعل الحقيقي ومسبب الأسباب.
وهذا الاحتمال أولى بأن يجعل تفسيرا لقول المصنف (فإنه لمسببه وإنه لا فعل على الحقيقة لشئ من الطباع).
(١٢٩) قوله في القول ١٠١ كما في بعض النسخ (ولا أراه مسندا لشيئ من التوحيد)
الظاهر أنه تصحيف كلمة (مفسدا) إذ لا معنى لكلمة (مسندا) هنا سواء قرء بصيغة الفاعل أو المفعول.
(١٣٠) قوله في القول ١٠٢ (بلا فصل)
الغرض من عنوان هذا الباب إزاحة شبهة ص لبعض المتكلمين توهموا
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله