عند الاحتكام إلى المقارنة المضمونية بين هذين النحوين من المعرفة، نجد أنّ الروايات المستفيضة عن الفريقين تركّز على معرفة النفس الانسانية، بل في بعضها أنّ «المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين» كما جاء عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقد ذكرت في كلمات الاعلام وجوهاً لانفعية المعرفة الانفسية على المعرفة الآفاقية، مع اشتراكهما جميعاً في الهداية إلى الايمان بالله تعالى، والتمسّك بالدين الحقّ والشريعة الالهية; منها:
الوجه الاوّل: «أنّ كون معرفة الآيات نافعة، إنّما هو لانّ معرفة الآيات بما هي آيات موصلة إلى معرفة الله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله، ككونه تعالى حيّاً لا يعرضه موت، وقادراً لا يشوبه عجز، وعالماً لا يخالطه جهل، وأنّه تعالى هو الخالق لكلّ شيء، والمالك لكلّ شيء، والربّ القائم على كلّ نفس ما كسبت، خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم، بل لينعم عليهم بما استحقوه، ثمّ يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه ، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
هذه وأمثالها معارف حقّة إذا تناولها الانسان وأتقنها، مُثلت له حقيقة حياته، وأنّها حياة مؤبّدة ذات سعادة دائمة أو شقوة لازمة، وليست بتلك المتهوسة المنقطعة اللاهية اللاغية. وهذا موقف علمي يهدي الانسان إلى تكاليف ووظائف بالنسبة إلى ربّه، وبالنسبة إلى أبناء نوعه في الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهي التي نسمّيها بالدين.
غير أنّ النظر إلى آيات الانفس أنفع، فإنّه لا يخلو من العثور على ذات النفس وقواها وأدواتها الروحية والبدنية وما يعرضها من الاعتدال في أمرها أو طغيانها أو خمودها، والملكات الفاضلة أو الرذيلة، والاحوال الحسنة أو السيّئة التي تقارنها.
واشتغال الانسان بمعرفة هذه الامور والاذعان بما يلزمها من أمن أو خطر، وسعادة أو شقاوة، لا ينفك من أن يعرّفه الداء والدواء من موقف قريب، فيشتغل بإصلاح الفاسد منها، والالتزام بصحيحها، بخلاف النظر في الآيات الآفاقية، فإنّه وإن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سفاسف الاخلاق ورذائلها، وتحليتها بالفضائل الروحية ، لكنه ينادي لذلك من مكان بعيد، وهو ظاهر.
الوجه الثاني: وهو معنى أدقّ مستخرج من نتائج الابحاث الحقيقية في علم النفس، وهو أنّ النظر في الآيات الآفاقية والمعرفة الحاصلة من ذلك، نظر فكري وعلم حصولي بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلّية منها، فإنه نظر شهودي وعلم حضوري، والتصديق الفكري يحتاج في تحقّقه إلى نظم الاقيسة واستعمال البرهان، وهو باق ما دام الانسان متوجهاً إلى مقدماته، غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها، ولذلك يزول العلم بزوال الاشراف على دليله، وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه الاختلاف.
وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودها، فإنّه من العيان، فإذا اشتغل الانسان بالنظر إلى آيات نفسه، وشاهد فقرها إلى ربّها، وحاجتها في جميع أطوار وجودها، وجد أمراً عجيباً، وجد نفسه متعلّقة بالعظمة والكبرياء، متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبّها وسائر صفاتها وأفعالها، بما لا يتناهى بهاءً وسناءً وجمالاً وجلالاً وكمالاً من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغيرها من كلّ كمال»( [457]).
وذلك لانّ البرهان العقلي قائم على أنّ المعلول وكلّ شأن من شؤونه هو عين الفقر والحاجة إلى علّته، فإذا وقف الانسان على هذه الحقيقة عياناً وشهوداً، فإنّه لا يمكنه إلاّ أن يقف على خالقه وقيومه وهو الحق تعالى، وهذا ما صرّح به القرآن الكريم في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)( [458])، لذا ورد في جملة من الروايات، أنّه لا يمكن معرفة مخلوق إلاّ بالله، قال الصادق (عليه السلام): «لا يدرك مخلوق شيئاً إلاّ بالله»( [459]).
وهذا هو معنى قول الحكماء الالهيين «إنّ ذوات الاسباب لا تعرف إلاّ بأسبابها».
من هنا نفهم لماذا أنّ الانسان إذا وقف على ملكوت الاشياء، الذي هو وجود الاشياء من جهة انتسابها إلى الله سبحانه وقيامها به، وهو أمر لا يقبل الشركة ويختص به تعالى وحده (فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون)( [460]) لا يمكن إلاّ أن يحصل له اليقين بحسب الاصطلاح القرآني، وهو العلم الذي لا يشوبه شك، لذا رتّب القرآن حصول اليقين لابراهيم الخليل (عليه السلام) على إراءته ملكوت السموات والارض، قال تعالى: (وَكَذلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّموَاتِ وَالاَْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ)( [461]).
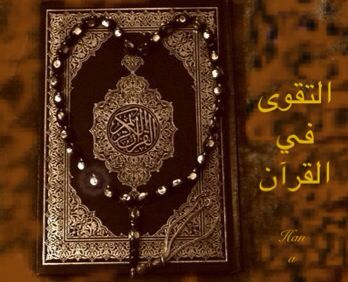
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله




