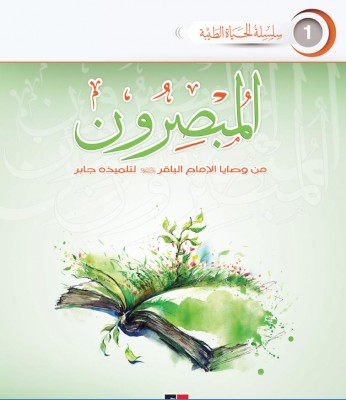بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعزّ المرسلين سيّدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين عليهم السلام، وبعد.
القيهم الأخلاقية هي مجموعة المبادئ والقواعد المنظِّمة لسلوك الفرد والمجتمع المسلم، والتي يُحدّدها الوحي الإلهي، ومن أنزل عليه الوحي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وآله عليهم السلام، وذلك من أجل تنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقّق الغاية من وجوده في هذه الدنيا. وهذا ما يلزم المسلمين جميعاً بالعودة إلى عدل القرآن وهم العترة الطاهرة عليهم السلام، فإنّ أحاديثهم وإرشاداتهم ووصاياهم وسيرتهم العملية كفيلة بتحديد معالم متكاملة وشاملة لمنهج أخلاقي يصلح أن يكون مرجعاً لجميع العلماء والباحثين والمتخصّصين بشؤون التربية والتعليم والتبليغ…
والأخلاق ثابتة ومتصلة بالقيم العليا، لأنّها من صنع الله. ولا شك أنّ فكرة الالتزام الخلقي هي العنصر الأساس الذي تدور عليه القيم الأخلاقية، فإذا زالت فكرة الالتزام يضيع جوهر الحكمة العقلية والعملية التي تهدف الأخلاق إلى تحقيقها، وإذا انعدم الالتزام انعدمت المسؤولية حتماً.
وهذا الكتاب هو محاولة لتثبيت هذه القيم والمبادئ الأخلاقية في النفوس والمجتمعات، وهي عبارة عن مجموعة من الوصايا الأخلاقية القيّمة التي وصّى بها إمامنا الباقر عليه السلام صاحبه جابر الذي تشرّف بخدمة إمامنا الباقر عليه السلام ثماني عشرة سنة، روى عنه خلق كثير من علماء الأمة والحفاظ وحملة الحديث، والثقاة من أصحاب الأئمة: السجاد عليه السلام، والباقر عليه السلام، والصادق عليه السلام، والكاظم عليه السلام، وله منزلة خاصة عند آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم. فقد ورد المدح في حقّه عنهم عليهم السلام، حيث روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: “رحم الله جابر كان يصدق علينا، ولعن الله المغيرة، فإنّه يكذب علينا“[1].
وروى الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص بإسناد صحيح إلى
عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام إذ دخل المفضل بن عمر، فلما بصر به ضحك إليه، ثم قال: إلي يا مفضل – إلى أن قال: – فقال: يا بن رسول الله، فما منزلة جابر بن يزيد منكم؟ فقال عليه السلام: “منزلة سلمان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم“[2].
والحمد لله رب العالمين
مركز نون للتأليف والترجمة
الدرس الأول: المبصرون، لا يظلمون
نص الوصيّة:
عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه وصاحبه جابر قال: “إِنْ ظُلِمْتَ فَلا تَظْلِمْ“[3].
المحاور:
-
المقدمة.
-
معنى الظلم، ومفهومه.
-
أنواع الظلم:
أ – ظلم العبد لربّه
ب- ظلم العبد لغيره
ج- ظلم الإنسان نفسه
-
عافية الظلم.
مقدّمة
لمَّا كانَ الظُّلمُ والعُدوانُ مُنافِيَينِ للعدْلِ والحقِّ الذي اتَّصفَ بهِ الملِكُ الديَّانُ، ومنافِيَينِ للميزانِ, الذي قامتْ بهِ الأرضُ والسماواتُ، وحُكِمَ بهِ قِسطاً وعدلاً بيْنَ جميعِ المخلوقاتِ، كانَ الظُّلمُ والعُدوانُ عندَ اللهِ تعالى مِنْ أكبرِ الكبائرِ والمُوبقاتِ، وكانتْ درَجتُهُ فِي الجُرْمِ والإثمِ بحسبِ مفسدتِهِ في الأفرادِ والأمم. ولأنّ الرسالات الإلهية ترى في العدل أسمَى غايةٍ، وأشرف وسيلةٍ، وأعظم طُلبةٍ، وخير ما حُفِظَتْ بهِ المكانَةُ، ونِيْلتْ بهِ العزةُ والكرامةُ، وبَقيتْ بهِ الديارُ ودامَ الأمانُ والاستقرارُ، وتريد له (العدل) أن يشمل كل ميادين الحياة تحقيقاً للسعادةِ في الدارين، لذلك أخبر الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله تعالَى أنه جعلَ الظلم بينَ عبادِه مُحرَّماً.
ولقد شخّص حفيد سيد المرسلين مولانا الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام الأمراض الأخلاقية والاجتماعية التي يُبتلى الناس بها، فوضع لها العلاج اللازم والدواء الحاسم، فأوصى تلميذه النجيب جابر بن يزيد الجعفي بوصايا خالدة وشاملة لجميع القيم الكريمة، والمثل العليا التي يسمو بها الإنسان إلى أعلى المراتب الإنسانية فيما لو طبّقها على واقع حياته، فتعالوا نقتبس من هذه الوصايا قبسات لعلّ الله ينوّر بها قلوبنا، ويُبصرّنا حقائق أنفسنا، ويهدينا إلى صراطه القويم ﴿هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾[4].
فلنبدأ أوّلاً بتوضيح الجملة الأولى عبر طرح السؤال التالي: ما هو تعريف الظلم، وما مفهومه؟
وحيث إنّ البحث الأدبيّ واللغويّ قد يكون مملاًّ، فسنشير إليه إشارة نافعة ومقتضبة.
تعريف الظلم
قال ابن فارس: “الظاء واللام والميم أصلان صحيحان، أحدهما: خلاف الضياء والنور، والآخر: وضع الشيء غير موضعه تعدّياً”[5].
وقال الجوهري: “ظلمه يظلمه ظلم ومظلمة، وأصله وضع الشيء في غير موضعه“[6].
وفي المثل “من استرعى الذئب فقد ظلم” ولأجل ذلك يُعد العدول عن الطريق ظلماً، يقال: “لزموا الطريق فلم يظلموه” أي لم يعدلوا عنه[7].
الظلم في الاصطلاح
الظلم هو: التصرّف في حقّ الغير بغير حقّ، أو مجاوزة الحق. وقيل: الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والتصرّف في حقّ الغير، ومجاوزة حدّ الشارع.
مفهوم الظلم
يُعد الظلم إحدى طبائع النفس البشرية، ومن السجايا الراسخة في أغلب النفوس، تُظهره القوة ويُخفيه الضعف، وقد عانت منه البشرية في تاريخها المديد ألوان المآسي والأهوال، ممّا جهّم الحياة، ووسمها بطابع كئيب رهيب، والإنسان خُلق ظلوماً جهولاً، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يُعلّمه الله ما ينفعه ويُلهِمه رشدَه قال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾[8]، فمن أراد الله به خيراً علّمه ما ينفعه فخرج به عن الجهل، ونفعه بما علّمه فخرج به عن الظلم، فأصل كلّ خير هو العلم والعدل، وأصل كل شرّ هو الجهل والظلم. وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حدًّا، فمن تجاوزه كان ظالماً معتدِياً، وله من الذمّ والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه، لأنّ الظلم أيّها الأحبّة جماع الآثام ومنبع الشرور، وداعية الفساد والدمار وهو الذي يحمل الإنسان على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضى، ويرضى في موضع الغضب، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدّة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزّة، ويتكبّر في موضع التواضع.
أنواع الظلم
الظلم كلمة عامة يحملها الناس على محمل ونوع واحد، لكن المتدبّر منهم يعلم أنّ الظلم ثلاثة أنواع، وهو بحسب من يقع عليه:
1- ظلم العبد لربّه:
بأن يُشرك به، فيجعل العبد لله ندّاً وهو خلقه، قال عزّ وجلّ حكاية عن لقمان عليه السلام، وهو يعظ ابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾[9].
عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: “حقّ الله الأكبر علينا أن نعبده لا نشرك به شيئاً“[10]، “فإن نحن لم نراع هذا الحقّ واخترنا غيره معبوداً كالهوى مثلاً وفقاً لقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾[11]، فإنّ اختيارنا هذا هو بمثابة التجاوز على حقّ الله تعالى والظلم له، وهو ظلم عظيم للغاية, ذلك أنّه كلّما كان الطرف المقابل أعظم شأناً وحقّه أكبر فإنّ الظلم الناجم من عدم مراعاتنا لحقّه يكون أعظم وأخطر. ومن هنا نستنتج أنّ للظلم مراتبَ مختلفةً. فهل يوجد من هو أعظم من الله جلّ شأنه يا ترى؟ وهل من حقّ هو أكبر من حقّ الله ؟”[12].
ومن الثابت أن عظمة كل عمل بعظمة أثره، وعظمة المعصية بعظمة المعصي، فإنّ مؤاخذة العظيم عظيمة، فمن أشرك بالله أو عدل به غيره أو اتخذ له سبحانه ندّاً، فقد ارتكب الظلم الأعظم، وخلع ربقة الإسلام من عنقه، و ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾[13].
ويفهم ممّا تقدّم أنّ الذي عناه وقصده الإمام الباقر عليه السلام في وصيّته الخاصّة لتلميذه لجابر ليس هو الظلم بهذا المعنى، وهو عليه السلام لم يقصد بوصيّته القول: “يا جابر! لا تظلم”، أي: لا تشرك بالله، فكلّ مؤمن يفهم بأنّه لا ينبغي له أن يرتكب هذا النوع من الظلم، وإلا لما كان مؤمناً، بل لقد أراد عليه السلام بنصيحته لجابر معنىً آخر ونوعاً آخر غير هذا النوع من أنواع الظلم”[14].
2- ظلم الإنسان نفسه:
الذي يفهم من لفظ الظلم وجود ظالم صدر منه الظلم، ومظلوم وقع عليه الظلم فمن هو الظالم، ومن هو المظلوم ؟ إنه هذا الإنسان المسكين، هو الظالم والمظلوم , ظلم نفسه وأوبقها، وظلم عباد الله عزّ وجلّ، فأساء إليهم، وأساء إلى نفسه وظلمها بما يُعرّضها من العقوبات في الدنيا والآخرة، وذلك بقطع صلتها مع الله تعالى، وبإهمال توجيهها إلى طاعة الله، وتقويمها بالخلق الكريم، والسلوك الرضي، ممّا يزجّها في متاهات الغواية والضلال، فتبوء آنذاك بالخيبة والخسران كما عبّر الله تعالى في الفرقان: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾[15]، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[16]،
وقال سبحانه: ﴿سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ﴾[17]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[18].
وظلم العبد لنفسه يكون فيما بينه وبين ربّه، ويتحقّق ذلك عندما يقطع العبد الصلة النورانية بينه وبين نور السموات والأرض الذي مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. والظلم خلاف الضياء والنور، ويتحقّق ذلك من خلال تقصير العبد الظالم لنفسه في المسارعة لتنفيذ أوامر الله تعالى، وفي الجرأة على إتيان نواهيه.
أعلم أخي المسلم: أنك إذا تعدّيت حدود الله ببصرك، فنظرت به إلى الحرام، فقد عملت سوءً وظلمت نفسك، وإذا تعدّيت حدود الله بأذنك فسمعت بها الحرام من الغناء أو الكذب أو الغيبة أو النميمة، فقد عملت سوءً وظلمت نفسك، وإذا تكلّمت بلسانك كلاماً يسخط الله فقد عملت سوءً وظلمت نفسك، وإذا بطشت بيدك أو مددتها على ما لا يحل، فقد عملت سوءً وظلمت نفسك، وعندما تسمع الأذان وتنام، ولا تقوم لتصلّي، فقد عملت سوءً وظلمت نفسك, لأنّ الله دعاك إلى إنقاذ نفسك فظلمتها.
الذي يهجر القرآن، ولا يقرأه ظالم لنفسه، لأنّه فوّت على نفسه من الحسنات ما لا يعلمها إلا الله تعالى الذي لا يذكر الله، ولا يدعوه، ولا يهتم بأمر المسلمين ولا يهتم بهذا الدين ظالم لنفسه الخ.
قال مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: “ألّا وإنّ الظلم ثلاثة: فظلم لا يُغفر، وظلم لا يُترك، وظلم مغفور لا يُطلب، أمّا الظلم الذي لا يُغفر، فالشرك بالله. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾[19]، وأمّا الظلم الذي يُغفر، فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، وأمّا الظلم الذي لا يُترك فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص هناك شديد، ليس هو جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسياط، ولكنّه ما يستصغر ذلك معه..”[20].
3- ظلم العبد لغيره:
أي الظلم الذي بينه وبين الناس، وإياه قصد الله تعالى بقوله: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ* إِنَّمَا
السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[21]، وهو ظلم لا يمكن الخروج منه، والتخلّص من شؤمه وإثمه بمجرّد الإقلاع والندم، بل يكون الخلاص منه بردّ المظالم إلى أهلها، أو استباحتهم منها، وإلا كان القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، وليس بالدينار والدرهم، وكفى بهذا حاجزاً عن الظلم، وكفى به رادعاً وواعظاً للعبد المسلم في أن يتخفّف من حقوق العباد، ويخرج من هذه الدنيا سالماً لا يطلبه أحد من العباد بمظلمة في دين أو نفس أو مال أو عرض، فقد روى أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام قال: “أما إنّه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم. أما إنّ المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من مال المظلوم، ثم قال: من يفعل الشر بالناس، فلا ينكر الشر إذا فُعل به..”[22].
وكي لا يمتطي الظالم سفينة الغفلة، فيرد موارد الهلاك، بجرأته على حقوق الآخرين بادر رحمة الله المهداة للعالمين بإغلاق كل المنافذ على الظلم والظالمين، وذلك من خلال فصل خطابه، وعظيم جوابه فروى عنه حفيده الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “ألا أنبّئكم بالمؤمن ؟ المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أموالهم وأمورهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السيئات فترك ما حرّم الله”[23]، وقال حفيده العظيم الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: “المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله لا يخونه ولا يخدعه، ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه[24].
بعض أنواع ظلم الغير
ومن الملاحظ أنَّ ظلم الغير له صور معدودة وكثيرة لا تنحصر بما ذكرناه منها على سبيل المثال:
1- ظلم باللسان: كالسبّ والشتم، والغيبة والنميمة، والبهتان والسخرية، والقذف وشهادة الزور..
2- ظلم بالفعل: كالقتل والضرب وأكل الربا والزنا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين والأرحام، والتجسُّس وتتبع العورات، والمماطلة في المعاملات، والغصب والسرقة، والاختلاس، وتطفيف المكيال والميزان، والعسف والتغرير بالعامل، وخيانة الودائع والأجير، كل ذلك
وأمثاله من المعاملات والتعاملات والعلاقات، التفريط فيها والخيانة لها والغش فيها ظلم مقت الله أهله وأحاطت بالديار عواقبه، و﴿بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾[25]، وقد ورد ذكر الظلم بصورتيه، وفي قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم “سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”[26]، فتأمّل لترى أنّ السباب صورة من صور الظلم الذي يكون باللسان، وأما القتل، فصورة أخرى للظلم ويكون فعلاً وهو أشدّ صور ظلم المخلوقين: قال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾[27]، وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “لا يزال المؤمن في فسحة مِن دينه ما لم يُصِب دماً حراماً”[28].
عاقبة الظلم
إنّ المتتبّع يعلم أنّ هذه الأمور لا تكاد تخرج مظالم العباد عنها،، ومردّها كلها للنوع الثالث من أنواع الظلم القبيح والفسق الصريح، الذي يربأ عنه عدول المؤمنين، وقد حذّر الله سبحانه وتعالى منها أشد التحذير فقال في محكم كتابه: ﴿إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾[29]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾[30] وقال عزّ من قائل: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾[31] وقال تبارك وتعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾[32]، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾[33] إلى الكثير الكثير من الآيات القرآنية الكريمة التي توعّد الله بها الظالمين بطردهم من ساحة رحمته، وإحباط أعمالهم، وبالعقاب العظيم في الدنيا، والعذاب الشديد في الآخرةـ، وقد بين النبي الأكرم والأئمة الطاهرين من أهل بيته عليهم السلام أن لأنواع الظلم في دار الدنيا آثاراً مشينة، وعواقب وخيمة، ونتائج مدمرة للفرد والمجتمع مضافاً للخزي والندامة في الدار الآخرة، وبيان ذلك فيما رواه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.. قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلّم: “اتقوا الظلم، فإنّه ظلمات يوم القيامة“[34]. وأقسم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قائلاً: “والله لأن أبيت على حسك السّعدان مسهّداً، وأجرّ في الأغلال مصفّداً، أحبّ إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولها، ويطول في الثّرى حلولها”[35]، وقال عليه السلام: “من خاف القصاص كفّ عن ظلم الناس“[36]، وقال أبو بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: “من أكل من مال أخيه ظلماً، ولم يردّه إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة”[37].
ولما سُئِل مولانا الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾[38] قال: “قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة“[39]. وجاء شيخ من النخع فقال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: إنّي لم أزل والياً منذ زمن الحجّاج إلى يومي هذا فهل لي من توبة؟ قال: فسكت ثم أعدت عليه. فقال: “لا حتى تؤدّي إلى كلّ ذي حقٍّ حقّه“[40]. وقال مولانا الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: “الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله، فأمّا الظلم الذي لا يغفره، فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره، فظلم الرجل نفسه، فيما بينه وبين الله، وأمّا الظلم الذي لا يدعه، فالمداينة بين العباد”[41].
الدرس الثاني: للمظلوم ناصرون
نصّ الوصيّة:
عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه وصاحبه جابر قال: “إِنْ ظُلِمْتَ فَلا تَظْلِمْ“[42].
المحاور:
-
المقدّمة.
-
من عواقب الظلم.
-
من إرشادات المعصومين عليهم السلام.
-
وجوب نصرة المظلوم.
-
تحريم مساعدة الظالم.
مقدّمة
من سنن الله تعالى أن لا يهلك الأمم بظلمها إذا قام فيها عباد مصلحون يأخذون على يدي الظالم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾[43]، والآية من سورة هود، وهي من السور التي تتحدّث عن مصارع الظالمين، ونهاية المجرمين والمفسدين في الأرض. “وبملاحظة التفاوت بين كلمتي “مصلح” و“صالح” تتجلّى هذه المسألة الدقيقة، وهي أنّ الصلاح وحده لا يضمنُ البقاء، بل إذا كان المجتمع فاسداً ولكن أفراده يسيرون باتجاه إصلاح الأُمور فالمجتمع يكون له حق البقاء والحياة أيضاً، فلو انعدم الصالح والمصلح في المجتمع فإنّ من سنّةِ الخلقِ أن يُحرم ذلك المجتمع حق الحياة ويهلك عاجلاً، وبتعبير آخر: متى كان المجتمع ظالماً ولكنّه مقبل على إصلاح نفسه، فهذا المجتمع يبقى، ولكن إِذا كان المجتمع ظالماً ولم يُقبل على نفسه، فيصلحها أو يطهرها، فإنّ مصيره إلى الفناء والهلاك”[44].
من عواقب الظلم
ذكر الله تعالى قصص الأمم السابقة الظالمة، وما حلّ بها من عقوبات حيث كان يطغى فيها الظالمون ويعبث فيها المفسدون، فلا ينهض من يدفع الظلم وينصر المظلوم على الظالم فيصلح ما أفسدوا، فحقّت سنّة الله على تلك الأمم، إمّا بهلاك الاستئصال، وإمّا بهلاك الانحلال والاختلال، فقال سبحانه: ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ وَكُلٌّ كَانُواْ ظَالِمِينَ﴾[45]، ولقد حفل القرآن الكريم بالأخبار الكثيرة عن مصارع الظالمين ومصير المفسدين، ومنهم الذين عمَّرُوا عمرانًا عظيماً، وشيَّدُوا حضارات عتيدة، وظنّوا أنهم بلغوا الغاية في القوة والعزّة فغرّتهم أنفسهم، وأصرّوا على ظلمهم وفسادهم رغم الآيات والنذر، فحقّت عليهم كلمة العذاب، وأصبحوا أثراً بعد عين وخبراً لا يُتْلَى إلا للتذكرة والاعتبار: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[46]، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾[47]، ولقد كانوا كما قال مولانا أمير المؤمنين عليهما السلام: “أطول منكم أعماراً، وأبين آثاراً، وأعد منكم عديداً، وأكثف منكم جنوداً، وأشدّ منكم عنوداً“[48].
إنَّ مَا حلَّ بالأُمَمِ السَّالِفةِ, ومَا نَزَلَ بالقُرونِ الهالِكةِ: قريبٌ مِمَّنْ شاكَلَ أوصافَهُمْ, ومُوشِكٌ أنْ يَحِلَّ بِمَنْ حَاكَى أعرافَهُمْ، كمَا قالَ اللهُ تعالَى:﴿فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ * مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾[49]، فالظلم له نهاية والمكر السيئ يحيق بأهله، وما بين كبرياء زعماء قريش ومقولتهم: لا بد أن نرد بدراً ونشرب الخمور وتعزف علينا القيان وتعلم العرب أنَّا نحن الناس، وبين صرعاهم المرميين في قليب بدر عبرةً لمن اعتبر.
الظلم نار فلا تحقر صغيرته لعل جذوة نار أحرقت بلدا
الظلم علّة الهلاك والسقوط
الظلم ليس سببًا من أسباب الهزيمة، فحسب بل هو سبب من أسباب هلاك الأمم وسقوط الدول، وتغيّر الأحوال، ويكفي في بيان سوء عاقبة الظلم قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾[50]، وللعلم والبيان: إنّ عذاب الله ليس بمقتصر على من تقدّم من الأمم الظالمة، بل إنّ سنّته تعالى في أخذ كل الظالمين سنة واحدة فلا ينبغي أن يظن أحد أن هذا الهلاك قاصر بأولئك الظلمة السابقين: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾[51].
إيّاك وظلم من لا يجد ناصراً
لقد نبّهنا مولانا الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام قائلاً: لمّا حضر علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة ضمنّي إلى صدره، ثم قال: “يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة، قال: يا
بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله”[52]، وهذه الرواية الجليلة برسم كل مُحبّ لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وحبّذا لو أن كل واحد منّا يُعطيها قدراً من التأمّل، ويتدبّر قول الإمام زين العابدين عليه السلام: “يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة” يعني أن هذه الوصية كانت في اللحظات الأخيرة من حياة سيد الشهداء مولانا الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام حين دخل على خيمة إمامنا السجّاد أخر مرّة من يوم العاشر من المحرّم، وجراحاته تشخب دماً ليوصيه بوصاياه، ويقول له: بني علي: إيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله، وإن عطش إمامنا الحُسين وجوعه وغربته، وعناءه والذب عن حرائر بيت الرسالة، ووقوفه وحيداً فريداً لا ناصر له ولا معين، كل هذا لم يمنع مولانا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن يؤدّي هذه الوصية لولده الإمام زين العابدين كي يوصلها إلينا – لماذا؟ باختصار لأنه عليه السلام رحمة الله الواسعة كجدّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، ويريد منّا أن نبقى في ساحة رحمة الله، لا أن نكون محطّ غضب الله جلّ شأنه، فقد قال والده أمير المؤمنين عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “يقول الله عزّ وجلّ: اشتدّ غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري“[53]. وعوائد غضب الله تعالى على الظالم في هذه الدنيا كثيرة جدّاً ومن أخزاها ما جاء في رواية الإمام الصادق عليه السلام حيث قال مبتدئاً: “من ظلم سلّط الله عليه من يظلمه. أو على عقب عقبه:، قلت: هو يظلم، فيُسلّط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟! فقال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا﴾[54]، ومن قرأ كتاب الله تعالى يجد أنّ الله حمد نفسه عند هلاك الظالمين، فقال: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[55]. والروايات الشريفة كثيرة في تحريم الظلم، وفيما تقدّم بيان كافٍ وحافز كبير لفضل القيام بنصرة المظلوم وحمايته من عسف الجائرين حيث إنّ ذلك من أهمّ أسباب دفع البلاء واستجلاب النعماء، والسلامة من العقوبات، والنجاة في الدنيا والآخرة،هذا مع وقعها الجميل، وآثارها الطيبة في حياة الانسان الروحية والمادية.
وجوب نصرة المظلوم
إنّ من أوجب الواجبات على أبناء الأمة، وخصوصاً أهل العلم منهم سعيهم لرفع الظلم عن
المظلومين من البرية، إذ السكوت عن ذلك من المهالك الردية، ولقد كان من دأب خلّص الموالين لأهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام نصرة المظلوم على الظالم حتى في أحلك الظروف ظلمة، ولم يقتصر دفاع علمائهم على المظلومين من المسلمين، بل تعدّاه إلى المناداة برفع الظلم عن أهل الذمّة الذين يعيشون بينهم وفي جوارهم لأنّهم يعتبرون نصرة المظلوم واجباً دينياً وأخلاقياً على كل من شهد الظلم، ويملك القدرة على رفعه أو الحد منه، ويعتبرون ذلك من أفضل الطاعات، وأعظم القربات إلى الله عزّ وجلّ حيث إنّ الله تعالى أقسم بعزّته على نُصرة المظلوم، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في وصيّته: “يا علي أربعة لا يُردّ لهم دعوة إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم يقول الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالي لأنصرنّك ولو بعد حين”[56]. انطلاقاً من ذلك وتنفيذاً لأمر الذي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلّم حيث روى حفيده الإمام الصادق جعفر بن محمد عن آبائه الكرام قال: “أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بسبع: أمرهم بعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وإبرار القسم، وتسميت العاطس[57] ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي“[58]، وكان صلى الله عليه وآله وسلّم يشحذ همم المسلمين ويحثّهم على نصرة المظلوم فورد عنه: “ومن أخذ للمظلوم من الظالم كان معي في الجنة مصاحباً”[59].
وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلّم: “ومن مشى مع مظلوم يعينه، ثبّت الله قدميه يوم تزلّ الأقدام”[60]. فمن مقتضيات العدل نصرة المظلوم، وتكون النصرة بتقديم العون له متى احتاج إليه، ودفع الظلم عنه إن كان مظلوماً، وردعه عن الظلم إن كان ظالماً تحقيقًا لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم “انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالماً؟ قال: تردّه عن ظلمه، فذلك نصرك إيّاه”[61]. وقال الإمام الصادق عليه السلام: “ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه، وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه، وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة“[62].
وفي قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم: “مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى
بعضه تداعى سائره بالسهر والحمى”[63]، و”المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا”[64] بيان لروح الإسلام، وحقيقته، وهي أحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وتحثّهم على التراحم، والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وحيث إن – كلام الإمام إمام الكلام، وقول المرتضى مُرتضى – نستشهد بقول ربيب سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلّم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: “أحسن العدل نصرة المظلوم“[65]، وقال عليه السلام: “خض الغمرات إلى الحق حيث كان“[66].
حرمة مساعدة الظالم والركون إليه
إنّ أحد أهم العوامل التي تُهيّىء المجتمع الإسلامي للقيام بنصرة المظلوم هو البعد كل البعد عن إعانة الظالم وتقديم أي نوع من أنواع المساعدة له، لماذا؟ لأنّ مساعدة الظالم تجعله يتمادى في الطغيان، ويكون أكثر وقاحة في اقتراف المزيد من الظلم وأعمال الباطل، وكثير مِن الظلمة لا يباشرون الظلم بأنفسهم بل يجدون أعواناً لهم يعينونهم، ويُسهِّلونه عليهم، ولا يعلمون أنهم في الإثم سواء قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[67].
“ومن عظم خطر الظلم وسوء مغبّته أن نهى الله تعالى عن معاونة الظالمين والركون إليهم: ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾[68]. هذا هو أدب القرآن الكريم، وهو أدب آل البيت عليهم السلام، وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون إلى الظالمين، والاتّصال بهم، ومشاركتهم في أي عمل كان، ومعاونتهم ولو بشقّ تمرة، ولا شك أنّ أعظم ما مُني به الإسلام والمسلمون هو التساهل مع أهل الجور، والتغاضي عن مساوئهم، والتعامل معهم، فضلاً عن ممالأتهم ومناصرتهم وإعانتهم على ظلمهم…. لقد جاهد الأئمة عليهم السلام في إبعاد من يتّصل بهم عن التعاون مع الظالمين، وشدّدوا على أوليائهم في مسايرة أهل الظلم والجور وممالأتهم، ولا يحصى ما ورد عنهم في هذا الباب”[69]. فقد روي عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم
أنه قال: “من أعان ظالماً سلّطه الله عليه“[70]، وعنه صلى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: “من مشى مع ظالم فقد أجرم، يقول الله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾[71].[72]
ولأنّ في نصرة المظلوم حتى يأخذ حقّه، والأخذ على يد الظالم حتى يكفّ عن تعديه حفظ نظام المجتمع، وحماية الضعفاء من تسلّط الأقوياء، سعى أئمة الهدى عليهم السلام بكل ما أتاهم الله تعالى لإقامة حكمه في الأرض، وهو الحكم الذي يقتص فيه للمظلوم من الظالم، ويلقى المحسن والمسيء كل جزاءه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: “لم تكن بيعتكم إياي فلتة، وليس أمري وأمركم واحداً إنّي أريدكم لله، وأنتم تريدونني لأنفسكم. أيها الناس أعينوني على أنفسكم، وأيم الله – لأنصفنّ المظلوم، ولأقودنّ الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق، وإن كان كارهاً -“[73].
ومن أجل إدانة الباطل، وتأييد الحق، وتربية النفوس على مقت الظلم ورفضه، والبراءة من الظالمين أوصى مولانا أمير المؤمنين الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهم السلام قائلاً: “كونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً“، وأتبعها بقوله عليه السلام: “أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي ..”[74]، وخاطب نوف البكالي واعظاً: “يا نوف إن سرك أن تكون معي يوم القيامة، فلا تكن للظالمين معيناً”[75]، وروى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق قال: “سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: “من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطاً حتى ينزع من معونته”[76].
وقد أمر عليه السلام صفوان بن مهران الجمال بأن يخاطب الإمام الحسين عليه السلام في الزيارة الشهيرة المعروفة بزيارة عرفة قائلاً: “… فلعن الله أمةً قتلتك، ولعن الله أمةً ظلمتك ولعن الله أمةً سمعت بذلك فرضت به..”[77] ، ويرشدنا مولانا الإمام علي بن الحسين عليهما السلام في دعاء مكارم الأخلاق للاعتذار من الله سبحانه إن لم تكن لنا القدرة على نصرة المظلوم: “اللهم إنّي أعتذر إليك من مظلوم ظُلم بحضرتي، فلم أنصره“[78]، وفي دعاء العهد المروي عن إمامنا
الصادق عليه السلام والذي يقول في فضله من دعا إلى الله أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار قائمنا.. “اللهم واجعله مفزعاً للمظلوم من عبادك، وناصراً لمن لا يجد ناصراً غيرك،..”[79].
الدرس الثالث: لا يخونون
نصّ الوصيّة:
روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر قال: “وَإِنْ خَانُوكَ فَلا تَخُنْ”[80].
المحاور:
-
مقدّمة.
-
تعريف الخيانة لغة.
-
تعريف الخيانة اصطلاحاً.
-
أصناف الخيانة.
-
من الأثار السيئة للخيانة.
مقدّمة
الوصية الأخرى التي يوصي بها الإمام الباقر عليه السلام جابر هي: “وَإِنْ خَانُوكَ فَلا تَخُنْ“[81], أي: إذا خانك الناس فلا تُبادرهم بالخيانة. والخيانة بالطبع هي إحدى مصاديق الظلم، لكنّ ذكرها بالخصوص هو من باب الاهتمام ببعض مصاديق الظلم التي قد لا تتبادر إلى الذهن.
والخيانة هي ذلك الفكر المظلم والسلوك الشاذ الناشئ عن الجهل والظلم والذي يؤدّي إلى ترك ما يجب حفظه ورعايته من حقوق والتعدّي عليها والتفريط فيها، و”الخيانة” آفة دنيئة تأباها النفوس الشريفة، وترفضها العقول السوية، وتمجّها الطباع الكريمة بغضّ النظر عن دين أو مذهب أو قومية أو عرق أصحاب تلك الطباع.
تعريف الخيانة لغةً
إنّ الجذر اللغوي لها هو مادة “خان” بمعنى انتقص، يخون خوناً وخيانة وخانة ومخانة، فالخاء والواو والنون أصل واحد معناه التنقص والضعف، يقال: في ظهره خون أي ضعف، والخون أن يؤتمن المرء فلا ينصح، والخيانة التفريط في الأمانة، وخانه إذا لم يف له، وخان السيف إذا نبا عن الضربة، وخانه الدهر إذا تغيّر حاله إلى الشر، وناقض العهد خائن لأنّه كان يُنتظر منه الوفاء فغدر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[82].
واختانه فهو خائن وخؤون وخوَّان وخائنة، ومنه قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾[83].
أي: ما يسارق المرء من النظر نظر ريبة إلى ما لا يحل له، وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: “إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين”[84].
تعريف الخيانة اصطلاحاً
لمّا نزل القرآن الكريم نقل اللفظ “الخيانة” إلى معناها المصطلحي المتضمّن للغدر والكذب وتزييف الحق وتزوير الوقائع والتجسّس وكشف عورات المسلمين والمجتمع الإسلامي بالقول والعمل والإشارة والعبارة، هذا المعنى الذي يُحدّد معالم شخصية مريضة حاقدة مضطربة، دنيئة لئيمة، تُطْرَدُ من الصف المسلم إن تعذّر تقويمها وإصلاحها.
لقد شمل لفظ “الخيانة” بذلك معاني واضحة تُحدّد معالم الأشرار، لا تركن إليها نفوس الأحرار، ولا ترتضع ألبانها أفواه الأبرار، معاني تركس منظومة الأخلاق في مستنقع الرذيلة والفساد ركساً، وتحطّم كل مفاهيم العبادات والمعاملات من باب الطهارة إلى باب الديات مروراً بنظم الحكم والاقتصاد والاجتماع والسياسات: فمن لم يُهذّب نفسه ولم ينتفع بعقله، فقد خان نفسه، ومن استسلم لحلاوة المال أو الجاه أو القوة، فقد خان نفسه، ومن عشي بصره عن عيوبه، ومَرضَ قلبه باتباع الهوى، فقد خان نفسه، ومن غرّته المطامع وأعمته الأماني، فقد خان نفسه، ومن غُلَّ عقله بالغضب والشهوة، فقد خان نفسه، ومن مدحك بما ليس فيك فقد خانك، ومن ستر عنك الرشد اتباعاً لما تهوى، فقد خانك، ومن ساترك عيبك فقد خانك، ومن كان معك في أمر جامع واستبدّ برأيه عليك، فقد خانك…
وعندما يتعرّض المرء لخيانة فإنّه يتولّد في داخله دافع لتخطّي حدود الحقّ. إذن فإنّ عبارة: “وَإِنْ خَانُوكَ فَلا تَخُنْ” تُمثّل هي الأخرى إنذاراً للإنسان بأن لا يتعدّى على حدود الحقّ في مثل هذه المواقف. في حين أنّه ليس ثمّة ما يوجب الالتزام والتمسّك بذلك العقد الذي ألغي بخيانة الطرف المقابل. بالطبع قد يبقى الإنسان ملتزماً بعهده حتّى في مثل هذه المواطن رعايةً منه لأمر أخلاقيّ أو تربويّ وهو أن يلقّن الطرف المقابل درساً وينبّهه لخطئه، كما مرّ بيانه في مسألة العفو والصفح، فإن طُرحت أمثال هذه الأمور فستشكّل موارد استثنائيّة قد تكون مطلوبة بعناوين أخرى”[85].
أصناف الخيانة
إنّ أعمال الخيانة متعدّدة ومتنوّعة، ولكن لها باعتبار من وجّهت ضدّه أربعة أصناف حدّدتها آيتان كريمتان هما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[86].
وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾[87].
1ـ خيانة لله عز وجل.
2ـ خيانة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم.
3ـ خيانة للأمانة.
4ـ خيانة للنفس.
والخيانة في هذه الأصناف الأربعة خيانة واحدة، لأنها كالأواني المستطرقة، يصبّ بعضها في بعض، إذ خيانة النفس خيانة لله وللرسول وللأمانة، وكذلك خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الأمانة، فإنّ ورودها مفصّلة في القرآن الكريم ومبينة في السنة النبوية وأحاديث أئمة الهدى عليهم السلام يراد به زيادة التوضيح، والتحذير والتنبيه، والحثّ على اجتنابها والبعد عن أهلها.
1- خيانة المرء لله تعالى:
تتمثّل أول ما تتمثّل في الكفر والشرك كونهما رأس الموبقات، لأنّ حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئاً، فإن أنت لم تؤدِّ هذا الحق، واخترت غيره معبوداً كالهوى مثلاً وفقاً لقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾[88]، فإنّ اختيارك هذا هو بمثابة الخيانة العظمى, ذلك أنّه كلّما كان الطرف المقابل أعظم شأناً وحقّه أكبر فإنّ الخيانة الناجمة من عدم مراعاتنا لحقّه تكون أعظم وأخطر، وتتمثّل خيانة المرء لله تعالى أيضاً بمرضى القلوب داخل الصف المسلم ويُجسّدها النفاقان العقدي والعملي بوضوح، وذلك من خلال إظهار الإيمان والعمل الصالح وإسرار الشرك والرياء، وعدم الوفاء بعهد الله.
2- خيانة المرء للرسول صلى الله عليه وآله وسلّم:
كان يقوم بها الذين كانوا يظهرون لرسول الله من الحق ما يرضى به منهم، ثم يخالفون في السر إلى غيره، وإنّ الله تعالى قد كفاه مكر الخائنين وغدرهم، فقال: ﴿وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[89]، وأرشده عزّ وجلّ إلى خير أسلوب للتعامل مع الخونة بعد أن شبّههم بشرّ الدواب بقوله في سورة الأنفال: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ * فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ﴾[90]، فإنه صلى الله عليه وآله وسلّم تعليماً لنا وإرشاداً وتحذيراً، كان لا يستعين مطلقاً بمن يتوسّم فيهم ملامح الخيانة , هذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلّم، وأمّا بعد انتقاله، فتتمثّل الخيانة بالذين لا يمتثلون لأمره ونهيه ولا يقتدون به وبهديه، ولا يتمسّكون بثقليه العظيمين (قرآنه وعترته)، ويُدخلون البدعة في سنّته.
3- خيانة الأمانة:
“يُستخدم مصطلح الخيانة في الأصل في موارد خيانة الأمانة. فالله عزّ وجلّ يقول في كتابه: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾[91]، لكنّه يوجد من يخون الأمانة على الرغم من هذا الأمر الإلهيّ , أي عوضاً عن أداء الأمانة إلى أصحابها فهو ينكرها أو ينقص منها أو يقصّر في حفظها وصيانتها، وهذا من مصاديق الخيانة، فأكثر الأمثلة شيوعاً للخيانة هي خيانة الأمانة، وبناء عليه يكون معنى الرواية: إذا خانك الآخرون بعدم أداء المال أو الحق الذي ائتمنته عندهم أو بتضييعه فلا تُقابلهم بنفس الأسلوب، لكن قد يتّسع مفهوم الخيانة ليشمل الخيانة لكلّ تعهّد والتزام. فقد يتعهّد شخصان أو فريقان ببعض الأمور فلا يفي أحد الطرفين بهذا التعهّد ويخون العهد. وهذا لا يُعَدّ اصطلاحاً خيانةً للأمانة، بل هو خيانة للتعهّد المبرَم مع الآخرين[92].
وهذان المفهومان (وهما: أداء الأمانة، والوفاء بالعهد) هما من أكثر القيم التي تشكّل قوام الحياة الاجتماعيّة عموميّةً. فحتّى لو لم يكن لجماعة من الناس أيّ دين تدين به أو مذهب عقائديّ خاصّ، ولم يكونوا أصحاب أيّ مدرسة أخلاقيّة، أو تابعين لأيّ حكيم أو شخصيّة عظيمة لكنّهم يريدون أن يهنئوا بحياة اجتماعيّة مريحة مع بعضهم، فإنّه يتحتّم عليهم مراعاة هذين الأمرين. فالذين وقّعوا صلح الحديبيّة مع النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّمكانوا عبَدة أوثان، لكنّ جلوسهم مع النبيّ واستعدادهم لأن يوقّعوا وثيقة صلح معه صلى الله عليه وآله وسلّم يعني أنّهم يقولون في قرارة أنفسهم: إنّنا ملتزمون بهذا العقد. يقول القرآن الكريم في هذا المجال: ﴿فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ﴾[93]، فطالما التزم الذين أبرمتم معهم عهداً بهذا العهد فلا تنكثوه أنتم. فإذا نكثوا هم العهد من جانبهم فمن حقّكم حينئذ أن تنكثوه أنتم ولا تلتزموا به, لكن ما داموا أوفياء به فأنتم أولى منهم بالوفاء به، والقيمة التي تقوم الحياة الاجتماعيّة عليها هي أداء الأمانة. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: “لو أنّ قاتل أبي الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهما السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به لأدّيته إليه[94]“.[95]
قال أمير المؤمنين عليه السلام: أقسم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً ثلاثا: “يا أبا الحسن أدِّ الأمانة إلى البر والفاجر فيما جلّ أو قلّ حتى في الخيط والمخيط“[96].
وروى مولانا الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “ليس منّا من أخلف بالأمانة“[97]، وروى مولانا الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: “لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم، وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة”[98]، وقال أبي كهمس: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام، قال: “وعليك و عليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام، وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، فالزمه، فإنّ علياً عليه السلام إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بصدق الحديث وأداء الأمانة”[99].
وديني رعْيُ العهد والود والصفا فما لي ومُختار الخيانة والغدْر
4- خيانة المرء نفسه:
فإنّ معناها العام المطلق يشمل أمرين اثنين:
أ- الخيانة الذاتية: بأن يرتكب المرء من المعاصي والأفعال ما يضرّ به نفسه في الدنيا والآخرة، والخيانة كما تجري في أفعال الجوارح تجري في أفعال القلوب أيضاً كخيانة الضمير، وتلك لا يشعر بها غير الله. وأعلم أخي المسلم أنّ كل عضو أعانك على الخيانة، فقد خان، فالعين خانت بنظر واطلاع، والأذن في إصغاء واستماع، واللسان في قولٍ واختراع، والفم بمأكل مضاع، واليد والقدم إذا نقلهما للإثم ساع.
ب- خيانة المرء أمّته: باعتبار أنها من نفس واحدة كما قرّر ذلك القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾[100]، وأن جماعة المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وتكون خيانتهم بانتقاص حقوقهم المعنوية بالامتناع عن الدفاع عنهم أو عن بذل النصيحة لهم أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر، أو بخذلانهم في ساعات الضيق والعسرة، أو التجسّس عليهم وكشف عوراتهم لأعدائهم، أو
بانتقاص حقوقهم المادية كأكل أموالهم بالباطل، أو انتهاك أعراضهم أو سفك دمائهم, وغشّهم والمكر بهم وخديعتهم، فكل ذلك خيانة لأنّ فيها انتقاصاً لحقوق المسلمين وإضراراً بهم وغدراً لهم، ومن مظاهر خيانة الأمة في زماننا هذا أن يُحمى الوطيس، وتُنصب المنجنيقات، ويتقاذف الناس بالكلمات التي هي أشد من الحجارة، وأنكى من السهام من أجل مسائل تحتمل أكثر من وجه وتقبل أكثر من تفسير، فهي من مسائل الاجتهاد، التي دلّت على سعة هذا الدين ومرونته.
من الآثار السيّئة للخيانة
عندما نتتبّع آيات الكتاب العزيز والروايات الشريفة نجد العديد من الآثار للخيانة منها:
1- الخائن منافق:
تتضح لنا المعاني وتستنير المعالم من تتبّعنا لسياق قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾، فقد تلاها مباشرة قوله عزّ وجلّ: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾، ثم تلاه مباشرة قوله سبحانه: ﴿هَاأَنتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً﴾[101]، وبمفهوم هذه الآيات الكريمة يعد خونة أنفسهم منافقين، نفاقاً عقدياً لأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ونفاقاً عملياً لأنّ تصرّفاتهم تناقض تعاليم الإسلام وإن تظاهروا بالإيمان.
2- عدم محبّة الله للخائن:
وهم بذلك محطّ غضب الله تعالى وبغضه: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾، وما أعظمه من ذنب يجلب على صاحبه بغض الله له، ومن أبغضه الله فقد لعن، ومن الإيمان أن تُحبّ من يُحبّه الله وتُبغض من يُبغضه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله والبغض في الله“[102].
3- الخيانة عنوان كل جريمة:
وعندما نتأمّل النصوص القرآنية، والبيانات النبوية يتّضح لنا أنّ الخيانة عنوان كل جريمة مهما دقّت أو جلّت، والأمين لا يخون أبداً، لا يخون مسلماً ولا كافراً ولا خائناً، ولقد حذّر سبحانه وتعالى
رسوله الكريم من أهل الخيانة تحذيراً صريحاً لا لبس فيه فقال: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا﴾[103].
وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم: “كل الخلال يطوى عليها المسلم إلا الخيانة والكذب“[104]، وروى الحسن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد الله (الإمام الصادق) عليه السلام: “يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، قال: قلت: فيكون جباناً؟ قال: نعم، قلت: فيكون كذّاباً؟ قال:لا، ولا جافياً، ثم قال: يُجبل المؤمن على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب”[105].
4- الخيانة من الكبائر:
إنّ المتتبّع بدقّة يعلم بأنّ الخيانة تفوق بخطورتها جلّ الكبائر المرتكبة لأنّها تضمّها كلّها ولها تعلّق بالنفاق والغشّ والخداع، وترك النصيحة وارتكاب الفواحش، والنميمة والكفر والشرك، وسفك الدم الحرام…الخ، والنفاق خيانة كلّه، وآية المنافق كما وردت في حديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “إذا اؤتمن خان وإذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف”[106]، وقال مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: “الخيانة رأس النفاق“، وقال عليه السلام: “ثلاث هن شين الدين الفجور والغدر والخيانة”، وقال أيضاً: “جانبوا الخيانة، فإنّها مجانبة الإسلام” وقال عليه السلام: “رأس الكفر الخيانة”[107].
5- نفي الإسلام عن الخائن:
روى مولانا الإمام علي بن موسى الرضا، عن آبائه الكرام عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع، فإنّي سمعت جبرئيل يقول: إنّ المكر والخديعة في النار.ثم قال: ليس منّا من غشّ مسلماً، وليس منّا من خان مؤمناً”[108].
لحى الله الخِيانةَ كَم تَعيبُ وَكَم تَعدو وَتُخطئُ لا تصيبُ
الدرس الرابع: لا يغضبون
نصّ الوصيّة:
روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه وصاحبه جابر قال: “وإن كُذِّبت، فلا تغضب“[109].
المحاور:
-
مقدّمة.
-
تكذيب الأولياء سنّة الظالمين.
-
بعضاً ممّا لاقاه نبّينا الخاتم.
-
من دوافع المكذِّبين.
-
عدم الغضب.
-
كيف نجتنب الغضب.
-
دور الوصية في إيجاد الصبر والثبات.
مقدّمة
من الوصايا التي يوصي بها إمامنا أبو جعفر الباقر عليه السلام صاحبه وتلميذه النجيب جابر الجعفي هي: “وإن كُذِّبت، فلا تغضب”[110].
“الوصيّتان الأولَيان ترتبطان بالمسائل العمليّة والسلوكيّة أكثر من غيرها. لكن قد تقع أحياناً بعض الأمور التي تُثير غضب الإنسان وتُمهّد الأرضيّة لارتكابه المعصية. والمثال على هذه الأمور هو عندما يقول المرء لأحد شيئاً خدمةً له، أو لأجل إصلاحه أو إرشاده لا يحدوه لذلك سوى الخير والحرص على مصالح ذلك الشخص، لكنّ ذلك الشخص يردّ طالب الخير هذا باتّهامه بالكذب قائلاً له: “إنّك تكذب، وتضمر نيّات سيّئة“!
“وأوضح مثال على هذا السلوك هو ما صنعه الكفّار مع الأنبياء، فالكلام الذي أتى به أنبياء الله تعالى عليهم السلام للبشر هو الأكثر صدقاً والأوفر فائدة والأعظم أثراً من بين كلّ ما يمكن أن يُقدّمه بشر لبشر طلباً لنجاته نجاةً أبديّة، لكنّنا نجد أنّ القرآن الكريم يُصرّح بأنّه ما من نبيّ أرسلناه إلاّ وكذّبه قومه، بل واستهزأوا به أيضاً“[111].
تكذيب الأولياء سنّة الظالمين
لقد تكرّرت مجموعة من التهم التي رُمي بها أصحاب كل الدعوات الإلهية والإصلاحية على مر الأزمان وكان من أمضاها وأبلغها (الاتهام بالكذب).
تذكر الكثير من الآيات القرآنية أنّ تكذيب الدُّعاة والمصلحين ممّا دأب عليه الطُّغاة وأعوانهم الملتفّون حولهم والرَّعيَّة الفاسدة المتّبعة لهم، فما من داعية أو مصلح إلا وقد رموه بالكذب، وكان القصد من هذا الاتهام هو تنفير العامة، ووضع الحواجز والعراقيل بينهم وبين الدُّعاة المصلحين، ومن الآيات الصريحة في ذلك ما يأتي، قال تعالى: ﴿… إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾[112]، وقال سبحانه: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي
يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[113]، ومن ذلك قول الملأ لنبي الله تعالى هود عليه السلام: ﴿قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[114].
وقالت الزمرة الفاسدة من قوم نبي الله صالح عليه السلام: ﴿أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ﴾[115]، وقالت النُّخبة المستكبرة لشعيب عليه السلام: ﴿وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[116]، ولم يكن الأمر مختلفاً مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم مع أنه كان مشهوراً لديهم من قبل بالصادق الأمين، إلا أنّ أئمة الكفر من قريش رغم علمهم بذلك وصفوه بالكذّاب، قال تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾[117]، وكما تبين فإنها سنة متبعة عند الظالمين من عهد نوح عليه السلام وإلى يوم القيامة قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ * وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾[118].
بعضاً ممّا لاقاه نبيّنا الخاتم
الكذب تهمة تذرّع بها كلّ الطُّغاة والفاسدين في مواجهة دعوة الأنبياء والمرسلين ودعاة الإصلاح وما لاقاه مولانا خاتم النبيين رسول الله محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم من الأذى أكثر من أن يُحصى وأشهر من أن يُذكر، وما أوذي نبي مثل ما أوذي نبيّنا في الله، ولذلك ساد رُسُلَ الله عليهم السلام. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾[119]، فلمّا بعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى الناس كافة ليهديهم به إلى الصراط المستقيم قابله المشركون بما يستطيعونه من الأذى والمناوأة، وتأليب الناس عليه، وتحذيرهم منه، فوصفوه بأشنع الأوصاف، فقالوا: “إنه ساحر“، وقالوا: أخرى “إنه كاهن“، وقالوا: “مجنون“.
هذا وهم أعلم الناس بماضيه المشرق الوضّاء، ولكن الذي حملهم على ذلك (الحسد والكبر)، ودوافع أخرى، وقد أخبر الله تعالى عنهم في كتابه العزيز أنّهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلمّا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً واستكباراً في الأرض ومكروا به المكر السيّئ، ولا يحيق المكر السيّئ إلا بأهله، وقال سبحانه وتعالى مخبراً عنهم: ﴿وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾[120] إلى أن قال مشيراً إلى حسدهم له صلى الله عليه وآله وسلّم: ﴿أءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا﴾[121]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾[122]، ثم قال مخبراً عن اعتراضهم على الله في اختياره لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾[123]، فأنكر عليهم ذلك، وبين أن الأمر أمره، والخلق خلقه، والفضل فضله يؤتيه من يشاء، فهو أعلم حيث يجعل رسالته، فقال تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾[124]، وقال تعالى ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾[125].
وكان كلّما اشتدّ ألم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لتكذيب قومه لله تعالى, وداخله الحزن لأذاهم له كانت آيات القرآن تتنزّل على رسول الله تباعاً تسليةً له بعد تسلية, وعزاءً بعد عزاء. قال تعالى ﴿فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾[126]، ﴿وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾[127] ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾[128], ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾[129]، ﴿وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾[130].
من دوافع المكذِّبين
الحسد والكبر، وحبّ الرياسة، والانغماس في الترف، والإسراف في التنعُّم، والفسق…الخ هذه الأوبئة وأوضح مصداق للدلالة على ذلك – الحوار الذي دار بين الأخنس بن شريق وأبو جهل- عندما قال له: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنّه ليس ههنا من قريش
غيري وغيرك يسمع كلامنا، فقال أبو جهل: “ويحك والله إنّ محمداً لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية والحجابة والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش”[131]، وقال مرة أخرى: “تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنّا كفرسي رهان قالوا منّا نبي ينزل عليه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه، والله لا نؤمن به، ولا نُصدّقه”[132]، وهكذا يبلغ الحسد والتكبّر وحبّ الرياسة بهؤلاء القوم الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمإلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، فحملهم ذلك على تكذيبه تجاهلاً للحقيقة وإبداء خلاف المستقر في القلوب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم متبعين في ذلك إمامهم في الضلال والحسد إبليس اللعين حيث فسق عن أمر ربّه له بالسجود لآدم كبراً وحسداً استناداً منه لعنه الله على أنّه أفضل منه على زعمه، لكونه خُلق من نار وآدم عليه الصلاة والسلام خُلق من طين.
الوصية بعدم الغضب
قالوا: إنّ الغضب حالة نفسية، تبعث على هياج الإنسان، وثورته قولاً أو عملاً، والمتأمّل بدقّة يعلم أنّ الغضب أوله (فكرة سيئة) تحوّلت بسرعة إلى حالة نفسية. والغضب خلق من الأخلاق المنافية للصبر، وهو مفتاح من مفاتيح الشرور، وداعية الأزمات والأخطار. لا سيما الغضب الذي يخرج الإنسان عن طوره وسمته، أو الغضب للباطل وللهوى والشهوة ــ هذا الغضب رذيلة من الرذائل الخلقية إذا تحكّم في أفكار ونفوس الناس، واستشرى في مجتمعاتهم كان له أسوأ الأثر في حياتهم، ونتائج بشعة في تمزيق روابط المودّة بينهم، فالإنسان حين يشتدّ غضبه ويزداد غيظه يفقد الرشد والصواب، ويصبح وحشاً ضارياً لا يدري ما يفعل ويظن أنه بذلك يظهر بمظهر المحترم لنفسه المحافظ على كرامته والواقع أنه يظهر بمظهر الطائش الأحمق.. إذ يتصرّف تصرّفات رعناء تُفسد عليه حياته وقد يخسر دنياه وآخرته. لذلك كله جعل الإسلام من صفات المتقين الذين يستحقّون رضوان الله عدم الاستسلام للغضب، كما قال الله تعالى في وصفهم: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[133]، وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “.. وما من جرعة أحبّ إلى الله من جرعتين جرعة غيظ يردّها مؤمن
بحلم، وجرعة جزع يردّها مؤمن بصبر..”[134].
قال الحافظ عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني: جعلت جارية لعلي بن الحسين عليهما السلام تسكب عليه الماء، فتهيّأ للصلاة فسقط الأبريق من يد الجارية على وجهه، فشجّه، فرفع رأسه إليها، فقالت الجارية إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾، فقال: قد كظمت غيظي، قالت: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾، فقال لها: عفا الله عنك، فقالت: ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين﴾ قال: “أنت حرّة لوجه الله تعالى“[135]. والغيظ هو أشدّ الغضب، والغضب عدو العقل، وهو له كالذئب للشاة قلَّ ما يتمكّن منه إلا اغتاله، والغضب يُنسي الحرمات، ويدفن الحسنات، ويخلق للبريء جنايات، وقد أحسن وأجاد الشاعر لما قال:
وَعَينُ الرِضا عَن كُلِّ عَيبٍ كَليلَةٌ وَلَكِنَّ عَينَ السُخطِ تُبدي المَساوِيا.
وكذلك قيل:
وعين البغض تبرز كل عيب وعين الحب لا تجد العيوبا.
كيف نجتنب الغضب
روى مولانا أبو عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: “أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم رجل بدوي، فقال: إني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلم، فقال: آمرك أن لا تغضب، فأعاد عليه الأعرابي المسألة ثلاث مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه، فقال: لا أسأل عن شيء بعد هذا ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلا بالخير”[136].
ومعنى اجتناب الغضب أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فلا يُقْدم على قول أو فعل يندم عليه في حال الرضى, بحيث يكون كل سلوكه محكوماً بعقله السليم في حالتي الغضب والرضى, لا بالغرائز الجامحة، وإذا كان سلوك الإنسان محكوماً بوحي من عقله السليم، فإنه يحوز الخير كله، ويبتعد عن الشر كله, لأن العقل السليم ينسجم تماماً مع الدين الإسلامي الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها.
وهكذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لذلك الرجل، ووصية حفيده الباقر عليه السلام في كلمة واحدة “لا
تغضب”, ولكن هذه الكلمة تتضمّن توجيهاً عالياً نحو السلوك الأمثل, فالإنسان في حال الغضب يتصرّف بدافع من عاطفته بعيداً عن تحكّم العقل الرشيد, فلا يؤمَن – والحال هذه – عليه أن يتفوّه بكلام سفاهة أو أن يعتدي بجوارحه على من غضب عليه, فالحلم عند الغضب ضمان لسلوك المسلم في كفّ أذاه بلسانه ويده، وإذا علمنا أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّمقد جعل كفّ الأذى رمزًا للمسلم الحقّ، وذلك في قوله الذي رواه عنه حفيده الباقر عليه السلام: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده“[137]، فإنّنا نعلم سمو المقاصد التي اشتملت عليه هذه الكلمة “لا تغضب”.
ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عظمة الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب وذلك من خلال قوله: “ليس الشديد بالصُّرَعة, إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب“[138]، فالشديد ليس هو القوي في بدنه الذي يصرع الرجال, وإن كان هذا يعدُّ في عرف الناس شديدًا, إنما الشديد حقاً هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فكم من غضبة جرحت العواطف المرهفة، وشحنت النفوس بالأضغان، وفصمت عرى الإخاء والمحبة والتآلف بين الناس، وكم من غضبة زجّت أناساً من الأبرياء في قعر السجون، وعرّضتهم للتلف، وكم من غضبة أثارت الحروب، وسفكت الدماء، فذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء.
دور الوصية في إيجاد الصبر والثبات
وكانت هذه الوصية من إمامنا الباقر عليه السلام لجابر ليحثّه على الصبر على مشاق الدعوة ومواقفها التي تتطلّب صبراً عالياً، ومقاومة شديدة، وضبطاً للنفس لا يقدر عليه إلا أهل اليقين الصامدون في خندق العقيدة، والثابتون على طريق المبدأ، ذلك أن إقامة الخلْق على العبودية لله تعالى تُكلِّفهم أن يخرجوا على هوى أنفسهم، وينعتقوا من أسر عاداتهم، وما ورثوه عن آبائهم، وما ألفوه في حياتهم من الطقوس والتقاليد الجاهلية، وهذا ما يشقّ على النفوس، ويستحيل على كثير من الناس أن يستجيبوا له.
“إذن فمن المناسب هنا أن يبادر مَن هم مِن أمثال الإمام الباقر عليه السلام لنصيحة جابر (وعبره إلى كل مؤمن تبلغه هذه الوصية): “إِنْ كُذِّبْتَ فَلا تَغْضَبْ”، فعندما لا يكون ثمّة قصد غير طلب الخير للآخرين وإنّ الطرف الآخر لا يُقدِّر ذلك حقّ قدره فيتعيّن على الذين ينتهجون نهج الأنبياء أن يستعدّوا للسيطرة على أنفسهم ومشاعرهم عندما يواجَهون بتكذيب المعارضين وأن لا يغضبوا.
فإذا لم يُعِدّ المرء نفسه مسبقاً لمواجهة مثل هذه السلوكيّات فسوف لن يتمالك نفسه ويخرج عن حالته السويّة، لكنّه إذا لقّن نفسه قبل الولوج في هذا الميدان فسوف لن يشقّ عليه كثيراً تكذيب المكذّبين ومعارضة المعارضين. فإذا أحبّ المرء نصيحة الآخرين طلباً لخيرهم فليحدّث نفسه قائلاً: إذا كُذِّبتُ فعليّ أن لا أعبأ بكلامهم. فإنّ على عاتقي مهمّة وقد أدّيته, وإنّ على الطرف المقابل تكليفاً وهو مخيّر بين أن يعمل أو لا يعمل به، فهو الذي يتحمّل في النهاية مسؤوليّة فعله، ولا أتحمّل أنا أيّ مسؤوليّة، وعندها لن يغضب في مقابل إساءة الآخرين له. وهذه هي الوصيّة الثالثة التي وجّهها الإمام عليه السلام إلى جابر، وفّقنا الله وإيّاكم للعمل بها إن شاء الله”[139].
جعلنا الله وإياكم من المهتدين بهدى النبي الأعظم والأئمة الأطهار عليه السلام ومن المقتفين آثارهم السالكين منهاجهم الآخذين بحجزتهم والماكثين في ظلّهم، فإنهم كانوا:[140]
لا يَغضَبونَ لِغَيرِ اللَهِ إِن غَضِبوا وَلا يُضيّعونَ حُكمَ اللهِ إِن حَكَموا
الرُكنُ وَالبَيتُ وَالأَستارُ مَنزِلُهُم وَزَمزَمٌ وَالصَفا وَالحِجرُ وَالحَرَمُ
صَلّى الإِلَهُ عَلَيهِم أَينَما ذُكِروا أَنَّهُم لِلوَرى كَهفٌ وَمُعتَصَمُ
الدرس الخامس: بالمدح لا يفرحون
نصّ الوصيّة:
روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه وصاحبه جابر قال: “وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَفْرَحْ“[141].
المحاور:
-
مقدّمة.
-
لو مدحوك ما رفعوك.
-
الممدوح الذي زكّاه ربّه سبحانه وتعالى.
-
النعمة الإلهيّة في ستر العيوب.
-
نقد للأخلاق البشريّة.
-
كي لا تُصيبنا النشوة من إطراء الآخرين.
-
فخّ الرياء.
مقدّمة
الفقرة الرابعة من وصية: إمامنا الباقر عليه السلام: لتلميذه وصاحبه جابر “وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَفْرَحْ“[142]. “يُحبّ الإنسان بطبيعته أن يكون حسن السمعة وأن يذكره الناس بالمزايا والصفات الإنسانيّة المثلى، ويكره – في المقابل – أن يذمّه الآخرون وينتقصوا من شأنه في غيابه، فهل ينبغي للإنسان أن يفرح من مديح الآخرين ويستاء من ذمّهم له؟ وهل يتعيّن عليه يا تُرى أن يأتي بما يوجب ثناء الناس عليه من الأفعال وينتهي عمّا يدفعهم لذمّه وملامته؟ أم إنّ عليه أن يُخفي محاسنه عن الناس ويُظهر عيوبه لهم؟”[143].
قال الله العظيم في كتابه الكريم: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾[144]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾[145]، وقال سبحانه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾[146]، فمن تدبّر هذه الآيات المباركة كان على علم أنه ينبغي للإنسان العاقل أن يزهد في مدح الناس وثنائهم، فسواء مدحه الناس أو ذمّوه، الأمر عنده سيّان، ما دام يعمل لإرضاء الله، وأمّا الروايات الشريفة من السنة النبوية وأحاديث أئمة الهدى عليهم السلام فهي تُحذّر المرء من التظاهر أمام الناس، وكشف حسناته لهم كي لا يوجب ذلك الرياء، وهي تحضّه أيضاً على عدم فسح المجال لهم ليمدحوه, وحثّته على اجتناب الرضا عند المدح والغضب عند الذم.
ولم يرض مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بالثناء عليه مع كمال تقدّسه، فقال حين مدحه قوم في وجهه: “اللهم إنّك أعلم بي من نفسي وإنّي أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلنا خيراً ممّا يظنّون واغفر لنا ما لا يعلمون”[147].
لو مدحوك ما رفعوك
قال الشيخ المفيد رضوان الله عليه: وقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾[148] [149] نزلت في واحد بعينه نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، فقال: “يا محمد إن مدحي زين، وإن شتمي شين”[150]، فإذا عرفت أيها المسلم: بأن الناس لو مدحوك ما رفعوك، ولو ذمّوك ما خفضوك, فلا تكترث عند ذلك لمدحهم ولا ذمّهم، وكن على يقين أنّ الناس قد يمدحونك اليوم ويذمونك غداً، وكم من عبد تقي نقي أخوف ما عنده أن يشعر الناس به, لأنه يعلم أنه لا أمن له إلا عند الله، ولا عزّ ولا كرامة له إلا من الله. واعلم أنّ الموفَّق لا يتأثّر بثناء الناس وإذا سمع ثناءً لم يزده ذلك إلا تواضعًا وخشية من الله، وأيقِن أن مدح الناس لك فتنة، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: “كم من مغرور بحسن القول فيه كم من مفتون بالثناء عليه“[151]، فادع ربّك أن يُنجيك من تلك الفتنة واستشعر عظمة الله، وضعف الخلق وعجزهم وفقرهم، واستصحب دومًا أنّ الناس لا يملكون جنة ولا نارًا، والنفوس تصلح بتذكّر مصيرها، ومن أيقن أنه يوسَّد في اللحد فريدًا أدرك أنه لن ينفعه سوى إخلاصه لربّه, ومن طمع في الخلق لم يخل عن الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة والمهانة، فكيف يترك العاقل ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد قد يُصيب وقد يُخطئ وإذا أصاب فلا تفي لذّته بألم منّته ومذلّته، فماذا نريد ممّا عند الناس؟ قال تعالى حاكياً قول قلوب الذين أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا﴾[152]، وقال مادحاً لهم: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾[153]، فكونوا من المهتدين بهداهم والمقتفين آثارهم، والسالكين منهاجهم، والآخذين بحجزتهم، والماكثين بظلّهم، يعود خير ذلك عليكم.
الممدوح الذي زكّاه ربّه سبحانه وتعالى
مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والثناء عليه بما هو أهله، إنما هو لإبراز ظواهر القدوة والأسوة والعصمة لشخصه الشريف، فقد مدحه وزكّاه ربّه عزّ وجلّ في القرآن، وأثنى عليه, فمدحه بحسن الخلق ومدحه بشفقته على أمته، ورأفته بها وحرصه على هدايتها، والله تعالى زكَّى عقله صلى الله عليه وآله وسلّم، فقال: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾[154]، وزكَّى لسانه فقال: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
يُوحَى﴾[155]، وزكَّى بصره فقال: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾[156]، وزكّى فؤاده فقال: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾[157]، وزكَّى قلبه فقال: ﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ﴾[158] وزكّى أذنه فقال: ﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ﴾[159]، وزكَّى صفته فقال: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾[160]، وزكّى وجوده فقال: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾[161]، وزكَّى فعاله فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾[162]، وزكّى رسالته فقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾[163]، وزكّى دينه فقال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾[164]، وزكَّى جليسه فقال: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾[165] وزكّى أهل بيته الطيبين، فقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾[166]، وزكَّاه كُله فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[167]، فالذين عصمهم الله لا نهي عن مدحهم إذا جنبوا قول الغلاة:
جنّبوهم قول الغلاة وقولوا ما استطعتم في فضلهم أن تقولوا
فإذا عدت سماء مع الأرض إلـى فـضـلـهـم، فـذاك قـلـيـلُ
وقال بعض العلماء أن من يعرف بكمال تقواه، ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في مدحه إذا لم يكن فيه مجازفة، وإن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير، والازدياد منه، أو الدوام عليه، وأن النهي محمول على المجازفة في المدح، والزيادة في الأوصاف، ومخافة الفتنة على من يعجب ويصاب بالنشوة إذا سمع المدح والثناء، “فالمدح بذاته ليس عيباً، خصوصاً إذا كان من أجل التعريف بالحقّ والإعانة على طريق الصواب. فلا يكون مدح امرئ مذموماً إلاّ إذا اتّخذ طابع التملّق والإطراء الزائف”[168].
النعمة الإلهيّة في ستر العيوب
“إنّ من النعم الإلهيّة الكبرى التي مَنّ الله بها علينا هي ستره لعيوبن, فلو انكشفت عيوب الناس واطّلع كلٌّ على نقائص الآخرين وسيّئاتهم وقبائحهم لما بادل أحد أحداً المحبّة, فقد جاء في الخبر: “لو تكاشفتم ما تدافنتم” أي لو كُشف عن أعمالكم لما أقدم أحد على دفن جنائزكم. إذن فمن نِعَمِ الله جلّ شأنه علينا هي ستره على عيوبنا، بل وحتّى إنّه سبحانه لا يجيز لنا من الناحية الشرعيّة أن نبوح بسيّئاتنا للآخرين”[169]. فالأصل هو في ستر العيوب وهي نعمة إلهيّة منّ بها الله عزّ وجلّ على عباده ليتمكّنوا من الإفادة من النعم والبركات الاجتماعيّة على نحو أفضل، وجميعنا تقريباً يحظى بهذه النعمة وعلينا أن نشكر الباري تعالى عليها.”
فعندما يكون للمرء وجاهة وسمعة طيّبة في المجتمع يحترمه الناس ويحسنون به الظنّ الأمر الذي يتيح له فرصة الانتفاع من معونة الآخرين ضمن إطار الحياة الاجتماعيّة المشتركة. وهذه نعمة إلهيّة عظيمة وهي تتطلّب منّا شكراً أيضاً، لكنّ المشكلة تكمن في أنّ هذه المسألة تتّخذ طابع الإفراط أحياناً فتكون مطلوبة بذاتها بالنسبة للإنسان، وهو عندما لا يكون المرء إنساناً صالحاً لكنّه يحبّ أن يعرفه الناس بالصلاح وينسبون إليه ما لم يأت به من الصالحات. فهذه حالة تتّسم بالإفراط وهي صفة ذميمة ترجع إلى حبّ الذات وحبّ السمعة، وهذا هو ما أشار إليه الإمام عليه السلام في هذه الرواية. فالقرآن الكريم يقول في ذمّ الكافرين وضعيفي الإيمان من الناس: ﴿وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ﴾[170].
الذم والمدح في الأخلاق الإلهية
من الواضح في المدارس الإلهيّة والرؤى التوحيديّة أنّه من المذموم أن يشعر الإنسان بالاستقلاليّة في مقابل الله سبحانه وتعالى، وإنّ كلّ طريق يقود الإنسان إلى هذه النهاية يُعدّ خطيراً. من هنا فإنّ جميع الحسنات والكمالات في المدارس الإلهيّة تُنسب إلى الله عزّ وجلّ، وإنّ ملاك حسنات المرء يعود إلى عبوديّته لله الواحد. لهذا فإنّ الشخص المؤمن الموحّد لا يعتقد لنفسه بالأصالة في مقابل الباري تعالى أبد, فشعاره دائماً: “على الناس أن يعبدوا الله وحده ويحبّوه”. وإنّه إنْ طلب حبّ الناس له فسيكون ذلك في ضوء حبّهم لله, بمعنى أنّه يعلم أنّ علّة حبّ الناس له هي أنّهم يشاهدون بعضاً من نور صفات الله الحميدة فيه، أمّا غير المؤمن فإنّ نفسه وذاته هي المناط دائماً. فهو
يريد أن يحبّه الناس هو, من دون أن يكون حبّهم لله أو عدم حبّهم له مهمّاً بالنسبة له. وإنّ المؤمن – انطلاقاً من نظرة الأخلاق التوحيديّة – يحبّ أن يكون محبوباً لدى الآخرين كي يشكّل ذلك وسيلة لتقرّبهم إلى الله, لأنّ فطرة الإنسان تحبّ كلّ خير وحسن. وهذه النظرة تُعدّ في الواقع فضيلة.
عندما قدم الإمام الخميني قدس سره إلى مدينة قمّ المقدّسة وأثناء حضوره في أحد المجالس بالغ الحاضرون في المجلس في إظهار عواطف المودّة ومشاعر المحبّة لشخصه بل إنّ بعضهم كان يبكي شوقاً ولهفة إليه. وحينما وصل إليه الدور في الكلام وبعد أن استهلّ كلامه ببسم الله الرحمن الرحيم قال: “أحمد الله تعالى على أن أفهَمَني أنّ محبّة الناس هذه ليست هي لشخصي, بل هي أمارة على ما يكنّونه من حبّ للدين“. أجل فهناك من يفرح لحبّ الناس له لأنّ حبّاً كهذا يكون سبباً في إشاعة دين الله في الأرض. فإن لم يصل فهم أحد إلى إدراك أمثال مَن يحمل مثل هذه الصفات فلا ينبغي له القول: “هذا كذب، فالإسلام يريد أن يربّي أناساً يتساوى عندهم مدح الناس لهم وعدم مدحهم”.
كي لا تصيبنا النشوة من إطراء الآخرين
“إذا شئنا أن نعرف كيف نحارب آفة حبّ الذات في أنفسنا كي لا نفرح كثيراً من مديح الآخرين، فعلينا أن نفهم أنّ ما يبديه الناس من مديح وثناء ينقسم إلى عدّة أقسام:
1- المديح الذي لا يمتّ للشخص الممدوح بأيّ صلة: وإنّ فرحه به هو لون من ألوان الفرح الزائف, كأن يقال: “فلان من أهل المدينة الفلانيّة التي أنجبت الكثير من العلماء“! أو أن يقال: “كان جدّه من كبار علماء عصره”. فأيّ صلة لمثل هذا الإطراء بهذا الشخص؟! وأي مديح يكون له بهذا الكلام؟! فمحاربة هذا النمط من الوساوس ليس بالأمر المعضل جدّاً، وسيفهم الإنسان بقليل من التأمّل والتفكّر أنّه لا علاقة له بهذه الألوان من الإطراء.
2- مدح المرء بسبب ما وهبه الله من مواهب وصفات: كأن يُثنى على امرئ لما أوتي من نعم وكمالات وما وُهب من الإمكانيّات, كأن يكون قد جدّ في طلب العلم، وعبد الله، وقدّم الخدمات للعباد، أو كان سبباً في نجاة أمّة من الضلالة، أو امتلك صفات أخلاقيّة حسنة دفعته لإنجاز صالح الأعمال، كما لو اتّصف بالسخاء أو الصفح والتجاوز… وللمرء أن يفرح قليلاً بهذا المديح، لكن عليه التفكير أوّلاً بقضيّة أنّه ليس هو الذي حصل بنفسه على هذه النعم، بل إنّ الله جلّ وعلا هو المتفضّل بها عليه وإنّ عليه في مقابلها تكليف الإفادة منها على أحسن وجه.
ثمّ إنّ عليه ثانياً أن يلتفت إلى هذه النقطة وهي: هل إنّ كلّ مَن مُنح هذه الإمكانيّات والنعم فهو عزيز عند الله؟! فلربّما كان هناك من هم أقلّ منه إمكانيّة بكثير وقد ظفروا بحسن العاقبة، ولربّما وُجد مَن يفوقه بالإمكانيّات فأصبح سبباً في ضلالة جماعة من الناس. فهذه الفضائل لا تُشكّل سبباً وجيهاً لتفاخر المرء بنفسه.
فالمرء يُدرك أنّ تلك الكمالات ليست من نفسه، ومع ذلك تجده يفرح كثيراً من إطراء الآخرين، ممّا يفسح المجال لوسوسة الشيطان له.
وهنا ينبغي للمرء من أجل الخلاص من شرّ وساوس الشيطان أن يتنبّه إلى أربعة أمور, فعليه:
أوّلاً: أن يعلم أنّ القسم الأعظم ممّا قام به من أعمال حسنة إنّما هو ببركة توفيق الله له وأنّه تعالى هو الذي هيّأ له المقدّمات لذلك. فلو فكّر المرء مليّاً في ذلك لوجد أنّ دور إرادته في كلّ ما يقوم به قد يكون أقلّ من واحد بالمائة، فكم من الوسائل والأسباب قد وفّرها الباري عزّ وجلّ من أجل أن تكون للمرء هذه الإرادة!
ثانياً: عليه الالتفات إلى قضيّة مهمّة وهي أنّه من غير المعلوم أنّ هذه النعمة التي استمرّ الله تعالى في إعطائه إيّاها إلى هذه اللحظة ستستمرّ بعد ساعة من الآن، فمن يدري أنّ العلم الذي يمتلكه الإنسان سيبقى إلى ما بعد ساعة. فالقرآن الكريم يقول: ﴿وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾[171], فقد يمتدّ عمر الإنسان إلى أتعس مراحله من الشيخوخة حتّى أنّه لا يعود يعلم شيئاً بعد ما كان عالماً ومطّلعاً. فالذين يبتلون بمرض الآلزايمر في الكبر قد لا يعرفون حتّى أبناءهم. فإن كانت لدينا نعمة فهي باقية بإرداة الله عزّ وجلّ وهو إن لم يُرِد لم نبق متمتّعين بها.
ثالثاً: أنّ على الإنسان أن يقلق من مآله وعاقبته. إنّهم لكثيرون أولئك الذين عاشوا عمراً طويلاً وهم يتمتّعون بطيب السمعة بين الناس وقدّموا خدمات جليلة لكنّ عاقبتهم كانت الكفر! ومن هنا فليس للإنسان أن يفخر بأيّ كمال أو يطمئنّ به. أمّا النقطة الرابعة التي ينبغي الالتفات إليها فهي أنّ الفرح من تملّق الآخرين وكلامهم المعسول قد يوقع الإنسان في فخّ الرياء ويشكّل مقدّمة لسقوطه. ومن هنا يقول الإمام الباقر عليه السلام لجابر: “إذا تعرّضت للمديح والإطراء فلا تفرح ولا تشعر بالنشوة كثيراً”![172].
الحذر من فخّ الرياء
إنّ الله حذّرنا من الرياء في الأقوال والأفعال، وذلك في كثير من آيات القرآن الكريم، وبيّن لنا سبحانه أن الرياء يُحبط الأعمال الصالحة، فقال تعالى: ﴿لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾[173]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾[174]، فالرياء من صفات المنافقين الذين أخبرنا الله عنهم أنّهم في الدرك الأسفل من النار، وكفى بهذا واعظاً للمسلم العاقل قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: “ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويُحبّ أن يُحمد في جميع أموره”[175]. فقد يعمل الإنسان عملاً خالصاً لوجه الله تعالى، وقد ينال بهذا العمل علو الرتبة عند الله تعالى، وقد يلحقه بجوار النبيين والصديقين، ونفس هذا العمل إذا كان الإنسان مرائياً فيه، فإنّ عاقبته البعد عن ذلك الجوار العزيز والرد إلى زمرة العاصين بسبب الرياء. ولهذا فالمؤمن دائم الحرص على البعد عن كل سبب يؤدّي للوقوع في الرياء، ويدفعه بكل ما أوتي من علم عندما يخطر بقلبه، وتراه حريصاً على إخفاء العبادات المستحبة، ومسارعاً بالبعد عن مجالسة المدّاحين وأهل الرياء، وعالماً أنّ من أسباب الرياء الشعور باللذّة والتنعّم عندما يمدحه الناس، فمن كمال تواضعه للرب عزّ وجلّ وإظهار العبودية له لا يقبل المدح والثناء من المدّاحين من المنافقين والمداهنين، وفّقنا الله وإياكم لمراضيه والبعد عن معاصيه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الدرس السادس: لا يجزعون
نصّ الوصيّة:
روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر قال: “وإن ذُممت، فلا تجزع”[176].
المحاور:
-
مقدّمة.
-
الذم لغة.
-
الجزع لغة.
-
العاقل لا يجزع.
-
المخلص الحقيقي.
-
أهمّية الوقوف على عيوب النفس.
-
ترك الجزع من الحقّ.
-
الثواب المجّاني.
مقدّمة
أرسل الله عزّ وجلّ أنبياءه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام لاستنقاذ البشر من براثن الشرك والشيطان ولنصيحة أقوامهم لما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فقال الله تعالى في كتابه الكريم حاكياً عن نبيه نوح عليه السلام: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾[177]، فتبيّن أنّه يجب على الناصح أن يكون عالماً بما ينصح به، وقال الله تعالى حاكياً قول نبيّه هود عليه السلام: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾[178]، ونقل الله تعالى ما قاله نبيه صالح عليه السلام لقومه: ﴿يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾[179].
والنصيحة هي: الإخلاص وتخليص الشيء من الشوائب مع إصلاح العمل، والنصيحة في الشرع كلمة جامعة تتضمّن قيام الناصح للمنصوح له ببيان وجوه الخير إرادة وعملاً، والناصح محسن كما قال الله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[180]، إذاً فالناصح المشفق محسن والمحسنون أجرهم عند الله عظيم، وكان دأب أنبياء الله ورسله عليهم السلام تقديم النصح والإرشاد إلى الخير، وكذلك دأب أوصيائهم الكرام والخُلّص من أتباعهم عليهم السلام، ولكنّهم لم يلاقوا من أعدائهم إلا التهمة والأذية بعد الكفر بما أنزل الله تعالى، وكذلك لم ينالهم من المنافقين والفسقة والمستهترين إلا الذم والتنقص، والسخط والملامة، فلا تجزع أيها الناصح إن وجدت أقواماً ذمّوك لنصحك لهم، أو لا يحبون قولك من النصيحة، فقد ذمّوا رسل الله تعالى وأوصياءهم من قبلك.
الذم لغة
قال أحمد بن فارس في مقاييس اللغة: “الذم: الذال والميم في المضاعف أصلٌ واحد يدلُّ على
خلافِ الحمد. يقال ذَمَمْتُ فلاناً أذُمُّه، فهو ذميمٌ ومذموم، إذا كان غير حميد“[181].
وقال ابن منظور في لسان العرب: “الذم: نقيض المدح وذَمَّ يَذُمُّ ذَمّاً وهو اللوم في الإساءة، والذَّمُّ والمَذموم واحد، والمَذَمَّة: الملامة”[182]. وذم الشخص: عابه، وهجاه، ولامه، وانتقصه.
الجزع لغة
قال الرَّاغب الأصفهاني: “الجزع أبلغ من الحزن، فإنّ الحزن عام، والجَزَع هو: حُزْن يَصْرِف الإنسان عمَّا هو بصدده، ويَقْطَعه عنه”[183].
والجزع نقيض الصبر، والجزوع ضدّ الصبور، ويقال: جزع فلان يجزع جزعاً وجزوعا إذا ضعف عن حمل ما نزل به، ولم يجد صبراً، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ…﴾[184].
العاقل لا يجزع
تحدّثنا في الدروس السابقة حول بعض دلالات وصيّة الإمام الباقر عليه السلام يقول فيها لجابر: “يَا جَابِرُ… أُوصِيكَ بِخَمْسٍ: إِنْ ظُلِمْتَ فَلا تَظْلِمْ، وَإِنْ خَانُوكَ فَلا تَخُنْ، وَإِنْ كُذِّبْتَ فَلا تَغْضَبْ، وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَفْرَحْ”، وقد قدّمنا بحدود ما وفّقنا الله توضيحاً للوصاية الأربع الأولى.”أمّا وصيّة الإمام عليه السلام الخامسة فهي: “وَإِنْ ذُمِمْتَ فَلا تَجْزَعْ”، فقد وضّح الإمام عليه السلام الجملة الأخيرة فقال: “وَإِنْ ذُمِمْتَ فَلا تَجْزَعْ، وَفَكِّرْ فِيمَا قِيلَ فِيكَ, فَإِنْ عَرَفْتَ مِنْ نَفْسِكَ مَا قِيلَ فِيكَ فَسُقُوطُكَ مِنْ عَيْنِ اللهِ عزّ وجلّ عِنْدَ غَضَبِكَ مِنَ الْحَقِّ أَعْظَمُ عَلَيْكَ مُصِيبَةً مِمَّا خِفْتَ مِنْ سُقُوطِكَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى خِلافِ مَا قِيلَ فِيكَ فَثَوَابٌ اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْعَبَ بَدَنُكَ” أي: “إذا واجهك أحد بسوء الكلام فلا تجزع! وفكّر فيما إذا كان ما قيل فيك حقّاً أم باطلاً؟ فإن كان حقّاً فلا تنزعج, لأنّك إذا انزعجت، فإنّما تنزعج من أمر هو حقّ، وهذا يُسقطك من عين الله، فإنّه لا قيمة عند الله تعالى لمن يستاء وينزعج من الحقّ، وأمّا إذا كان ما قيل فيك باطلاً، فاعلم أنّ ثواباً سيُكتب لك في صحيفة أعمالك إزاء هذا الذمّ بلا جهد ولا تعب، وهذا أيضاً ليس ممّا
يدعو إلى الانزعاج”[185].
قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: “أيّها الناس اعلموا أنّه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه”[186]. فالعاقل من يضع الأشياء في مواضعها ويعلم عاقبة الأمور ومبادءها ومنافعها ومضارها، فلا محالة يتحمّل الصبر على النوائب والسكون في المصائب ولا يضطرب من قول الزور والكذب فيه، ولا يجزع من الافتراء عليه وإن كان ذلك بلية عظيمة لعلمه بنور عقله بأن أمثال ذلك من المصائب بعد وقوعها لا ينفعه إلا الصبر والسكون واللجأ إلى الله تعالى، وأن للحزن والجزع والاضطراب مصائب أخرى مهلكة، فيصبر ويسكن ويفوّض أمره وأمر خصمه الفاسق الكاذب إليه سبحانه ليكتسب بذلك أجر الصابرين، ويحفظ نفسه عن الهلاك، فمن انزعج واضطرب وتحرّك نحو الانتقام علم أنّه ليس بعاقل لجهله مضرّة ذلك ومنافع الصبر[187].
المخلص الحقيقي
“نلاحظ أنّ الإمام عليه السلام لم يضف على النصائح الأربع السابقة شيئاً لكنّه لم يكتف في الخامسة بقوله: “وَإِنْ ذُمِمْتَ فَلا تَجْزَعْ” بل أردفها بالتوضيح. فما فرق هذه الجملة عن سابقاتها؟ ولماذا اكتفى في الجمل الأربع السابقة بذكر النصيحة من دون توضيح؟
وفقاً للظاهر وفيما يتّصل بالمديح فإنّ المرء لا يتوقّع أن يمتدحه الجميع، بل ولا يرى لنفسه مثل هذا الحقّ. أمّا بخصوص الذمّ، فهو لا ينتظر أن يذمّه أو يقرّعه أحد. فالمدح بذاته ليس عيباً، خصوصاً إذا كان من أجل التعريف بالحقّ والإعانة على طريق الصواب. فلا يكون مدح امرئ مذموماً إلاّ إذا اتّخذ طابع التملّق والإطراء الزائف. أمّا فيما يتعلّق بالذمّ فالإنسان يرى أنّ من حقّه أن لا يذمّه الآخرون، وهو بشكل طبيعيّ يستاء عند التعرّض للملامة.
ومن هنا، فإنّ إهانة الآخرين، والاستهزاء بهم، ونسبة العيوب اليهم، وغيبتهم، ورميهم بمختلف التهم حرام، فانزعاج الإنسان من هذا الأمر يرجع إلى شعوره بأنّ حقّاً قد سُلب منه , كما هو الحال فيما يتعلّق بسائر الحقوق، فعندما يُغتصب من المرء حقّ فإنّه – بشكل طبيعي – يستاء، وكذا إذا أسيء إليه بقول لا سيّما إذا كان ذلك بحضور الآخرين. وبناءً على ذلك تحتاج النصيحة الخامسة
إلى مزيد من التأكيد على أنّه: حذار في مثل هذه المواطن من أن تغضب وتثور! ومن هذا المنطلق فقد وضّح عليه السلام لجابر، في هذا المورد كيفيّة كبح سَورة الغضب بقوله: “إذا ذمّك أحد، ففكّر بالأمر، وقُل لنفسك: هل إنّ ما يقوله صحيح؟ وهل أنا هكذا حقّا”؟[188].
المعروف والمشهور من سير أنبياء الله ورسله الكرام وأوصيائهم عليهم السلام توجيهاتهم الدائمة للإنسان أن يُحاسب نفسه كل يوم وليلة، كما مر في الأخبار، فعند المساء ينظر ويتفكّر فيما عمل به في اليوم وساعاته وما قصّر فيه من طاعاته، وما أتى به من سيئاته، فيستغفر الله، ويحمده استدراكاً لما فات منه من الحسنات واستمحاء لما أثبت في دفاتر أعماله من السيئات، وفي الصبح يتفكّر لما جرى في ليله من الغفلات وفات منه من الطاعات، فيتلافى ذلك بالذكر والدعاء والاستغفار، ويتوب إلى ربّه العالم بالخفايا والأسرار، فقد روي عن مولانا الإمام الحسن بن علي المجتبى عن جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “لا يكون العبد مؤمناً حتى يُحاسب نفسه أشدّ من محاسبة الشريك شريكه، والسيد عبده“[189] وقال مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام: “ليس منّا من لم يُحاسب نفسه كل يوم“[190].
فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه وتجنّب ما يرديه، فيدخل مدخل الكرامة، فأصاب سبيل السلامة يبصر ببصره، وأطاع هادي أمره. ويمكننا القول إنّ زبدة المخاض في شرح وبيان وصية مولانا الإمام الباقر محمد بن علي عليهما السلام: “وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَفْرَحْ، وَإِنْ ذُمِمْتَ فَلا تَجْزَعْ” قد جاءت على لسان ولده الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال في فصل خطابه وجليل جوابه: “لا يصير العبد عبداً خالصاً لله عزّ وجلّ حتى يصير المدح والذم عنده سواء، لإن الممدوح عند الله عزّ وجلّ لا يصير مذموماً بذمّهم، وكذلك المذموم، فلا تفرح بمدح أحد، فإنّه لا يزيد في منزلتك عند الله، ولا يُغنيك عن المحكوم لك، والمقدور عليك، ولا تحزن أيضاً بذمّ أحد فإنّه لا ينقص عنك به ذرة، ولا يحطّ عن درجة خيرك شيئاً، واكتف بشهادة الله تعالى لك، وعليك، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا﴾[191]، ومن لا يقدر على صرف الذمّ عن نفسه، ولا يستطيع على تحقيق المدح له، كيف يُرجى مدحه أو يُخشى ذمّه، واجعل وجه مدحك وذمّك واحداً، وقف في مقام تغتنم به مدح الله عزّ وجلّ لك ورضاه، فإنّ الخلق خُلقوا من العجين من ماء مهين، فليس لهم إلا ما سعوا
قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾[192]، وقال عزّ وجلّ: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾[193].[194]
أهمّية الوقوف على عيوب النفس
“يتّصف الإنسان – بشكل طبيعيّ – بحبّ الذات ولا يرغب في أن يرى في نفسه نقصاً، أو عيباً، أو ذنباً. وحتّى عندما يرتكب المعصية في العلن، فهو يختلق لنفسه المبرّرات ويحاول إقناعها بأنّه يمتلك الحقّ في هذا التصرّف، أو عندما يكون غير مطّلع على أمر وقد سُئل عنه فهو يحاول الإجابة بشكل لا يَشعر معه المقابلُ بجهله، كي لا يقول صراحة: لا أعلم!
“وهذا السلوك يدلّ على أنّ الإنسان بطبيعته شديد الحبّ لنفسه، ولا يودّ أن يقف على عيوبه. ولذا فعندما يعيبه أحدٌ مّا فإنّ أوّل ما يتبادر إلى ذهنه هو أنّ هذا الشخص يكذب وأنّني بريء من هذا العيب. فكثيراً ما توجد في المرء عيوب تكون غائبة عن باله, لأنّ من جملة حيل النفس – التي تُعدّ موجوداً عجيباً إلى أبعد الحدود – هي سترها لعيوب الإنسان ونقائصه حتّى عن نفسه، فهي أحياناً تجعل الأمر مشتبهاً على الإنسان نفسه فتُظهر نفسه له بشكل لا يُصدّق معه أنّه إنسان سيّئ.
ومن هنا يقول أبو جعفر الباقر عليه السلام: “فَكِّرْ فِيمَا قِيلَ فِيكَ“، أي: إنّ وجود هذا العيب فيك أو عدمه مبهم بعض الشيء حتّى بالنسبة لك، وقد لا تُصدّق بوجوده من دون تفكير وتأمّل، فإنّ الكثير من الرذائل كالحسد، والتكبّر، والأنانية موجودة، وإن كانت بمراتب ضعيفة، عند كثير من الناس لكنّهم غير مصدّقين بذلك”[195].
إن ضرورة التفكّر للوقوف على عيوب النفس، يحتّم علينا ويوجّهنا للسير برحلة البحث في كتاب الله تعالى ويوصلنا إلى قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾[196]، قال الراغب الأصفهاني: “أصل الزكاة النمو الحاصل من بركة الله تعالى – إلى أن قال -: وتزكية الإنسان نفسه ضربان: أحدهما: بالفعل وهو محمود، وإليه قصد بقوله: قد أفلح من تزكى، والثاني بالقول كتزكيته لعدل غيره، وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه، وقد نهى الله تعالى عنه فقال: لا تزكوا أنفسكم، نهيه عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلاً وشرعاً،
ولهذا قيل لحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقّاً؟ فقال: مدح الرجل نفسه”[197].
وفي هذا الموضع يطيب لنا أن ننقل كلاماً نفيساً لصاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه حيث يقول: “قوله تعالى: ﴿بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ إضراب عن تزكيتهم لأنفسهم، وردّ لهم فيما زكوه، وبيان أنّ ذلك من شؤون الربوبية يختص به تعالى، فإن الإنسان وإن أمكن أن يتصف بفضائل، ويتلبّس بأنواع الشرف والسؤدد المعنوي غير أن اعتناءه بذلك واعتماده عليه لا يتم إلا بإعطائه لنفسه استغناء واستقلالاً، وهو في معنى دعوى الألوهية والشركة مع رب العالمين، وأين الإنسان الفقير الذي لا يملك لنفسه ضرّاً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة والاستغناء عن الله سبحانه في خير أو فضيلة؟ والإنسان في نفسه وفي جميع شؤون نفسه، والخير الذي يزعم أنه يملكه، وجميع أسباب ذلك الخير، مملوك لله سبحانه محضاً من غير استثناء، فماذا يبقى للإنسان؟ وهذا الغرور والإعجاب الذي يبعث الإنسان إلى تزكية نفسه هو العجب الذي هو من أمهات الرذائل، ثم لا يلبث هذا الإنسان المغرور المعتمد على نفسه دون أن يمس غيره، فيتولّد من رذيلته هذه رذيلة أخرى، وهي رذيلة التكبّر، ويتمّ تكبّره في صورة الاستعلاء على غيره من عباد الله، فيستعبد به عباد الله سبحانه، ويجري به كل ظلم وبغي بغير حق وهتك محارم الله وبسط السلطة على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، وهذا كله إذا كان الوصف وصفاً فردياً، وأما إذا تعدّى الفرد وصار خلقاً اجتماعياً وسيرة قومية، فهو الخطر الذي فيه هلاك النوع وفساد الأرض، وهو الذي يحكيه تعالى عن اليهود إذ قالوا: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾[198].
فما كان لبشر أن يذكر لنفسه من الفضيلة ما يمدحها به سواء كان صادقاً فيما يقول أو كاذباً لأنّه لا يملك ذلك لنفسه لكن الله سبحانه لمّا كان هو المالك لما ملّكه، والمعطي الفضل لمن يشاء وكيف يشاء كان له أن يزكّي من شاء تزكية عملية بإعطاء الفضل وإفاضة النعمة، وأن يُزكّي من يشاء تزكية قولية يذكره بما يمتدح به، ويشرفه بصفات الكمال كقوله في آدم ونوح…”[199].
ترك الجزع من الحق
بعض النماذج من البشر إذا أساء الناس إليه وذمّوه أو إذا أُصيب بمصيبة تراه وقد أذهب الجزع صبره وأذهل عقله وحال بينه وبين الفهم والإفهام والقول والإسماع، ويغيب عنه أن المصائب التي
تُصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو في أسرته،أو في مجتمعه ليست شرّاً محضاً، يوجب الجزع بل هي خير للمؤمن إن أحسن تلقّيها والتعامل معها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه: “وَاعْلَمْ أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وأنَّ مَعَ العُسْرِ يُسراً”[200].
روى إبراهيم بن مسعود قال: كان رجل من تجار المدينة يختلف إلى جعفر بن محمد (الإمام الصادق) عليهما السلام، فيخالطه، ويعرفه بحسن الحال، فتغيّرت حاله، فجعل يشكو ذلك إلى جعفر بن محمد عليه السلام، فقال جعفر:
وَلا تَجزَع وَإِن أُعسِرتَ يَوماً فَقَد أَيسَرَت في الزَمَنِ الطَّويل
لا تَيأَس فَإِنَّ اليَأسَ كُـفـرٌ لَعَلَّ اللَهَ يُغني مِن قَليلِ
وَلا تَظُنَّنَ بِرَبِّكَ ظنّ سوء فَإِنَّ اللَهَ أَولى بِالجَميلِ
قال إبراهيم بن مسعود: فخرجت من عنده وأنا أغنى الناس[201].
والإمام عليه السلام يتابع في وصيته فيقول: إذا وصلت بتفكيرك إلى نتيجة تقول إنّ هذا العيب موجود فيك فعلاً، لكنّك كنت تُخفيه ولا تُحبّ أن يُعلن على الملأ، فإنّ ما فعله هذا الشخص – بغضّ النظر عن كونه قد ارتكب محرّماً وسيُعاقَب عليه – قد بيّن لك حقيقةً. فهل عليك – يا ترى – أن تضجر وتغضب من اكتشافك للحقيقة؟! فإن أنت فعلت ذلك كان فعلك أسوأ من سابقه, لأنّه إذا علم الإنسان بعيبه فأنكره، كان إنكاره هذا عن عمد وسيؤدّي إلى سقوطه من عين الله أكثر من ذي قبل، وسوف لن ينظر الله إليه نظرة لطف ورحمة، فلماذا تخاف من الذمّ إذن؟ هل تخاف أن يُسيء الناس الظنّ بك، فتسقط من أعينهم وتفقد سمعتك ووجاهتك بينهم؟ هل تخشى من أن تُشكّل هذه الإساءة مانعاً من استمرارك في أعمال الخير فلا تستطيع بعدئذ أن تُقدّم ما كنت تُقدّم من خدمات للعباد؟ أم إنّك تخاف من أن تُحرم من خدمة الناس ومساعدتهم لك؟ لكن أيّهما أسوأ: أن تسقط من أعين الناس أو تسقط من عين الله عزّ وجلّ؟ فمَن هم الناس في مقابل الله تعالى كي يُعيرهم الإنسان كلّ هذه الأهمّية؟ فالمهمّ هو أن لا يسقط المرء من عين الباري عزّ وجلّ، فإنّك إن غضبت في هذا المقام، فستسقط من عين الله، وستُبتلى بأسوأ ممّا خفت منه.
الثواب المجّاني
أمّا إذا قادك تفكيرك إلى أنّه لا أساس لكلّ هذه الإساءات، سواء أكان المسيء مخطئاً في الفهم، أو تعمّد الإساءة كذباً، فإنّه سيُكتب لك في صحيفة أعمالك ثوابٌ في كلتا الحالتين. وليس في ذلك ما يثير الاستياء والانزعاج، (والجزع). بل إنْ ذمّوك بما هو ليس فيك، فعليك أن تفرح لظفرك بثواب من غير تعب ولا نصَب، بل إنّ ذلك ممّا يوجب الشكر أيضاً[202].
أيها المؤمن إذا ذمّوك وعابوك فلا تجزع أو تجازهم بفعلهم، فإن ذلك يوجب زيادة خشونتهم وذمهم بل أعطهم من الإساءة إليك على سبيل القرض في ذمّتهم لتستوفيه منهم يوم حاجتك في القيامة.. قال الإمام الصادق عليه السلام: “أغلق أبواب جوارحك عمّا يقع ضرره إلى قلبك ويذهب بوجاهتك عند الله، ويعقب الحسرة والندامة يوم القيامة، والحياء عمّا اجترحت من السيئات، والمتورِّع يحتاج إلى ثلاثة أصول: الصفح عن عثرات الخلق أجمع، وترك خطيئته فيهم، واستواء المدح والذم…”[203].
وروي عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “قال عيسى بن مريم عليه السلام ليحيى بن زكريا عليه السلام: إذا قيل فيك ما فيك، فاعلم أنه ذنب ذكرته، فاستغفر الله منه، وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم أنها حسنة كُتبت لك لم تتعب فيها”[204].
الدرس السابع: لأهل البيت عليهم السلام موالون
نصّ الوصيّة:
روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر: “يَا جَابِرُ! لا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ أُحِبُّ عَلِيّاً وَأَتَوَلاّهُ ثُمَّ لا يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فَعَّالاً”[205].
المحاور:
-
مقدّمة.
-
أهمّية ومنزلة الولاية.
-
لوازم الولاية.
-
من صفات الشيعة.
-
تحذيرات المعصومين عليه السلام.
المقدّمة
يقول الإمام الباقر عليه السلام في نفس الحديث حول الموضوع ذاته: “يَا جَابِرُ! لا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ أُحِبُّ عَلِيّاً وَأَتَوَلاّهُ ثُمَّ لا يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فَعَّالاً”[206].
فإذا ظنّ الرجل أنّه يكون من موالينا أهل البيت بإظهاره الحبّ لأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلّم فسنبادر إلى سؤاله: هل أن مقام عليّ عليه السلام عند الله أعلى أم مقام محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم؟ فمن الواضح أنّ مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمأعلى من مقام عليّ عليه السلام: “فَلَوْ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ رَسُولَ اللهِ، فَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلّمخَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ عليه السلام”[207].
إذن فمن أراد أن يكون من أهل الولاية فانّه يتعيّن عليه أن يكون تابعاً للإمام عليه السلام بالقول والفعل، أي ينبغي أن تكون محبّة الإمام في قلوبكم وآثار هذه المحبّة ظاهرة في سلوككم، فمجرّد الكلام والادّعاء لا يُجدي نفعاً. إذن، فماذا نصنع؟ يُجيب عليه السلام: “مَنْ كَانَ للهِ مُطِيعاً فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ، وَمَنْ كَانَ للهِ عَاصِياً فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ”[208].
“”فالذين يعصون الله عزّ وجلّ فهم إنّما يعادوننا أهل البيت وليسوا من أوليائنا. فإن كانوا أولياءنا فينبغي أن تُماثل سيرتُهم سيرتَنا وأن يتّبعونا. وبطبيعة الحال فإنّ للولاية مراتبَ وإنّ هذه المرتبة التي يذكرها الإمام الباقر عليه السلام وهي “اتباعنا حذو النعل بالنعل” هي المرتبة العليا من مراتب الولاية وهي المرتبة التي كان يسعى لنيلها مَن هم من أمثال جابر. فإنّه لمثل هذا الرجل – الذي علّمه الإمام عليه السلام خمسين ألف حديث لا يحقّ له نقل واحدٍ منها”[209].
أهمّية ومنزلة الولاية
لم يُعطَ أصل من أصول الدين بعد التوحيد والنبوة أهمية بالغة كما أُعطيت إمامة وولاية الأئمة الطاهرين من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، فقد تصدّى علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام وعلى مرّ الأزمان لبيان الأدلة النقلية والعقلية على أصل إمامتهم وولايتهم، ومن ثم مستلزمات هذه الولاية التي هي بالأصل ولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم، وكان مستندهم في كل ذلك كتاب الله المجيد والسنة النبوية المطهرة، ومن ثم أفعال أئمة الهدى وتقريراتهم وحديثهم عليهم السلام الذي هو حديث رسول الله كما قال مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: “حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث، جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وحديث رسول الله قول الله عزّ وجلّ“[210].
وإن الله تعالى بهدايته وتوفيقه لعلماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام يسّر لهم ـ وله الحمد ـ المجيء بالحجج الساطعة التي لا تترك خليجة، ولا تدع وليجة، فدحضوا كل إشكال، ودرؤوا كل شبهة حاول إلصاقها مخالفوهم بولاية الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً حتّى أسفر الصبح لذي عينين وحصحص الحق لمن رضي به ديناً، وقد روي عن إمامنا الباقر عليهم السلام صاحب هذه الوصية التي نتشرف بخدمتها “والله، لا يجعل الله من عادانا ومن تولاّنا في دار واحدة”[211].
لوازم الولاية
إنّ أهم لوازم الإيمان بهذا الحق هو الحبّ له، والعمل به، فمن المسلَّم به أنّ حبّهم عليهم السلام إيمان وبغضهم والعياذ بالله نـفـاق، وسرّ ذلك يكمن في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمللمسلمين بالتمسّك بالثقلين، واقتران العترة بالقرآن يظهر أن إيجاب محبّتهم لائح من معنى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾[212]، فإنّه تعالى جعل شكر إنعامه، وإحسانه بالقرآن منوطاً بمحبتهم على سبيل الحصر، ولعلّ أول ما يخطر ببال الأخ المسلم، والأخت المسلمة أنه لا يوجد مسلم أو مسلمة على وجه الأرض، إلا ويُحبّان أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم صحيح، ولكن هل تعلم أيها المسلم أن
– (الحب) – أصله الحقيقي هو اللزوم والثبات، كما نص على ذلك فقهاء اللغة العربية، منهم أحمد بن فارس بن زكريا حيث قال: “فالحاء والباء أصول ثلاثة، أحدها اللزوم والثَّبات، والآخر الحَبّة من الشيء ذي الحَبّ، والثالث وصف القِصَر إلى أن يقول:(وهو موضع الشاهد): أمّا اللزوم فالحُبّ والمَحبّة، اشتقاقه من أحَبَّه إذا لزمه. والمُحِبّ: البعير الذي يَحْسِر، فيلزمُ مكانَه“[213].
إن المودّة والحبّ الحقيقي يُصاحبه سعي عن إرضاء المحبوب، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: “ما عرف الله من عصاه”، وأنشد:[214]
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمرك في الفعال بديع
لو كان حبّك صادقاً لأطعته إنّ المحبّ لمن أحبّ مطيع
فكيف يمكن أن يكون المحبّ لله ولرسوله ولأهل البيت صادقاً في حبّه، وهو يُخالفهم في العمل، ويعمل على خلاف إرشاداتهم وتعاليمهم؟ يقول الشيخ المظفر رحمه الله تعالى: إنّ الأئمة من آل البيت عليهم السلام لم تكن لهم همّة.إلا. تهذيب المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما يريدها الله تعالى منهم، فكانوا مع كل من يواليهم، ويأتمنونه على سرّهم يبذلون قصارى جهدهم في تعليمه الأحكام الشرعية وتلقينه المعارف المحمدية، ويعرفونه ما له وما عليه، ولا يعتبرون الرجل تابعاً وشيعة لهم إلا إذا كان مطيعاً لأمر الله مجانباً لهواه آخذاً بتعاليمهم وإرشاداتهم، ولا يعتبرون حبّهم وحده كافياً للنجاة كما قد يمنّي نفسه بعض من يسكن إلى الدعة والشهوات ويلتمس عذراً في التمرّد على طاعة الله سبحانه. إنّهم لا يعتبرون حبّهم وولاءهم منجاة إلا إذا اقترن بالأعمال الصالحة، وتحلّى الموالي لهم بالصدق والأمانة والورع والتقوى[215]، وقد روى إمامنا الباقر عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: “إنّه لا يُدرك ما عند الله إلا بطاعته”[216]، ولذلك أكدوا عليه السلام أن التشيّع لهم وموالاتهم، هو طاعة الله وولايته والتقوى، فمن التزم ذلك، فهو لهم وليّ، ومن كان لله عاصياً ومخالفاً، فهو لهم عدوّ، حتى لو ادّعى مشايعتهم، وحاول أن يصوّر للناس أنّ مجرّد محبّتهم وممارسة بعض الأعمال البسيطة، كفيل بغفران ذنوبهم، وكان من نتاج دعواه الباطلة أن شجَّع الكثير من الموالين على التساهل في أمور الدّين، وغرّر بهم وأوقعهم في متاهات لا نهاية لها، وأبعدهم كل البعد عن أهداف الأئمة المعصومين عليهم السلام.
من صفات الشيعة
يظهر بوضوح لمن يتتبّع روايات أهل البيت عليهم السلام الصفات الحقيقية للشيعة نذكر منها:
1- شيعتنا من اتقى الله:
في حديث آخر حدّث به إمامنا أبو جعفر الباقر عليه السلام تلميذه النجيب جابر الجعفي، وقد بيّن فيه ماهية المفاهيم التي تُشخِّص صفات الأتباع الحقيقيين لأهل البيت عليهم السلام وجعل هذه المفاهيم أوضح من الشمس في رابعة النهار، فقال عليه السلام: “يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت، فو الله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشّع والأمانة، وكثرة ذكر الله، والصوم والصلاة، والبر بالوالدين، والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة، والغارمين والأيتام، وصدق الحديث وتلاوة القرآن، وكفّ الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء.ـ.”[217].
2- شيعتنا أهل الطاعة:
قال الإمام الباقر عليه السلام لجابر: “أحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ أتقاهم وأعملهم بطاعته، يا جابر والله ما نتقرّب إلى الله عزّ وجلّ: إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار،ولا على الله لأحد من حجّة، من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصياً، فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع“[218].
3- شيعتنا زين لنا:
وروى أحد أصحاب الصادق عليه السلام قال: سمعت أبا عبد الله يقول: “عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً، وعليكم بطول الركوع والسجود، فإنّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت”[219].
4- شيعتنا أهل الصلاة والقيام لله:
وكتب الإمام الصادق عليه السلام رسالة إلى جماعة من شيعته كتاب جاء فيه: “وعليكم بالمحافظة
على الصلوات والصلاة والوسطى، وقوموا للّه قانتين كما أمر الله به المؤمنين في كتابه من قبلكم، وعليكم بحبّ المساكين المسلمين، فإنّ من حقّرهم وتكبّر عليهم، فقد زلّ عن دين الله والله له حاقر ماقت، وقد قال أبونا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أمرني ربّي بحبّ المساكين المسلمين منهم واعلموا أنّ من حقّر أحداً من المسلمين ألقى الله عليه المقت منه والمحقرة حتّى يمقته الناس أشدّ مقتاً..”..[220]
5- شيعتنا من حفظوا ألستنهم وكفّوا أيديهم:
روي عن الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام لبعض شيعته: “بلّغ موالينا عنّا السلام، وقل لهم إنّي لا أُغني عنكم من الله شيئاً إلاّ بورع، فاحفظوا ألسنتكم وكفّوا أيديكم وعليكم بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين“[221].
6- شيعتنا من أهل العمل:
قال مولانا الإمام الباقر عليه السلام لصاحبه خيثمة: “أبلغ شيعتنا أنه لا يُنال ما عند الله إلا بالعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره، وأبلغ شيعتنا أنّهم إذا قاموا بما أمروا أنهم هم الفائزون يوم القيامة”[222].
7- شيعتنا هم الأورع:
عن علي بن أبي زيد، عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عيسى بن عبد الله القمي، فرحّب به وقرّب مجلسه ثم قال: “يا عيسى بن عبد الله (ليس منّا ولا كرامة) من كان في مصر فيه مائة أو يزيدون، وكان في ذلك المصر أحد أورع منه[223].
وخلاصة القول ما جاء في وصية مولانا الإمام أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام لشيعته قال: “أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم، والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من برّ أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار. فبهذا جاء محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم صلّوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدّوا حقوقهم، فإنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه، وأدّى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا شيعيّ فيسرّني ذلك، اتّقوا
الله وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً، جرّوا إلينا كلّ مودّة، وادفعوا عنّا كلّ قبيح، فإنّه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حقّ في كتاب الله وقرابة من رسول الله، وتطهير من الله لا يدّعيه أحد غيرنا إلاّ كذّاب، أكثروا ذكر الله، وذكر الموت، وتلاوة القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، فإنّ الصلاة على رسول الله عشر حسنات، احفظوا ما وصّيتكم به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام”[224].
من هذه الروايات الشريفة وأمثالها يُعلم أن عنوان التشيّع لأهل البيت عليهم السلام ومحتوى منهجهم هو تقوى الله وطاعته، والورع عن محارمه.
ليس منّا
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “ليس منّا من يُحقِّر الأمانة – يعني يستهلكها إذا استودعها – وليس منّا من خان مسلماً في أهله وماله”[225].
وعنه صلى الله عليه وآله وسلّم: “ليس منّا من خان بالأمانة“[226].
وعن الإمام الصادق عليه السلام: “إنّه ليس منّا من لم يُحسن صحبة من صحبه، ومرافقة من رافقه، وممالحة من مالحه، ومخالفة من خالفه”[227].
وعن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام: “ليس منّا من لم يُحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل خيراً استزاد الله وحمد الله عليه وإن عمل شرّاً استغفر الله منه وتاب إليه”[228].
روى الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه، أو ماكره“[229].
قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: “ليس منّا من لم يأمن جاره بوائقه“[230].
يتضح من روايات أهل بيت العصمة أنّ مجرّد إظهار التشيّع والولاء لأهل البيت عليهم السلام لا يكفي في إثبات صدق هذه الدعوى، وإنّ إظهار المودّة والمحبّة لأهل البيت عليهم السلام إذا لم يقترن بالعمل بالواجبات واجتناب السيئات، فإنّه لا يوجب السعادة في الآخرة والنجاة من المهالك، إن كل من أطاع أوامر الله عزّ وجلّ فهو
من محبّي أهل البيت والموالين لهم وكل من عصى الله عزّ وجلّ فهو عدوّ لأهل البيت عليهم السلام حتى لو أعلن ولاءه لهم.
اللهمّ إنّا نقسم عليك بحقّ محمّد وآل محمّد عليهم السلام أن تمنّ علينا بحقيقة الولاية وأن توفّقنا للسير على نهج أهل بيت نبيّك عليهم السلام بالقول والعمل.
الدرس الثامن: للكتاب حافظون
نصّ الوصيّة:
روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر قال: “ولكن أعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللهِ, فَإِنْ كُنْتَ سَالِكاً سَبِيلَهُ، زَاهِداً فِي تَزْهِيدِهِ، رَاغِباً فِي تَرْغِيبِهِ، خَائِفاً مِنْ تَخْوِيفِهِ فَاثْبُتْ وَأَبْشِرْ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُبَايِناً لِلْقُرْآنِ فَمَاذَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِنْ نَفْسِكَ”[231].
المحاور:
-
مقدّمة.
-
دليل يدلّ على خير سبيل.
-
نوراً لا تُطفأ مصابيحه، وسراجاً لا يخبو توقّده.
-
هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
-
حبل الله المتين والصراط المستقيم.
-
الناصح الذي لا يغشّ، والهادي الذي لا يضلّ.
-
منهاجاً لا يضلّ نهجه.
مقدّمة
كان جابر من خواصّ أصحاب الإمام الباقر عليه السلام وكان شديد الرغبة في الانخراط في زمرة أولياء أهل البيت عليهم السلام وأصحاب المقام الرفيع المتمثّل بالولاية. وبعد أن أوصى مولانا الإمام الباقر عليه السلام صاحبه وتلميذه جابر الجعفي قائلاً: “أوصيك بخمس… إِنْ ظُلِمْتَ فَلا تَظْلِمْ، وَإِنْ خَانُوكَ فَلا تَخُنْ، وَإِنْ كُذِّبْتَ فَلا تَغْضَبْ، وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَفْرَحْ، وإِنْ ذُمِمْتَ فَلا تَجْزَعْ”، يرفع الإمام عليه السلام وتيرة كلامه متابعاً بالقول: “وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ لا تَكُونُ لَنَا وَلِيّاً حَتَّى لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ وَقَالُوا إِنَّكَ رَجُلُ سَوْءٍ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ، وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرَّكَ ذَلِكَ”[232].
في هذا القسم من الوصية الشريفة يُحدّد الإمام الباقر عليه السلام لجابر بعض المعايير والشروط اللازمة للظفر بمقام الولاية السامي فيقول الإمام عليه السلام في هذا الصدد: إنّ هذا المقام الذي تطلبه وتنشده لا يُنال بسهولة ويُسر, بل إنّ له شروطاً وإنّ عليك الاستعداد لبلوغه. فاعلم أنّك لن تنال ولايتنا أهل البيت ما لم تتزيّن بهذه السجيّة وهي, أنّه لو اجتمع جميع أهل مدينتك الذين عشت معهم وترعرعت بينهم، وقابلوك ببذيء الكلام، ورفعوا ضدّك الشعارات، فلا ينبغي حتّى أن تحزن لذلك، وعلى العكس فلو اجتمع جميع أهالي تلك المدينة يوماً من الأيّام وصاروا يهتفون باسم جابر وبحياته وشهدوا جميعاً على أنّك رجل في قمّة الصلاح والتقوى، فلا ينبغي أن تفرح لذلك, أي: لا بدّ أن يكون وضعك الروحيّ والنفسيّ ثابتاً، سواء شَتَمَك جميع أهل مِصرك أم امتدحوك, فلا تحزن لذاك ولا تفرح لهذا.
دليل يدلّ على خير سبيل
فما هو التكليف إذن؟ يُجيب الإمام عليه السلام: “وَلَكِنِ أعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللهِ, فَإِنْ كُنْتَ سَالِكاً سَبِيلَهُ، زَاهِداً فِي تَزْهِيدِهِ، رَاغِباً فِي تَرْغِيبِهِ، خَائِفاً مِنْ تَخْوِيفِهِ فَاثْبُتْ وَأَبْشِرْ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُبَايِناً لِلْقُرْآنِ فَمَاذَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِنْ نَفْسِكَ”[233], فأعرض نفسك
على محتوى القرآن! وانظر فيما إذا كنت كما يريد القرآن أم لا من دون الاكتراث لإهانات الناس وإطرائهم فإذا كنت كما يريد القرآن الكريم فاشكر الله على ذلك! وإن لم تكن كذلك فاسعَ في إصلاح نفسك وإزالة عيوبها![234].
لو كان للهداية وصف غالب، فلن يكون لها اسم سوى ومسمّى سوى “القرآن الكريم“. وهذا ما جسّده إمام الهدى وسليل بيت التقى مولانا الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام، وكي نستفيد تمام الفائدة من هذا التكليف “أعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللهِ”، يتوجّب علينا أن نتوجّه إلى من أُنزل عليه القرآن لأنّه لا يمكن أن يتدبّر القرآن من لا يدري حقيقة القرآن، ولا إنزال القرآن، ولا منزل القرآن ولا المنزل عليه القرآن محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم الأطهار، الذين ينقل لنا ثامنهم عن آبائه عن جده سيد الأنس والجان قولهصلى الله عليه وآله وسلّم: “أيّها الناس إنّكم في دار هدنة، وأنتم على ظهر سفر والسير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كلّ جديد ويُقرِّبان كلّ بعيد، ويأتيان بكلّ موعود، فأعدّوا الجهاز لبُعد المجاز قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله وما دار الهدنة؟ قال: دار بلاغ وانقطاع، فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، فعليكم بالقرآن، فإنّه شافع مشفّع وماحل مصدق[235] ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم لا تُحصى عجائبه، ولا تبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة، فليجل جال بصره، وليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب[236]، ويتخلّص من نشب[237]، فإنّ التفكّر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخلّص وقلّة التربّص[238]“[239].
هذا هو الثقل الأكبر الذي قرنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، وهما الثقلان اللذان خلّفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في أمّته ليكونا سبباً للهداية والنجاة، ما إن تمسّك أبناء هذه الأمة
بهما، لأنّهما متلازمان لا يمكن التمسّك بأحدهما دون الآخر، وأن ترك أحدهما معناه تركهما معاً، ومن هنا تأتي عظمة وصية إمامنا الباقر عليه السلام لجابر “أعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللهِ“.
حقيقة القرآن
من الثابت أنّ عظمة كلّ عمل بعظمة أثره، وعظمة الموعظة من عظمة الواعظ، وإنّ الكلام يعظم بعظم قائله، فكيف إذا كان المتكلِّم هو الله عزّ وجلّ؟ وكلامه جلّ شأنه هو كتابه الخالد، وحجّته البالغة على الناس جميعاً، ختم الله به الكتب السماوية، وأنزله هداية ورحمة للعالمين، وضمّنه منهاجاً كاملاً وشريعة تامّة لحياة المسلمين، وجعله معجزة وآية باقية ما بقي الليل والنهار، أيّد الله تعالى به مصطفاه محمداً صلى الله عليه وآله وسلّموتحدّى الإنس والجنّ على أن يأتوا بسورة من مثله، فكان عجز البلغاء والفصحاء قديماً، وما زال كذلك حديثاً، قال تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾[240].
إنّه مصدر عزّة هذا الدين وأهله، وسرّ تجدّده في نفوس المسلمين، وهو الذي لا يخلق من كثرة الترداد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يمله قارئه ولا سامعه، ولا يزداد به المؤمن إلا يقيناً بدينه وتعلّقاً به، إنّه المعجزة الخالدة، والكتاب الذي وعد الله بحفظه قائلاً: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[241].
في خطبة من خطبه ذكر الإمام علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بما هو أهله ثم قال: “ثمّ أنزل عليه الكتاب نوراً لا تُطفأ مصابيحه، وسراجاً لا يخبو توقّده، وبحراً لا يُدرك قعره، ومنهاجاً لا يضلّ نهجه، وشعاعاً لا يُظلم ضوءه، وفرقاناً لا يُخمد برهانه، وتبياناً لا تُهدم أركانه، وشفاء لا تُخشى أسقامه، وعزّاً لا تُهزم أنصاره، وحقّاً لا تُخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافيّ الإسلام وبنيانه، وأودية الحقّ وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضلّ نهجها المسافرون. وأعلام لا يعمى عنها السّائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ريّاً لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاجّ لطرق الصّلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونوراً ليس معه ظلمة، وحبلاً وثيقاً عروته، ومعقلاً منيعاً ذروته، وعزّاً لمن تولاّه، وسلماً لمن دخله، وهدى لمن ائتمّ به، وعذراً لمن انتحله، وبرهاناً لمن تكلّم به، وشاهداً لمن خاصم
به، وفلجاً لمن حاجّ به، وحاملاً لمن حمله، ومطيّة لمن أعمله، وآية لمن توسّم، وجنّة لمن استلأم. وعلماً لمن وعى، وحديثاً لمن روى، وحكماً لمن قضى”[242].
فضل القرآن
سنقتصر في بيان فضل القرآن الكريم على بعض الآيات الكريمة التي وصف الله تعالى بها كتابه، ونزراً يسيراً من وصف مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وأخيه أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنه عدل القرآن، وصفه الله تعالى بأوصاف تنبئ عن عظمة شأنه، وقوة حُجَجِه وبرهانه، وحسن عاقبته على تالِيه والمتدبرِّ له، ويُمنِه على أهله العالمِين به، فوصفه الله تعالى بأنه نورٌ وهدى وموعظة وذكرى وتبصرة وشفاء، وأنه فرقانٌ وبيانٌ، إلى غير ذلك من أوصافه العظيمة ونعوته الكريمة، ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾[243]. وقوله جلّ شأنه: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾[244]، لكفى في التنويه بشرفه والإرشاد بفضله، فكيف وقد وصفه الله تعالى بأنه روح من أمره، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾[245]، ووصفه بأنه الهادي إلى أفضل طريق، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾[246]، ووصفه الله بأنّه نور، والنور به الإبصار، فقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾[247]، ووصفه بأنه شفاء ورشاد، فقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء﴾[248]، ونعته بأنه كتاب الحق الذي لا يعرض له الباطل قط، فقال تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾[249]، وقال الله عز وجل: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾[250].
وهنا تكمن أهمية القرآن الكبرى وأهمية ما اشتمل عليه من هداية إلى العقائد الصحيحة، والعبادات الحقّة، والأخلاق الكريمة، والتشريعات العادلة، وما اشتمل عليه من تعاليم بناء المجتمع
الفاضل، وتنظيم الدولة القوية. ولو أراد المسلمون الخير والصلاح والعزّة لأنفسهم وأمتهم لجدّدوا إيمانهم بأهمية هذا الكتاب الكريم، والعترة النبوية الطاهرة، وكانوا جادّين في الالتزام والطاعة لهما، فإنّهم يجدون ما يحتاجون إليه من حياة روحية طاهرة، وقوة سياسية وحربية، وثروة وحضارة، ونعم لا تعدّ ولا تُحصى, قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ﴾[251].
القرآن في كلام المعصومين عليهم السلام
وصف سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم القرآن الكريم، فكان وصفاً حافلاً بمزايا القرآن، جامعاً لفضائله, فقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: “إنّها ستكون فتنة. قُلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبّار قصمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا يشبع منه العلماء، ولا تلتبس منه الألسن، ولا يخلق من الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم ينته الجنّ إذ سمعته حتى قالوا: إنّا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم”[252].
وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلّم أيضاً أنه قال: “القرآن أفضل كلّ شيء دون الله، فمن وقّر القرآن فقد وقّر الله، ومن لم يوقّر القرآن فقد استخفّ بحرمة الله”[253].
ولمّا كان القرآن كلام الله عزّ وجلّ، فلا يُقاس بكلام المخلوقين، ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: “فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه”[254]. وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: “القرآن غنى لا غنى دونه، ولا فقر بعده”[255]. وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: “القرآن مأدبة الله، فتعلّموا مأدبته ما استطعتم، إنّ هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع”[256]. وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: “من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلاً أُعطي أفضل ممّا أُعطي فقد صغّر عظيماً، وعظّم صغيراً”[257].
منهاجاً لا يضلّ نهجه
ومن خلال ما تقدّم نجد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وأخاه أمير المؤمنين عليه السلام ومن أجل ربط الأُمّة بالقرآن الكريم والالتزام بما جاء فيه من مفاهيم وقيم وأحكام وأخلاق، قد بيَّنا لنا أنّ القرآن الكريم رفيق المتّقين، وأنّه ربيع القلوب المتجدِّد، وأنّ القرآن ينابيع العلوم، والشفاء النافع لأمراض الأُمّة بجميع أنواعها إن تمسّكت به وجَعْلته دستوراً لها، وكُانت سَالِكة سَبِيلَهُ، زَاهِدة فِي تَزْهِيدِهِ، رَاغِبة فِي تَرْغِيبِهِ، خَائِفة مِنْ تَخْوِيفِهِ، فَإنّها ستكون ثْابتة على الحق ولها البشرى، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّها مَا قِيلَ فِيها، وَإِنْ كاْنتَ مُبَايِنة لِلْقُرْآنِ، فَمَاذَا الَّذِي يَغُرُّها مِنْ نَفْسِها.
وهكذا أرشدنا مولانا الإمام الباقر عليه السلام في وصيّته لجابر الجعفي فعرّفنا الطريقة المثلى للثبات على الحق، وبشّر سالكيها بحسن المآل، ودلّنا على الطريقة العملية للنجاة من الشبهات والفتن والضلال عبر إصلاح النفس وإزالة عيوبها، عبر وزنها بميزان القرآن: “أعرض نفسك على القرآن الكريم، فإن كنت سالكاً سبيله” فإن قال لك: خفْ، فأنت تخاف، وإذا قال لك: تقدّم، فإنّك تتقدّم، وعندما يقول لك: قف، فأنت تقف، وحينما يقول لك: أَحِبّ، فأنت تُحبّ، وإن قال لك: أبغض، فإنّك تبغض[258]… بذلك تكون حالاتك مطابقة لأوامر الله تعالى، وعندها تُدرك لماذا قال في فرقانه الحكيم: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[259]. وقال وليه الباقر عليه السلام: “الذكر القرآن، ونحن أهله“[260].
نعم في بيتهم نزل القرآن، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. وهما يشتركان معاً في إضاءة عقل الإنسان وروحه وقلبه، ويُوجهانه إلى حيث سعادته في الدارين، فلولا القرآن لم يكن للحياة هدى، ولا للإنسان رشد، ولا علق في طرفه نور، ولولا أهل البيت عليهم السلام لم يكن للرشد مُرشد، ولا للعلم معلم، ولا للنور مشكاة ومصباح، ولا للنجاة سفينة، فالقرآن الكريم أصل العلم، وأهل البيت عليهم السلام معرفته ومعدنه وبيانه.اللهم صل على محمد وآله، وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا، واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا، واجمع به منتشر أمورنا، وأرو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا، واحشرنا مع حبيبك المصطفى محمد وآله الطاهرين.
الدرس التاسع: للنفس مجاهدون
نصّ الوصيّة:
روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر قال: “إنَّ الْمُؤْمِنَ مَعْنِيٌّ بِمُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ لِيَغْلِبَهَا عَلَى هَوَاهَا، فَمَرَّةً يُقِيمُ أَوَدَهَا وَيُخَالِفُ هَوَاهَا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ، وَمَرَّةً تَصْرَعُهُ نَفْسُهُ فَيَتَّبِعُ هَوَاهَا، فَيَنْعَشُهُ اللَّهُ فَيَنْتَعِشُ، وَيُقِيلُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ، فَيَتَذَكَّرُ وَيَفْزَعُ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَخَافَةِ، فَيَزْدَادُ بَصِيرَةً وَمَعْرِفَةً لِمَا زِيدَ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾”[261].
المحاور:
-
مقدمة.
-
كيف نُجاهد من لا نعرفه؟
-
معرفة النفس أنفع المعارف.
-
الجهاد الأكبر.
-
الحبّ يُذلّل المصاعب.
-
الله ناصر المؤمن ومعينه.
-
العلاقة بين الخوف والمعرفة.
مقدّمة
“هذا المقطع من كلام الإمام عليه السلام ينطوي على مبحث رفيع المستوى وصعب المنال للغاية. ومن الواضح أنّه عليه السلام قد أسدى هذا النصح لجابر إذ وجد فيه الاستعداد لتقبّله, أمّا أمثالنا فقد نُصاب باليأس عندما نسمع مثل هذا الكلام ونقول: بما أنّنا لا نستطيع أن نكون كذلك فلن نُعَدّ من أصحاب ولاية أهل البيت عليهم السلام.
ولعلّ هذا الشيء هو الذي جعل الإمام عليه السلام يُتبِع حديثه هذا ببيان عامّ تربويّ مشبّهاً المؤمن في هذه الدنيا بالمصارع الذي يتصارع مع نفسه ويحاول التغلّب عليها، فتارةً تعلو همّته وتقوى إرادته، فيوفَّق بعون من الله عزّ وجلّ في الغلبة على النفس وصرعها، وتارةً أخرى تصرعه النفس وتطرحه أرضاً. فأبطال المصارعة لم يصبحوا أبطالاً بين ليلة وضحاها، بل إنّهم قد عكفوا على التمرين لفترات طويلة وصُرِعوا وصَرَعوا مراراً حتّى بلغوا هذه المرحلة، وإنّه ليس أمام كلّ مَن يرغب في الوصول إلى هذا المستوى سوى هذا الدرب. وكذا المؤمن فهو في حالة مصارعة مع نفسه, فقد تتغلّب عليه النفس أحياناً وتصرعه أرضاً، لكن لا ينبغي أن ييأس ويقول: إنّني لن أستطيع التغلّب على نفسي. فأنا غارق لا محالة، ولا فرق إن غرقت بين شبر من الماء ومائة شبر! لكن الأمر ليس بهذه الصورة، فكلّما قلّت المسافة التي تفصلنا عن سطح الماء كان أفضل، وحتّى المقدار القليل يكون ذا أهمّية أيضاً. فإن صُرعت أرضاً مرّةً فانهض، وواصل النزال مع نفسك بهمّة أصلب وعزيمة أشدّ رسوخاً، وتوكّل على الله تعالى، وستنتصر في المرّة الثانية، فالدنيا حلبة مصارعة، وعلى كلّ امرئ أن يصارع فيها نفسه باستمرار”[262].
كيف نجاهد من لا نعرفه؟
كان بالمستطاع البدء بالحديث عن مجاهدة المؤمن نفسه ليغلبها على هواه، فندلي في هذا الموضوع بدلونا، ولكنّنا آثرنا قبل البدء بذلك أن نطرح هذا السؤال الذي قد يخطر على بال أي متتبّع لهذا الموضوع، وهو: كيف نقوم بمجاهدة من لا نعرفه ؟ ولا نعرف إمكاناته وتجهيزاته وخططه!
خصوصاً أنه قد ورد عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: “أعدى عدوّك. نفسك التي بين جنبيك“[263]. وود عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: “من عرف نفسه فقد عرف ربّه“[264]. وقال عليه السلام: “من عجز عن معرفة نفسه، فهو عن معرفة خالقه أعجز”[265]. وعنه عليه السلام قال: “أفضل العقل معرفة المرء نفسه، فمن عرف نفسه عقل، ومن جهلها ضل”[266]، وقال عليه السلام: “من عرف نفسه جاهدها“[267].
ونحن في سؤالنا هذا لا نريد أن يكون موضوعنا هذا عن معرفة النفس، والطريق الذي يتوجّب سلوكه في هذا الأمر، ولكنّنا أردنا أن نثير دفائن العقول بهذا السؤال الذي طرحناه.
ولأن المؤمن لن يتمكّن من مجاهدة نفسه، ولن يعرف كيف يتغلّب على هوى النفس قبل أن يعرفها، وأمثال جابر الجعفي وإخوانه الكرام من أصحاب أئمة الهدى كانوا يعرفون أنفسهم، وبالتّالي يعرفون ربّهم وهذا ما مكّنهم من مجاهدة أنفسهم والارتقاء بها إلى درجات العليين. وقد جاءت معرفتهم هذه من تشرُّفهم بصحبة وملازمة الأئمة الهداة المهديين من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم، وصدقهم وإخلاصهم لهذه الصحبة والملازمة وتدبّرهم لأقوال وأفعال وتقرير المعصومين عليهم السلام.
معرفة النفس أنفع المعارف
يقول العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه في شرح قول أمير المؤمنين عليه السلام: “المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين“[268]: “الظاهر أن المراد بالمعرفتين المعرفة بالآيات الأنفسية والمعرفة بالآيات الآفاقية، قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾[269]، وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾[270].
وكون السير الأنفسي أنفع من السير الآفاقي، لعله لكون المعرفة النفسانية لا تنفك عادة من إصلاح أوصافها وأعمالها بخلاف المعرفة الآفاقية. وذلك أن كون معرفة الآيات نافعة إنما هو لأن معرفة الآيات بما هي آيات موصلة إلى معرفة الله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله. ككونه تعالى
حياً لا يعرضه موت، وقادراً لا يشوبه عجز، وعالماً لا يُخالطه جهل، وأنه تعالى هو الخالق لكل شيء، والمالك لكل شيء، والرب القائم على كل نفس بما كسبت، خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم بل لينعم عليهم بما استحقّوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
إلى أن يقول: فتخلص ممّا ذكرنا أن النظر في الآيات الأنفسية والآفاقية ومعرفة الله سبحانه بها يهدي الإنسان إلى التمسّك بالدين الحق والشريعة الإلهية من جهة تمثيل المعرفة المذكورة الحياة الإنسانية المؤبدة له عند ذلك، وتعلقها بالتوحيد والمعاد والنبوة، وهذه هداية إلى الإيمان، والتقوى يشترك فيها الطريقان معاً أعني طريقي النظر إلى الآفاق والأنفس فهما نافعان جميعاً غير أنّ النظر إلى آيات النفس أنفع، فإنّه لا يخلو من العثور على ذات النفس وقواها وأدواتها الروحية والبدنية وما يعرضها من الاعتدال في أمرها أو طغيانها أو خمودها، والملكات الفاضلة أو الرذيلة، والأحوال الحسنة أو السيئة التي تُقارنها، واشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يلزمها من أمن أو خطر، وسعادة أو شقاوة لا ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب، فيشتغل بإصلاح الفاسد منها، والالتزام بصحيحها بخلاف النظر في الآيات الآفاقية، فإنه وإن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سفاسف الأخلاق ورذائلها، وتحليتها بالفضائل الروحية لكنّه ينادي لذلك من مكان بعيد، وهو ظاهر”[271].
الجهاد الأكبر
قال الله العظيم في مُحكم كتابه وجليل خطابه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾[272] ومن معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿جَاهَدُوا فِينَا﴾ أي: جاهدوا في الله أنفسهم، وجاهدوا الكفار، وجاهدوا المنافقين، وجاهدوا الشيطان..، فالآية عامة تشمل جميع أنواع الجهاد، ومن ذلك: جهاد النفس , لأنه سبحانه حذف المفعول، ولم ينص عليه في الآية، حتى تعم كل أنواع الجهاد.
ويقول عزّ وجلّ: ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾[273]، إنّ الجهاد في الإسلام هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في سبيل أمر من الأمور, وهو بهذا المعنى يشمل ثلاثة أنواع من الجهاد: جهاد أعداء الإسلام، ويكون بالنفس والمال وبكلِّ ما يملك المسلم من طاقة، وهو فرض كفاية، إذا قام به المُؤَهَّلون له، أجزأ عن الآخرين وعن أهل الأعذار الَّذين لا يستطيعون أن يجاهدوا. وهناك جهاد آخر
هو جهاد النفس والهوى وهو الأكبر، وهذا الجهاد فرض عَيْن على كلِّ مسلم، وقد عُدَّ جهاداً أكبر، لأنه جهاد مستمرٌّ دائم ما استمرّت الحياة، ولا يتمكّن من جهاد عدوّه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنًا فمن نُصِرَ عليها نُصِرَ على عدوّه، ومن نُصِرَتْ عليه نُصِرَ عليه عدوّه.
روى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بعث سريّة، فلمّا رجعوا قال: “مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر، وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ فقال: جهاد النفس”[274].
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: “جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدو عدوّه وغالبها مغالبة الضد ضدّه، فإنّ أقوى الناس من قوي على نفسه“[275]، وقال عليه السلام: “إنّ مجاهدة النفس لتزمها عن المعاصي وتعصمها عن الردى“[276]، وقال عليه السلام: “غاية المجاهدة أن يجاهد المرء نفسه”[277] وقال عليه السلام: “رأس العقل مجاهدة الهوى”[278]، “طوبى لمن غلب نفسه ولم تغلبه، وملك هواه ولم يملكه”[279]. ولقد أجاد الشاعر بقوله: والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع.
إنّ أيّ مؤمن من المؤمنين، وبغضّ النظر عن منسوب التقوى الذي عنده يعلم علم اليقين أنّ هذه الوصية التي أوصاها إمامنا الباقر عليه السلام لصاحبه جابر مطابقة تماماً للفطرة التي فطره الله عليها، وقد مرّ بها كثيراً في خلواته بل تولّد لديه إحساس هو أشبه باليقين أنّ الإمام الباقر عليه السلام كأنّما يعيش معه في تلك الحالة، ويوجّهه بذلك التوجيه الحكيم.
الحبّ يُذلّل المصاعب
أشار الإمام الباقر عليه السلام في هذه الوصية إلى التفاتات تربويّة قيّمة، فيقول: “إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَعْنِيٌّ بِمُجَاهَدَةِ نَفْسِهِ لِيَغْلِبَهَا عَلَى هَوَاهَا”, فديدن المؤمن واهتماماته هي في جهاد نفسه: “فَمَرَّةً يُقِيمُ أَوَدَهَا وَيُخَالِفُ هَوَاهَا فِي مَحَبَّةِ الله“[280], فهو يتمكّن أحياناً من تقويم اعوجاجاتها وانحرافاتها
ويخالف هواها في سبيل محبّة الله عزّ وجلّ. وهذه العبارة تحتوي على ملاحظة جديرة بالاهتمام, فلو أنّه عليه السلام لم يقل: “فِي مَحَبَّةِ الله” لكانت العبارة تامّة، فلماذا أضاف هذا الجار والمجرور؟ الجواب: هذا الجار والمجرور هو لتبيين سبيل شيّق للتغلّب على الهوى بحيث يتمكّن المرء بسلوكه من التغلّب على هواه من جانب والشعور باللذّة من جانب آخر. فإن عثر الإنسان على هذا السبيل وعرف قدره فسيجد أنّه سبيل قيّم إلى أبعد الحدود.
نقرأ في المناجاة الشعبانيّة: “إلهي لم يكن لي حولٌ فأنتقلَ به عن معصيتك إلاّ في وقت أيقظتني لمحبّتك وكما أردتَ أن أكونَ كنتُ“[281]، فمخالفة النفس تكون أيسر إذا كانت محفوفة بجوّ من المحبّة. فالطفل المتعلّق كثيراً بأبويه عندما يزداد عبثه وإيذاؤه للآخرين ولا يُصغي لتوجيهات أبويه تقول له أمّه: “إذا كنت تُحبّني فلا تفعل ذلك“. فإن كان النهج المتّبَع في تربيته صحيحاً وكانت عواطفه مشبعة فسيشكّل هذا الكلام أفضل رادع يردعه عن ممارسة الأعمال القبيحة.
فإن كان قلب الإنسان عامراً حقّاً بمحبّة الله تعالى، وكان يُدرك أنّ الله أحبّ من أيّ محبوب، وأنّ كلّ سبب للمحبّة هو في الواقع شعاع من الفيوضات اللامتناهية له عزّ وجلّ، فإنّه سيترك القبيح بكلّ سهولة ويسر إذا قال له ربّه: “إذا كنت تُحبّني فلا تفعل ذلك”. لكنّ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: هل يقول الله مثل هذا القول؟ والجواب: نعم، فعندما يقول الباري جلّت آلاؤه في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾[282]، أو يقول: ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾[283]، فهو في الحقيقة يستخدم النهج التربويّ ذاته, فكأنّه يقول: إذا كنت تُحبّني فلا تتكبّر، وإذا كنت تُحبّني فكن من الصابرين. فهذه الطريقة هي من أفضل السبل التي يُمكن أن يسلكها المرء لترك المعصية. ومن هنا فإنّ ذكر الإمام عليه السلام لهذه العبارة: “فِي مَحَبَّةِ الله” يتضمّن – في حقيقة الأمر – إشارة لهذه الطريقة المثلى.
الله ناصر المؤمن ومعينه
يتابع الإمام الباقر عليه السلام في وصيّته فيقول: “وَمَرَّةً تَصْرَعُهُ نَفْسُهُ فَيَتَّبِعُ هَوَاهَا“، أي يتّبع ما تهوى وتُحبّ. ففي نزال المصارعة هذا تتغلّب النفس على الإنسان حيناً فتصرعه، ويغلبها هو طوراً فيطرحها أرضاً. فعندما يذوق الشخص المتفلّت من الالتزامات الدينيّة طعم المعصية مرّة تراه
يلهث وراءها بولع وشغف في كلّ مرّة. أمّا المؤمن فهو ليس بهذه الصورة، والمؤمن المفتَرَض هنا هو ذلك الإنسان الذي يكون في حالة صراع مع نفسه وهو يحاول صرعها على الدوام لكنّه يخفق من باب الصدفة في هذا النزال فتصرعه نفسه. فالله في هذه الحالة يمدّ له يد العون ولا يدعه يُسحَق تحت سطوة نفسه تقديراً لما اتّصف به من الإيمان والتقوى. “فَيَنْعَشُهُ اللهُ فَيَنْتَعِشُ، وَيُقِيلُ اللهُ عَثْرَتَهُ فَيَتَذَكَّرُ، وَيَفْزَعُ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَخَافَةِ فَيَزْدَادُ بَصِيرَةً وَمَعْرِفَةً لِمَا زِيدَ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ“, فشخص كهذا يساعده الله على الوقوف على قدميه مرّة أخرى ليستمرّ في النزال مع النفس، ويغضّ جلّ وعلا طرفه عن عثراته، وهو (هذا الإنسان) بدوره يتذكّر ويتنبّه بأنّه قد اقترف خطأ عظيماً. وفي إثر الخوف الناشئ من هذه الحالة يزيد الله في بصيرته ومعرفته، فتراه لذلك يستأنف النزال بقوّة أشدّ وعزيمة أكبر.
والالتفاتة التربويّة الأخرى التي ينطوي عليها هذا الكلام هي أنّ المرء في هذا النزال ليس أنّه لا ينبغي أن يتسلّل اليأس إلى قلبه إذا سقط أرضاً فحسب، بل لا بدّ أن يحدوه الأمل بتنامي قوّته أيضاً. فعليه أن يتوجّه إلى الله بعد سقوطه ويلجأ إليه بالتوبة والإنابة، قائلاً له: “إلهي! أخشى أن أصرع إنْ أنا اتّكلت على قدرتي. فكن أنت معيني وحافظي”. هذا الالتفات إلى الباري عزّ وجلّ والخوف من سخطه يبعث على تقوية روح الإنسان وتعزيز إرادته الأمر الذي يُضفي كمالاً إلى كماله. ولعلّ المراد من قوله تعالى: ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾[284] هو أنّ الإنسان إذا تاب بعد ارتكاب الخطيئة، فإنّ نفس هذه الحالة المتمثّلة بالإنابة واللجوء إلى الله هي ضرب من ضروب العبادة وهي حالة لم تكن موجودة لديه قبل اقتراف الذنب. فمضافاً إلى أنّ حالة التضرّع والتوسّل هذه تساعد على محو عمله السابق، فإنّها تُضفي عليه كمالاً مضاعفاً، أي إنّها تُزوّده بقدرة أكبر على اكتساب النورانيّة.
العلاقة بين الخوف والمعرفة
ثمّ يستدلّ الإمام عليه السلام بآية من الذكر الحكيم فيقول: “وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾[285]“. فالمؤمن الذي تبدُر منه زلّة في حين من الأحيان لا يُعدّ من أتباع الشيطان وليس ثمّة شيطان مُقيَّض له بحيث يكون قرينه ورفيقه. فما يُستفاد من الآيات القرآنيّة هو أنّ العلاقة بين الشيطان والناس لا تكون بشكل واحد, فبعض الناس يتجسّد الشيطان فيهم بالكامل، وبعضٌ يكونون قرناء الشيطان أي يصبح الشيطان رفيقاً
دائميّاً لهم، أمّا البعض الآخر فلا يوجد شيطان قرين أو مُوَكَّل بهم بشكل مستمرّ، بل إنّ الشياطين التي تطوف وتدور على نحو متواصل تميل عليهم إذا رأت ضالّتها فيهم, وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ وهذا الميل من قِبَل الشيطان على المرء يُمثّل تلك الزلّة التي تنتاب الإنسان في حين من الأحيان. وبمجرّد أن يرتكب أناس كهؤلاء الخطيئة فانّهم ينتبهون إلى قبيح فعلهم، فإذا التفتوا إلى العقاب الذي ينتظرهم جرّاء هذا الفعل فإنّ بصيرتهم تتفتّح: ﴿فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾. يقول عزّ من قائل: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾[286]. إذن هناك تناسب بين الخشية والعلم, فكلّما زاد علم المرء بالله، وبصفاته، وبحكمته، وبأهدافه، ازداد الخوف في قلبه, أي زاد شعوره بالحقارة والضعف في مقابل بارئه والخوف من سقوطه من عين الله عزّ وجلّ. فإذا تنامت هذه الحالة في نفسه كثُر لجوؤه إلى الله تعالى وتضاعف لذلك لطف الله به، فتراه يطوي مراتب الكمال الواحدة تلو الأخرى حتّى يصل إلى أعلاها.
إذن لا بدّ أن يكون خوفكم جدّي, فكثيرون هم الذينيدّعون الخوف من الله ومن عذابه بَيْد أنّ خوفهم لا يتّسم بالجدّية. فالناس في العادة يخشون محن الحياة الدنيا وعذابها وهم لهذا السبب يبذلون قُصارى جهودهم في سبيل الخلاص منها. فإذا كانت خشيتنا من عذاب الله عزّ وجلّ خشية حقيقيّة فلا بدّ أن يكون حذرنا أشدّ. فإذا كان خوف المرء خوفاً جدّياً فهو حتماً سيزيد في بصيرته: “فَيَزْدَادُ بَصِيرَةً وَمَعْرِفَةً لِمَا زِيدَ فِيهِ مِنَ الْخَوْفِ“.
الإنسان المؤمن هو باستمرار في حالة صراع مع نفسه وإنّ الله ناصره في هذا النزال وهو لا يتخلّى عنه بتاتاً. فإن زلّ وسقط أرضاً، فإنّ الله لمعرفته بأنّه من أهل الإيمان وأنّه قد عزم على عدم اقتراف المعصية سيمدّ إليه يده ويُنهِضه ليستأنف النزال من جديد. ففي كلّ مرّة يُصرع فيها أرضاً تزداد قوّته وتتضاعف منعته أمام خصمه حتّى يبلغ حدّاً يستطيع معه الدخول في نطاق ولاية أهل البيت عليهم السلام. فبعد أن أشار إمامنا الباقر عليه السلام إلى تلك الشروط الصعبة، استدرك فذكر هذه الملاحظات كي لا ييأس الآخرون من العثور على سبيل الوصول إلى الكمال المتمثّل بالولاية. فلا ينبغي للإنسان المؤمن أن ينتابه اليأس نتيجة مصارعة النفس أو السقوط أرضاً، بل ينبغي أن تكون عزيمته أكثر رسوخاً، وخوفه أشدّ كي يزيد الله جلّ شأنه في بصيرته. زاد الله تعالى في بصيرتنا أجمعين[287].
الدرس العاشر: الشاكرون
نصّ الوصيّة:
روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر: “يَا جَابِرُ اسْتَكْثِرْ لِنَفْسِكَ مِنَ اللهِ قَلِيلَ الرِّزْقِ تَخَلُّصاً إِلَى الشُّكْرِ، وَاسْتَقْلِلْ مِنْ نَفْسِكَ كَثِيرَ الطَّاعَةِ للهِ إِزْرَاءً عَلَى النَّفْسِ، وَتَعَرُّضاً لِلْعَفْو“[288].
المحاور:
-
مقدّمة
-
أهمّية مسألة الشكر.
-
طريقة الإمام الباقر عليه السلام لإيجاد الدافع للشكر.
-
عليك أن تَعُدّ كافّة آلاء الله عظيمة.
-
المحبوبون عند الله تعالى.
-
روحية استكثار النعمة.
-
الشكر يزيد من النعم.
-
من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
-
أئمة الشكر.
مقدّمة
قيل: الشَّكور أبلغ من الشاكر لأنّ الشاكر هو الذي يشكر على العطاء، والشَّكور هو الذي يشكر على البلاء، وقيل: الشاكر الذي يشكر على الموجود، والشَّكور الذي يشكر على المفقود.
وكلّنا يعلم أنّ الشكر هو واحدة من القيم الأخلاقيّة المهمّة ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾[289]، لكنّ السؤال المطروح هنا هو: كيف يمكن للمرء أن يكون شكوراً وأن يظفر بالدافع إلى الشكر؟ فمن عادتنا جميعاً أن نقول بعد تناول الطعام: “الحمد لله“. هذا العمل وإن اعتُبر شكراً لله وأنّه حسن جدّاً، لكنّه ليس كافياً. فماذا نصنع لنكون أناساً شكورين؟ والإمام الباقر عليه السلام يشير إلى هذه المسألة في موطنين على الأقل من وصيّته لجابر.
أهمّية مسألة الشكر
تحظى مسألة الشكر في النظرة القرآنيّة بأهمّية بالغة. فما يطلبه الله تعالى منّا يفوق بكثير الاكتفاء بقول: “الحمد لله” بعد تناول الطعام. هناك العديد من الكتب التي جُمعت فيها الأحاديث التي تتحدّث عن الصبر والشكر، وهذا دليل على الأهمّية القصوى التي تحظى بها هذه المسألة. إذن علينا أن نفهم أنّ الشكر ليس من المفاهيم العاديّة حتّى ننظر إليه نظرة عابرة.
الملاحظة الأخرى التي تتعلّق بأهمّية مسألة الشكر هي أنّ علماء الكلام وعند خوضهم في المباحث الكلاميّة أو البحث المتّصل بإثبات وجود الله تعالى فإنّهم عادة ما يطرحون هذا السؤال: ما هي ضرورة الخوض في أمثال هذه المباحث؟ إذ أنّ هناك البعض – ونخصّ بالذكر أولئك المنبهرين بالثقافة الغربيّة – ممّن يطرح الشبهة القائلة: ما هي حاجتنا أساساً للتطرّق إلى مسألة: هل يوجد في هذا الكون إله أم لا؟ فإن كنّا ملتزمين بعدم الكذب وعدم الخيانة، وعدم ممارسة الظلم، ونسعى لأن نكون أناساً صالحين، فإن كان يوجد إله فلا بدّ أنّه يحبّ الإنسان الصالح وإن لم يكن فالبحث مضيعة للوقت.
فكيف نستطيع تحفيز الإنسان على البحث في مسألة أصل وجود الله تعالى وصفاته؟ فنحن لا
نستطيع أن نقول لبعضهم: كان الأنبياء يعدّون البحث في هذا الموضوع أمراً واجباً! لأنّه لا يؤمن بنبيّ أساساً. إذن السبيل الوحيد لذلك هو الإفادة من قوّة العقل، فالعقل هو الذي ينبغي أن يحكم بوجوب البحث من أجل معرفة الله. يقول المتكلّمون في هذا الصدد: “إنّ أهمّ دليل عقليّ على وجوب معرفة الله سبحانه هو وجوب شكر الـمُنعِم“. فالعقل يقول: “يتعيّن أن تعرفَ الذي أغدق عليك نعماً جمّة، لأنّه من الضروريّ أن تشكر مَن أنعم عليك“. بمعنى أنّهم يعتبرون هذا الدليل أكثر الأمور التي تُلزِم الإنسان بالسعي لمعرفة الله بديهيّةً. إذن فمسألة الشكر هي على هذا القدر من الأهمّية.
ومع ذلك نرى أنّ الحافز الذي يدفع الناس إلى الشكر ضعيف. فلماذا لا نُقدِّر النعم العظيمة التي أسبغها الله علينا حقّ قدرها؟ ولماذا ينعدم الدافع إلى الشكر لدينا؟ كم مرّة طوال اليوم والليلة نتذكّر أنّه ينبغي علينا أن نشكر الله عزّ وجلّ؟
طريقة الإمام الباقر عليه السلام لإيجاد الدافع للشكر
في هذه الرواية يُقدّم الإمام عليه السلام لجابر طريقة لإيجاد الدافع إلى الشكر عند الإنسان. فهو يشير في حديثه هنا إلى أنّ علّة شحّة شكرنا هي عدم التفاتنا إلى آلاء الله وأنعمه علينا بشكل جيّد. فنحن نتدلّل – بعض الشيء – على الله سبحانه، ونرى أنفسنا مستحقّين وأصحاب حقّ، ونتوقّع منه عزّ وجلّ أن يمنّ علينا بأكثر بكثير ممّا أسبغ علينا إلى الآن من النعم. بل إنّنا أحياناً، وجرّاء وجود بعض النقائص، لا نُعرض عن الشكر فحسب، بل تتولّد لدينا حالة الشكوى والتذمّر أيضاً. إذن يتحتّم علينا أن نبذل غاية المجهود لمعرفة النعم الإلهيّة حقّ المعرفة وأن نفكّر حتّى بنعم الله الصغيرة علينا ونُدرك أهمّيتها. فلا ينبغي استقلال رزق الباري عزّ وجلّ واستكثار أعمالنا. فنحن معاشر البشر نأمل عادةً أن نحوز على ما عند أكثر بني البشر تنعّماً، ونُعاتب الله جلّ وعلا على أن أعطى لفلان نعمةً ولم يُعطني إيّاها. أمّا من جانب آخر فنحن نرى أنّ الأعمال التي نُنجزها نحن جبّارة وقيّمة، ونُحدّث أنفسنا بأنّنا نُصلّي ونصوم ونؤدّي ما أوجبه الله علينا من تكاليف، فما هو المطلوب منّا ونحن نأتي بكل هذه العبادات ؟!
عليك أن تَعُدّ كافّة آلاء الله عظيمة
إذن المشكلة التي نُعاني منها يكمن في هاتين النقطتين, أننا من جهة نرى أنفسنا مستحقين وأصحاب حقّ، ومن جهة ثانية نُعظّم أعمالنا ونراها غير ناقصة. وعلينا هنا كسر هذه المعادلة.
فمن ناحية يتحتّم علينا التفكير بنعم الله الصغيرة, فينبغي لنا – مثلاً – التفكير بما هيّئه الباري عزّ وجلّ من كمّ هائل من الأسباب والوسائل كي يوفّر لنا رغيف خبز واحد. فكما يقول الشاعر:[290]
سُحبٌ، رياحٌ، وأفلاكٌ، وشمسُ ضحىً تعاضدنَ في جلب الرغيف، وتَغفلُ؟!
فلقد وظّف الله سبحانه وتعالى جميع نعم الكون كي تحصل أنت على الرغيف ولا تنتابك الغفلة، وكذلك الحال مع سائر النعم الإلهيّة. فالغفلة – مع بالغ الأسف – تحول دون إدراك المرء لعظمة آلاء الله عزّ وجلّ. فكم قد أسبغ الله علينا من النعم من أجل عمليّة النطق البسيطة؟
فلكي يتفوّه الإنسان ببضع كلمات لا بدّ أن يعمل الجهاز التنفّسي بشكل صحيح في سحب الهواء ودفعه، وينبغي أن يكون للمرء حنجرة وأوتار صوتيّة سالمة، ويجب أن يؤدّي كلّ من اللسان والأسنان والفم وظائفه على النحو الصحيح، وإلاّ فلن نستطيع مهما بذلنا من جهد أن ننطق بكلمة واحدة. في أحد الاجتماعات نقل قائد الثورة المعظّم (حفظه الله) أنّ طبيباً قال له: “أتعلم أنّه لا بدّ أن تتظافر جهود بضعة مليارات من خلايا جسم الإنسان من أجل تحريك إصبع واحد من أصابع يده؟ ولولا هذا التعاون والتنسيق في العمل لا يمكن لهذا الإصبع أن يتحرّك”. فهل فكّرنا إلى الآن كم هي نعمة عظيمة أن نكون قادرين على تحريك إصبع من أصابعنا؟ لذا ننصح الإخوة من الشباب أن تكون لهم بعض المطالعات في علم الفسلجة البشريّة وعلم الأحياء، فهي تعلّم الإنسان الكثير.
المحبوبون عند الله تعالى
على أيّة حال فمن أجل أن يتولّد في أنفسنا دافع إلى الشكر، فنشكر الله شكراً يوصلنا إلى كمال الإنسانيّة ويجعلنا من المحبوبين عند الله جلّ وعلا، فإنّ علينا القيام بأمرين:
1- الوقوف على نعم الله:
علينا أن نحاول جهدنا الوقوف على أنعم الله ونعرفها حقّ معرفتها ونستعظمها. فلا نكوننّ ممّن لا تملأ عيونهم سوى القصور الفارهة وما يُعدّ للطواغيت وفراعنة العصر من شتّى صنوف الطعام والشراب، ولا نرى للطعام الذي نتناوله نحن مقداراً يستحقّ عليه الشكر. فإن أحببنا أن يتولّد في أنفسنا حافزٌ إلى شكر المولى المتعال فيتعيّن أن نُطيل التفكير حتّى في نعم الله الطفيفة علينا والوقوف على أهمّيتها بالنسبة لنا. على أنّ ما ذكرناه لا يتعدّى نطاق النعم الطبيعيّة التي يتنعّم بها
المؤمن والكافر على حدّ سواء، فما بالكم بنعمة العقل، ونعمة هداية الأنبياء، ونعمة معرفة الإسلام، ونعمة ولاية أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام؟ فما كنّا لنصنع لو لم توجد هذه النعم؟
إذن هل من اللائق، مع وجود كلّ هذه الآلاء والنعم، أن نشتكي ونُعاتب الله على بعض النقائص؟! إنّ عملاً كهذا يُسقط الإنسان من أريكة القيم الإنسانيّة. بالطبع إنّ الله عزّ وجلّ يصفح عن الكثير من هذه الأنماط من الكفران وعدم الشكر، لعلمه بضعفنا، أمّا فيما يتعلّق بأولياء الله فإنّهم يُحاسَبون حتّى على صغائر الزلاّت والعثرات ويشاهدون تبعاتها على الفور.
2- استقلال العبادة دائماً:
من ناحية أخرى ومن أجل إيجاد هذا الدافع، علينا أن نرى عباداتنا غاية في الضآلة وقلّة المقدار. بالطبع هذا الأمر أيضاً يحتاج إلى خطّة خاصّة, فكيف لي وقد صُمت لثلاثين يوماً أن اعتبر عملي هذا عديم القيمة؟! وعلى فرض أنّنا نؤدّي صلاة الليل طوال العام، فكيف يتسنّى لنا أن نعدّ هذه العبادة قليلة؟
الاستقلال والاستكثار هنا أمر نسبيّ, بمعنى أنّ المقدار المطلق للشيء ثابت في كلّ حال، لكنّنا عندما نُقارنه بغيره نقول: إنّه قليل أو كثير. فإنّك إذا أردت شراء سلعة قيمتها ألف دينار فدفعت للبائع ثمانمائة دينار فقط، سيقول لك على الفور: هذا قليل, ومعناه: إن ما دفعته ثمناً لهذه السلعة هو قليل بالقياس إلى القيمة الحقيقيّة لها، لا أنّ الثمانمائة دينار قليلة بذاتها. فإن علمنا كم أنّ الله سبحانه وتعالى متفضّل علينا، فإنّنا سنعتبر عباداتنا قليلة حتّى وإن قضينا العمر بأكمله في عبادته.
عندما عوتب الإمام زين العابدين عليه السلام على كثرة عبادته وبكائه بين يدي الله مع أنّ الله قد جعله في عداد المعصومين، قال عليه السلام: “من يقدر على عبادة عليّ بن أبي طالب عليه السلام”[291], فقد استقلّ عبادته عندما قاسها بعبادة جدّه عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
فمن أجل أن نستقلّ عباداتنا فما علينا إلاّ أن نقيسها بطاعة عباد الله الصالحين المخلَصين من حيث الكمّ والكيف وعندها سنخجل من أنفسنا. فلو أراد المرء أن يُقدّم فاكهة لأحدهم كهديّة فهل سيقدّمها بكلّ راحة بال ومن دون أدنى خجل إذا كان ما يقرب من تسعين بالمائة من هذه الفاكهة فاسداً ومتعفّناً؟ فإذا كنّا لا نلتفت إلاّ إلى عشرة بالمائة من صلواتنا فهي كالهديّة التي فسد تسعون بالمائة منها، ألا ينبغي لنا والحال هذه أن نُقدّمها بين بدي الباري عزّ وجلّ بمنتهى الخجل والحياء؟!
إذن فمن أجل إيجاد الدافع إلى الشكر أوّلاً، وبغية التمكّن من تأدية شكر الله تعالى ثانياً علينا من جانب أن نُطيل التفكير والتأمّل بأهمّية وكثرة ما يغدق علينا تعالى من رزق ونعم جمّة، ولا بدّ من جانب آخر أن نَعدّ ما نأتي به من العبادات قليلاً وناقصاً.
روحية استكثار النعمة
ومن هذا المنطلق يقول الإمام الباقر عليه السلام: “يا جابر! استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلّصاً إلى الشكر، واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراءً على النفس وتعرُّضاً للعفو“[292], أي: استكثر ما يُعطيك الله تعالى من رزق قليل. ولا يعني هذا أن تعدّ رغيف الخبز الواحد مائة رغيف! فهذا الكلام يدعو إلى السخرية. فقوله: “استكثر” يعني: انظر كم أسبغ الله عليك من النعم على الرغم من عدم استحقاقك وشحّة نفسك. “وَاسْتَقْلِلْ مِنْ نَفْسِكَ كَثِيرَ الطَّاعَةِ للهِ إِزْرَاءً عَلَى النَّفْسِ”[293], ومن ناحية أخرى استقلل ما تؤدّيه من العبادة والطاعة! فأيّ قيمة ومقدار لهذه العبادة في مقابل ما أغدقه الله عليك من عظيم النعم، وما يؤدّيه أولياؤه بين يديه من جسيم الطاعة. فلنقارن آلاء الباري علينا بعدم أهليّتنا وكثرة معاصينا كي نراها جسيمة ضخمة, ولنستقلل عباداتنا من الناحية الأخرى, ذلك أنّ النفس تُحبّ أن يكون لها شأن ومنزلة وعلينا مقارعتها وقمعها. يقول إمامنا عليه السلام في هذا الصدد: “من أجل قمع أنفسكم قولوا لها: هذه العبادات لا قيمة لها”, ذلك أنّ مقدارها بالقياس لطاعات أولياء الله قليل أوّلاً، ولا يعلم أنّها ستقبل أم لا ثانياً. إنّه ليتعيّن الاستغفار من العبادة المأتيّ بها من دون حضور قلب فما بالكم بأن نوليها أهمّية ونعطيها قيمة!
هذه الطريقة هي السبيل الذي يمكننا بسلوكه أن نحظى بالدافع إلى الشكر ونكون في عداد الشاكرين: “تخلُّصاً إلى الشكر”، وأن نتغلّب على النفس، ولا ندعها تنتصر علينا وتصرعنا.
الشكر يزيد من النعم
الله عزّ وجلّ، ولكي يحثّنا على الشكر وجني جزيل ثماره وعظيم نتائجه، فقد اعتمد أساليب أخرى من جملتها الوعد بزيادة الرزق عند الشكر، والإنذار – في المقابل – بزوال النعمة في حال عدمه. فهو يشير في ختام العبارة المذكورة أيضاً إلى نقطتين مهمّتين: “واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر“, أي: إذا شئت نيل المزيد من النعم فأكثِر من الشكر، وليكن شكراً عظيماً أيضاً.
ومن أجل أن تُوفَّق إلى تأدية عظيم الشكر عليك أن تُفكّر في أنّك إن لم تشكر فستزول منك النعم. وهذان العاملان يُعَدّان من أكبر العناصر المحفّزة للإنسان, فكلّ امرئ يسعى لنيل المزيد من النعم، وهذا يدلّنا على أنّ الازدياد في النعم هو من الأمور التي تحظى بقيمة عظمى لدى الإنسان. وعلى العكس، فإنّ شحّة النعم يُعتبر بلاء عظيماً له. إذن فالالتفات إلى هاتين النقطتين يحثّنا على شكر الله تعالى بما يستحقّه من الشكر. وبالطبع فإنّ الله ليس بحاجة لشكرنا، وإنّ سرّ إصراره على هذه المسألة هو رغبته جلّ وعلا في أن ينالنا نحن النفعُ من ذلك[294].
من لم يشكر الناس لم يشكر الله
من المعلوم أن من أعظم الأعمال التي يشكر به العبد ربّه سبحانه وتعالى عند تجدّد النعم أو اندفاع النقم أن يخرّ لله ساجداً، فيضع أشرف عضو من أعضاء جسده – وهو الوجه – على التراب وينكس جوارحه خاضعاً متذلِّلاً لله تعالى شاكراً له على هذه النعم، ويذكره في هذا السجود وهو على هذه الحال بأنواع الذكر من الشكر والمحامد والاستغفار وغيرها، فيكون العبد قد عمل عملاً شكر به المنعم جل وعلا من خلال هذا السجود وأشغل قلبه ولسانه وجوارحه بذكر المنعِم جلّ شأنه.
قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾[295] لأن المتلفِّظين بالحمد كثيرون، والعاملين بالشكر قليلون، فإنّ الله تعالى يقول: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾[296] ويقول سبحانه: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾[297]، واعلموا أيّها الأحبّة أنّ الله تعالى لمّا جعل الشكر من عباده أساسَ عبادته المباشرة، جعل أيضاً شكرهم لبعضهم عبادة له تزيد من أجرهم، فقد أمر سبحانه العبد أن يشكر لوالديه: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾[298] فشكر الله عبادته، وشكْرُ الوالدين برُّهُما، بل فاض أمر الشكر حتى زاد عن الوالدين إلى التعامل مع كل الناس، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: “من لم يشكر الناس لم يشكر الله“[299].
وروي عن إمامنا الرّضا عليه السلام أنه قال: “من لم يشكر المنعِم من المخلوقين، لم يشكر الله
عزَّ وجلّ“[300] وشكر الناس أن تُقابل إحسانهم بمثله، إن كان قولة أو فعلة، لأن مبدأ الشكر الاعتراف بالفضل لأهله، فإن وجد ذلك كان لله ثم لعباده، وإن عُدِم فليس لله ولا لعباده، ومعلوم من غير توضيح أن شكر الوالدين وشكر الناس جزء من شكره سبحانه وحده.
أئمة الشكر
إنّ المتأمِّل في آيات القرآن الكريم يجد أنّ الله تعالى صرّح بالثناء على صفوة خلقه أولي العزم من الرسل عليهم السلام بأنّهم كانوا من الشاكرين، فوصف نبيه نوحاً عليه السلام بأنّه ﴿كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾[301]. ونعت خليله إبراهيم عليه السلام بأنّه كان: ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ﴾[302]. وقال لكلٍّ من الكليم موسى والمصطفى محمد صلوات الله عليهما: ﴿وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾[303]، وقد كانا.
وهذا النبي الشاكر، والأوّاب الذاكر: سليمان بن داود عليهما السلام، والذي حفظ القرآن له أكثر من موقف عبّر فيه عن شكره لنعم ربّه، وبيّن أنّ فرحة اكتمال النعمة، وتمام الأمنية لم تُلهيه عن اللهج بالاعتراف بها لمسديها، وشكره عليها، استوقفته تلك النملة حين نذارتها لقومها: ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾[304].. تأمّل كيف لم تشغله تلك النعمة عن التوجّه إلى من أنعم عليه بها، بل حرّك فيه هذا المشهد الرغبة في الشكر لمستحقّه، فهو الذي علّمه ما علّمه، ويتكرّر مشهد الشكر عند هذا النبي الكريم، لمّا رأى عرش بلقيس مستقرّاً عنده ـ فيقول: ﴿هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾[305].
إنّه حال الشاكرين، فسليمان – عليه الصلاة والسلام – لم تشغله – هذه الآية العظيمة، وهي: حضور عرش بلقيس بسرعةٍ هي أقل من طرفة العين – عن شكر من أنعم عليه بذلك، بل لهج بالثناء والحمد لله تعالى. فإذا كان هذا حال أنبياء الله تعالى ورسله، فغيرهم أحوج إلى أن يكون. الحمد والشكر لله. شعاراً لهم ودثاراً، فإنّ الأمر كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: “النعمة موصولة
بالشكر، والشكر موصول بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله سبحانه حتى ينقطع الشكر من الشاكر“[306].
وفي مقدمة الشاكرين وإمامهم، سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلّم، وذلك لأنه أتقى الخلق، وأعرفهم بحقّ خالقه، وأشكرهم له. ويظهر ذلك جليًا من خلال النظر في حاله وسيرته مع أهل بيته عليهم السلام، وأزواجه وأصحابه، وعامة من رآه أو أتاه.
روي عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليه السلام: – في حادثة طويلة ومفصَّلة – عن أمير المؤمنين عليهما السلام في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: “إنه كان إذا قام إلى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيز كأزيز المرجل على الأثافي من شدّة البكاء، وقد أمنه الله عزّ وجلّ من عقابه، فأراد أن يتخشّع لربّه ببكائه، ويكون إماماً لمن اقتدى به، ولقد قام عليه وآله السلام عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورّمت قدماه واصفرّ وجهه، يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك فقال الله عزّ وجلّ ﴿طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾[307]. بل لتسعد به، ولقد كان يبكي حتى يغشى عليه، فقيل له: يا رسول الله أليس الله عزّ وجلّ قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ؟ قال: بلى أفلا أكون عبداً شكوراً”[308].
لو كلُّ جارحةٍ منِّي لها لغةٌ تُثْنِي عليك بِما أولَيْتَ مِن حَسَنِ
لكان ما زاد شُكْري إذْ شَكَرْتُ به إليك أبلغَ في الإحسانِ والْمِنَن
أما الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، فإنّهم هم الذين سيشكرون من ربّهم في الآخرة بالأجر الذي سيظلّون أبداً يحمدونه من أجله. عندما يقول لهم سبحانه بعد أن يستقرّوا في نعيمهم: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾[309]. ويستأنف الشكر لهم من الله بسخاء عطائه جلّ شأنه: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾[310].
جعلنا الله وإياكم من السائرين بركبهم في الدنيا والآخرة، ومن الذين يقرنون الشكر بالعمل كما أمروا عليهم السلام، وفّقنا الله وإيّاكم لأن نكون من الشاكرين، فلعلّنا برحمته نكون يوم القيامة من الحامدين.
الدرس الحادي عشر: للعلم طالبون
نصّ الوصيّة:
روي عن الإمام الباقر عليه السلام في وصية لتلميذه وصاحبه جابر: “وَادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ حَاضِرَ الشَّرِّ بِحَاضِرِ الْعِلْمِ، وَاسْتَعْمِلْ حَاضِرَ الْعِلْمِ بِخَالِصِ الْعَمَلِ، وَتَحَرَّزْ فِي خَالِصِ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيمِ الْغَفْلَةِ بِشِدَّةِ التَّيَقُّظِ، وَاسْتَجْلِبْ شِدَّةَ التَّيَقُّظِ بِصِدْقِ الْخَوْفِ”[311].
المحاور:
-
مقدّمة.
-
فضل أهل العلم.
-
العلم لمن علم ثم عمل.
-
خطّة للعمل بالعلم.
-
الغفلة آفة الإخلاص.
-
كيف نقوّي دعائم اليقظة في نفوسنا؟
-
احذر: فقدان الخوف الصادق من الله.
-
واتقوا الله ويُعلِّمكم الله.
مقدّمة
ما أمر الله تعالى نبيّه الخاتم ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم بطلب الزيادة من شيء في هذه الدنيا، إلا من العلم، فقال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾[312]. وكان من نتاج علم الله الذي علّمه مصطفاه أن خاطب الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾[313]. فالذكر في هذه الآية المباركة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، والله تعالى يقول: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[314]. ووصف مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الأئمة الطاهرين من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم، فقال: “هم عيش العلم وموت الجهل، يُخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحقّ إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية. لا عقل سماع ورواية، فإنّ رواة العلم كثير ورعاته قليل“[315]. هؤلاء أئمّتنا الكرام عليهم السلام أبرار عترة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم وأطائب أرومته، أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً.
فَتَشَبّهوا إِن لَم تَكُونوا مِثلَهُم إِنَّ التَّشَبّه بِالكِرامِ فَلاحُ.
فضل أهل العلم
لقد أشاد الله سبحانه وتعالى – أيّما إشادة – بفضل أهل العلم، ورفع من شأنهم، وأعلى من قدرهم، بما يعجز عن بيانه إلا الفرقان المبين، فقال الله تعالى في محكم آياته: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾[316]، وقال سبحانه: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[317]، وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾[318]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[319].
روى أبو بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: “كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم إنّ العلم ذو فضائل كثيرة: فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقرّه النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبّة الأخيار“[320].
خطّة للعمل بالعلم
يتابع الإمام الباقر عليه السلام وصيّته لجابر فيقول: “وَادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ حَاضِرَ الشَّرِّ بِحَاضِرِ الْعِلْمِ، وَاسْتَعْمِلْ حَاضِرَ الْعِلْمِ بِخَالِصِ الْعَمَلِ، وَتَحَرَّزْ فِي خَالِصِ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيمِ الْغَفْلَةِ بِشِدَّةِ التَّيَقُّظِ، وَاسْتَجْلِبْ شِدَّةَ التَّيَقُّظِ بِصِدْقِ الْخَوْفِ”[321].
الإمام عليه السلام يُركّز في هذه الوصايا الأخيرة على نقطة جوهريّة وهي: أنّك إذا استثمرت ما هو بحوزتك في الوقت الحاضر فستحصل على النتيجة المطلوبة, فإنّ خفتَ من أن يُصيبك شرّ فاستخدم ما في جعبتك من علم, أي حاول أن تحسن العمل بما تعلم. فعمل الإنسان عن رياء وعُجب وتظاهر وما إلى ذلك ليس هو عملاً بما يعلم، بل هو عمل مخالف للعلم, ذلك أنّ العلم يقول له: لا بدّ أن يكون عملك خالصاً. ومن أجل أن تكون قادراً على الإخلاص في عملك فاسْعَ أن تكون يقظاً تمام اليقظة في جوف الليل، وأن تتجنّب الغفلة لأنّ الغفلة تقود إلى الرياء في العمل. وبغية الحفاظ على حالة اليقظة فإنّ عليك أن تجتهد في أن يكون خوفك خوفاً صادقاً.
وقد خاطب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام طلبة العلم محذِّراً لهم: “يا حملة العلم أتحملونه فإنما العلم لمن علم ثم عمل ووافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تُخالف سريرتهم علانيتهم، ويُخالف عملهم علمهم يقعدون حلقاً، فيُباهي بعضهم بعضاً حتى إنّ الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله سبحانه“[322].
لأنّ المهام الملقاة على عاتق طلبة العلم مهام عظيمة ويناط بهم مسؤوليات جليلة كان هذا التحذير من أمير المؤمنين عليه السلام، ولأن طلب العلم جمع الله فيه بين الفضلين: فضله على النفس وفضله للغير، ولذلك فإنّ طلب العلم أفضل من صنائع المعروف لأنّه أشرفها وأعظمها وأعلاها، وأجزلها ثواباً عند الله تعالى, فأعظم المعروف أن تأخذ بحجز القلوب عن النار، وأعظم المعروف أن تُقرِّب العباد إلى رحمة الله، فأبشر بخير ما أنت فيه من طلب العلم، ففيه خير كثير إذا اقترن بالعمل. قال باب مدينة العلم وكهف الحلم عليه السلام: “اطلبوا العلم تُعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله”[323]. وقال الإمام الصادق عليه السلام: “من عمل بما علم كفي ما لم يعلم“[324].
اغتنم ما تعلم!
نحن غالباً ما نسعى إلى اكتشاف السبيل التي تؤمّن لنا سعادتنا وكمالنا، ونظنّ أنّ اكتشاف سبيل كهذه هو بمثابة وصفة سحريّة وسرّ خفيّ علينا التجوال في أقطار العالم وأكنافه كي نعثر على خبير يعرف كيف يُحرّر لنا هذه الوصفة الفريدة. لكنّ تفكيرنا بهذه الطريقة يدفعنا إلى التقاعس عن التوجّه نحو قمّة الكمال والقناعة بما أصبناه وما هو متوفّر بأيدينا. فهمّة المرء تقضي في بداية الطريق أن ينال المقامات العالية، لكنّه عندما يشاهد أنّ الأمر ليس بالسهولة التي يتصوّر فإنّه يتراجع شيئاً فشيئاً حتّى يصرف نظره عن الأمر كلّياً.
ومن أجل إلغاء هذا النمط من التفكير سعت الروايات إلى التأكيد على عدم تكثيف المساعي في كثرة طلب العلم, بل أن يُركِّز الإنسان سعيه في العمل بالمقدار الذي لديه من علم. يقول النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم في هذا المجال: “مَن عمل بما يعلم وَرّثه الله علمَ ما لم يعلم“[325]، إذن فالمهمّ هو أن يستفيد المرء ممّا بحوزته من العلم قبل أن يذهب إلى طلب غيره. بالطبع إنّ المراد من العلم هنا هو العلوم التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأعمال العباديّة وطاعة الله عزّ وجلّ.
فنحن نُحبّ أن نعلم كلّ شيء, نودّ أن نعلم كيف وصل الأئمّة عليهم السلام وأولياء الله المقرّبون إلى ما وصلوا اليه من مقامات عالية؟ وما هي سلسلة المقامات والسبيل الموصلة إليه؟ فهذا هو حبّ الاستطلاع الذي غرسه الله تعالى في قلوب البشر وهو عامل مهمّ في دفع الإنسان إلى طلب العلم. لكنّ الأفضل من ذلك هو أن يعمل المرء بما تعلّمه. فشكر العلم يكون في العمل به. ألسنا نرغب في
أن نقوم بما يجعلنا نشكر الله شكراً عظيماً كي يزيدنا من نعمه؟ فهذه الالتفاتة تُمثّل بحدّ ذاتها علماً من العلوم وإنّ شكرها يكون في العمل بموجبها.
الغفلة آفة الإخلاص
لكن كيف السبيل إلى إخلاص العمل؟ فلو وقف العبد وحيداً في مسجد أو صحراء يعبد ربّه من دون أن يراه أحد لما وجد في نفسه ما يُحرّضه على الرياء، فالدافع للرياء لا يتولّد لدى المرء إلاّ إذا علم بأنّ شخصاً يراقب عمله, لأنّ “الرياء” يعني إظهار العمل للآخرين. فإذا تولّد في نفس المرء حافز على الرياء فستراه يُحدّث نفسه: “إذا قمت بعملي بالكيفيّة التي تُرضي فلاناً من الناس فإنّني سأحظى بمكانة مرموقة عنده وأقطف ثمار هذه المكانة. إذن من الأفضل أن أُصلّي صلاة لائقة أمامه”! غافلاً عن أنّ هذه النيّة تُبطل صلاته, فلقد أغفَلَ ربّه إرضاءً للناس، وهذا من موجبات سخط الباري عزّ وجلّ.
إنّ ما يوجب خروج العمل عن حالة الإخلاص هو الغفلة عن مقام المعبود ولوازم ذلك المقام. فأوّل أثر للنيّة المشوبة هو ذهاب العبادة، بل وقد يُسجَّل له ذنب في صحيفة أعماله أيضاً. إذن فمن أجل أن يُصبح عملنا خالصاً يتعيّن علينا المحافظة على هذه اليقظة حتّى لا تعرض الغفلة علينا.
ومن أجل حفظ هذه اليقظة فإنّ علينا الالتفات دوماً إلى هذه النقطة وهي: مَن هو الذي نتعامل معه؟ يجب أن نتنبّه باستمرار إلى أنّ تعاملنا هو مع الله سبحانه، وأنّ خلقه لا يقدرون على فعل أيّ شيء لنا: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ﴾[326]، إذن فما الذي يدفعني إلى التفكير بالناس والتظاهر أمامهم بالعبادة والزهد والتقوى؟! ينبغي لهذه القضيّة أن تكون حاضرة في أذهاننا دائماً. بالطبع إنّه عمل شاقّ ويحتاج إلى تمرين متواصل، ونادراً ما يُكلّل بالنجاح، فمشاغل الدنيا تجرّ الإنسان إلى الغفلة بين الفينة والأخرى. لكنّنا إذا تمكنّا من تقوية الخوف من الله في نفوسنا وجعله خوفاً صادقاً فإنّنا سننجو من الرياء والغفلة.
كيف نقوّي دعائم اليقظة في نفوسنا؟
المشكلة الأساس في الموضوع أنّ خوفنا من الله لا يتّصف بالعمق، فهو لا يتعدّى كونه ادّعاءً سطحيّاً. فعندما يكون خوف المرء من أمرٍ مّا جدّياً تراه يتوخّى الحذر الشديد لئلاّ يُبتلى به. فلو قيل: هناك في الطريق سلك كهربائيّ مجرّد من غلافه ملقىً على الأرض وهو موصول بالكهرباء ومن وَطَأه سيُصعَق، فسوف يتّخذ الجميع جانب الحيطة والحذر حتّى وإن كان احتمال كونه مكهرباً
واحداً بالمائة فقط، حذراً من الإصابة بالصعقة الكهربائيّة. فإذا كان المرء يخاف من جهنّم ومن سقوطه من عين الله تعالى بقدر خوفه من سلك الكهرباء فسوف يكون يقظاً باستمرار كي لا يأتي بما يثير غضب الباري جلّ وعلا وسخطه عليه.
يقول الإمام عليه السلام, إذا أردت المحافظة على هذه اليقظة في سبيل عدم الابتلاء بالرياء والتحايل وطلب السمعة وكلّ ما يبطل العبادة فلا بدّ أن يكون خوفك خوفاً صادقاً.
وهنا يتبادر السؤال التالي إلى الذهن: كيف نجعل خوفنا صادقاً؟ وللإجابة على هذا السؤال يتعيّن الالتفات إلى قضيّة أنّه من أجل القيام بأيّ فعل فإنّنا نحن مَن ينبغي أن يُقرّر القيام به، ومن ثمّ نُقدِم عليه بإرادتنا بعد التفكير والتأمّل. فإنّ عرْضَ خطّة للطريق لا يعني أنّ العمل سيُنجَز وينتهي كلّ شيء، بل إنّ تقديم الخطّة هو من أجل الإرشاد إلى الطريق الصحيح وتبيين مراحله كي يتمكّن المرء من التقدّم إلى المرحلة التالية بسهولة أكبر، أمّا الذي يتّخذ القرار ويُقدِم على العمل للحصول على نتائجه فهو الإنسان نفسه: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾[327].
1- تقوية عامل الخوف من الله:
فمن أجل صيانة هذه اليقظة علينا تقوية الخوف في أنفسنا، وإطالة التفكير في كلام الله تعالى وفي أنّه: هل هذه الصورة التي ترسمها الآيات القرآنيّة عن عاقبة أهل المعصية جدّية؟ فابن آدم دائماً يُرجّح دفع الضرر على استجلاب النفع. فلو دار الأمر بين أن يدفع عن نفسه مرضاً عضالاً وبين أن يحظى بجسم رشيق وجميل فهو سيرجّح دفع الضرر. فدفع الضرر هو من أهمّ العوامل المؤثّرة في أفعالنا الاختياريّة. وحتّى القرآن الكريم فإنّه يختار لأنبياء الله تعالى صفة المنذِرين, حينما يقول: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا﴾[328] أو: ﴿لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾[329]. فصحيح أنّ الأنبياء عليهم السلام كانوا مبشِّرين ومنذِرين في آن معاً، لكنّ صفة “المنذِر” قد أُطلقت عليهم بشكل مطلق، خلافاً لصفة “البشير” فهي لم تكن صفة مطلقة لهم, ذلك أنّ تأثير الإنذار في عمل المرء يفوق تأثير أيّ شيء آخر. طبعاً قد يُقدِم الإنسان على تعريض نفسه لضرر بسيط من أجل خير ونفع أعظم، لكنّه إذا تساوى عنده الضرر والنفع فإنّه يُفضّل دفع الضرر على جلب النفع. ولا يتحقّق دفع الضرر إلاّ إذا خاف المرء من شيء مّا وعندها فقط سيسعى إلى دفع ضرره عنه، فإن لم يشعر بالخوف منه فإنّه لا يحاول دفع ضرره, فلو لم يخش الإنسان المرضَ فإنّه لن يُراعي لوازم الصحّة والسلامة وسوف يُبتلى بالمرض لا محالة.
2- التفكُّر في عواقب الأمور:
الخطوة الأولى كما ذكرنا تكمن في السعي لتحصيل الخوف الصادق. أمّا السبيل إلى هذا الخوف فهو التفكّر في كلمات القرآن الكريم وتعابير الروايات الشريفة التي تُذكِّر بما للذنوب والسلوكيّات المنحرفة من تبعات سوء، ومحاولة تجسيد هذه التبعات أمام أنظارنا ولو قليلاً. فهذا النمط من الخوف يبعث على تيقّظ الإنسان وعدم غفلته، وإنّ عدم الغفلة يدفعه إلى الإخلاص في عمله، والإنسان المخلِص يستفيد من علمه على نحو أفضل ويؤدّي شكر هذا العلم، وحينئذ سيزيد الله في علمه، وهكذا تتواصل هذه السلسلة, بمعنى أنّه: كلّما عمل بما لديه من المعلومات ازداد علمه. وإنّ العلم الأكثر يقتضي عملاً أكثر وأفضل، وهكذا تستمرّ هذه العجلة في الدوران حتّى يصل المرء إلى مقامات القرب من الله عزّ وجلّ.
ومن هذا المنطلق يقول الإمام أبو جعفر عليه السلام: “وَادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ حَاضِرَ الشَّرِّ بِحَاضِرِ الْعِلْمِ، وَاسْتَعْمِلْ حَاضِرَ الْعِلْمِ بِخَالِصِ الْعَمَلِ، وَتَحَرَّزْ فِي خَالِصِ الْعَمَلِ مِنْ عَظِيمِ الْغَفْلَةِ بِشِدَّةِ التَّيَقُّظِ، وَاسْتَجْلِبْ شِدَّةَ التَّيَقُّظِ بِصِدْقِ الْخَوْفِ”[330]. ولعلّ التأكيد هنا على كلمة “حاضر” هو من أجل أن لا يظنّ الإنسان أنّ عليه الجدّ والمثابرة لسنوات طوال من أجل طلب العلم وعند ذاك فقط يمكنه العمل بهذا العلم، بل إنّه إذا استفاد من نفس هذا العلم الذي بحوزته في الوقت الحاضر فإنّه سيدفع الشرّ عنه.
وعليه: فإنّ الإفادة من العلم هي أن تعمل به بكلّ إخلاص، وإنّ ما يبعث على تبدّد الإخلاص هي الغفلة. فبغية صيانة النفس من الغفلة ينبغي للمرء الاجتهاد في أن يكون في حالة يقظة تامّة، أمّا المفتاح لهذه اليقظة التامّة والمستمرّة، فهو الخوف الصادق. فلابدّ أن تصدّق بما جاء في الآيات والروايات من ذكر أشكال العذاب كي تستثير هذه اليقظة في نفسك. لكنّك إن لم تحمل هذا الأمر على محمل الجدّ فستصاب بالغفلة وستُبتلى في إثرها بالرياء أيضاً.
احذر: فقدان الخوف الصادق من الله ومن ثمّ يأتي الإمام عليه السلام بعبارة يكتنفها بعض الغموض، الذي قد يكون بسبب خطأ حصل في النسخ، وهي: “وَاحْذَرْ خَفِيَّ التَّزَيُّنِ[331] بِحَاضِرِ الْحَيَاةِ”[332].
الإمام الباقر عليه السلام يشير هنا استكمالاً لموضوع الخوف الصادق إلى آفة هذا النمط من الخوف. فإنّ من الأمور التي تجعل المرء لا يحمل ألوان الإنذار على محمل الجدّ هي معاشرة محبّي الدنيا. فإنّ
معاشرة أولئك الذين لا يفتؤون يتحدّثون عن ملذّات الدنيا، وعن صعود أسعار المادّيات ونزولها، وعن الأفلام، وما شابه ذلك ولا ينقطعون عن التفكير في التزيّن بزينة الدنيا وزخارفها هي من العوامل التي تُخلّي قلب الإنسان من الخوف، فلا يصبح بعد ذلك من أولئك الذين تضطرب وترتعش قلوبهم لذكر الله عزّ وجلّ، بل قد يبلغ مرحلة لا يُحبّ معها سماع اسم الباري المتعال! فجملة: “وَاحْذَرْ خَفِيَّ التَّزَيُّنِ” تعني: احذر ممّن همّته التزيّن بالحياة الدنيا. فمعاشرة أمثال هؤلاء تبعث على فقدان الخوف الصادق وإزالة التيقّظ من قلب الإنسان، والله العالم. وفّقنا الله وإيّاكم إن شاء الله[333].
واتقوا الله ويعلِّمكم الله
يقول الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ﴾[334]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾[335]. روي عن عنوان البصري – وكان شيخاً كبيراً قد أتى عليه أربع وتسعون سنة – ذكر أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال له: “ليس العلم بالتعلُّم، إنّما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه“[336].
وبهذا يُعلم أنّ العلم ليس هو مجرّد استحضار المعلومات الخاصة، وإن كانت هي العلم في العرف العامي، وإنّما هو النور المذكور الناشئ من ذلك العلم الموجب للبصيرة والخشيه لله تعالى[337]. فالهداية بالإيمان وزيادة الهدى، من قِبَل الله سبحانه، إنّما هما عمل غيبي، وتصرّف إلهي، والتعليم لا ينحصر بالكلمة وبالفعل الذي ترد فيه الاحتمالات فقط. قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ﴾[338]، وقال عزّ وجلّ: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾[339]، وقال تعالى: ﴿…وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾[340]، فهنيئاً للعلماء الذين كانوا قدوة بالأفعال مثل ما كانوا قدوة بالأقوال، لأنّ النفوس إلى الاقتداء بالفعال أسرع منها إلى الاقتداء بالقوال.
الدرس الثاني عشر: للهوى غالبون
نصّ الوصيّة:
عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لتلميذه وصاحبه جابر: “وَتَوَقَّ مُجَازَفَةَ الْهَوَى بِدَلالَةِ الْعَقْلِ، وَقِفْ عِنْدَ غَلَبَةِ الْهَوَى بِاسْتِرْشَاءِ الْعِلْمِ، وَاسْتَبْقِ خَالِصَ الأَعْمَالِ لِيَوْمِ الْجَزَاء”[341].
المحاور:
-
مقدّمة.
-
المراد من صراع الإنسان مع نفسه.
-
الفارق الأساس بين النفس والعقل.
-
التغلُّب على النفس بتقوية العقل والعلم.
-
العقيدة الصحيحة أساس الأخلاق الكريمة.
-
الإخلاص غاية الدين والإيمان.
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله