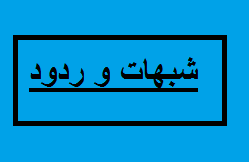أوائل المقالات في المذاهب والمختارات / الصفحات: ٢٨١ – ٣٠٠
(١٠) قوله في القول ٢: (وساقها إلى الرضا علي بن موسى (ع)).
أقول: لا خلاف بين المتكلمين في أن اصطلاح (الإمامية) لا يطلق إلا على القائلين بإمامة الأئمة الاثنا عشر فيتحد معناها مع (الاثنا عشرية)، ويدل عليه من كلام الشيخ المفيد قده ما يأتي في القول الثالث من قوله: (واتفقت الإمامية على إن الأئمة بعد الرسول اثنا عشر إماما…). وحينئذ فلماذا لم يقل (وساقها إلى الإمام الثاني عشر) بل قال (وساقها إلى الرضا علي ابن موسى (ع))؟
الظاهر أنه قده كان في مقام تمييز الإمامية عن بقية فرق الشيعة بالتركيز على نفس مورد الاختلاف، وحيث أن آخر الفرق التي افترقت عن الإمامية هي الواقفة الذين وقفوا على موسى بن جعفر (ع)، وأنكروا إمامة علي بن موسى (ع)، كان ذكره (ع) – مضافا إلى إفادته ما يفيده ذكر الإمام الثاني عشر في المقام – تحديدا على آخر من ينتهى إليه افتراق الفرق المنحرفة للشيعة، وإشارة إلى عدم حدوث فرقة أخرى يعتد بها بعد الواقفة.
وأما ما ذكر المتكلمون ومنهم النوبختي من الفرق الحادثة في زمن العسكريين (ع) فمضافا إلى ما ذكرنا في محله – من عدم ثبوت أصل وجود أكثرها، وعدم كون بعضها مذهبا وفرقة بل كلاما صدر من أحد فعدها بعضهم
(١١) قوله في القول ٢: (لأنه وإن كان في الأصل علما على من دان من الأصول بما ذكرناه دون التخصيص لمن قال في الأعيان بما وصفنا…).
أقول: الضمير في (لأنه) راجع إلى الوصف بالإمامية والمراد (بما ذكرناه) وجوب الإمامة ووجودها في كل زمان والعصمة والكمال والمراد بقوله (في الأعيان) أشخاص الأئمة الاثنا عشر على التعيين.
وحاصل المعنى: إن الوصف بالإمامية بمقتضى التفسير اللفظي مع قطع النظر عن الظهور العرفي والاصطلاحي كان مقتضاه إطلاقه على كل من اعتقد في الإمام الشرائط والأوصاف المذكورة، ولكنه صار من جهة العرف و الاصطلاح علما على من اعتقد بالأوصاف المذكورة في خصوص الأئمة الاثنا عشر دون غيرهم.
(١٢) قوله في القول ٢ (لاستحقاق فرق من معتقديه ألقابا بأحاديث لهم بأقاويل أحدثواها…).
الظاهر أن كلمة (بأحاديث) تصحيف (بأحداث) وعلى التقديرين فالمعنى المراد بها البدع والآراء الشاذة التي تحدث فيما بين الشيعة ولا تصل إلى حد الخروج عن التشيع ولكنها تخرجهم عن التسمية بالامامية.
فالمعنى: إنما خصصنا الإمامية بمن ذكرناه، لأن بعض معتقديه أحدثوا بدعا وأقوالا خرجوا بسببها عن استحقاق لقب الإمامية، إلى استحقاق ألقاب
(١٣) قوله في القول ٣ (وجوزوا أن يكون الأئمة عصاة في الباطن)
راجع شرح المواقف ج ٨ ص ٣٠١ ومقالات الاسلاميين ج ٢ ص ١٢٥.
(١٤) قوله (البترية)
الظاهر كما مر في القول الأول أنه لا توجد فرقة من الزيدية تنكر النص الخفي على أمير المؤمنين وكونه أولى بالخلافة من غيره، غاية الأمر البترية تدعي أن تسليمه (ع) حقه لأبي بكر تصحح خلافته والباقون لا يقولون به. راجع الحور العين ص ١٥٥ فإن مؤلفه من البترية.
(١٥) قوله في القول ٣ (وجوزوا خلو الأزمان)
راجع مقالات الاسلاميين للأشعري ج ٢ ص ١٣٤ – والمغني للقاضي ج ٢٠ الجزء الأول ص ١٧ إلى ص ٤٥ وشرح المواقف ص ٣٤٥.
(١٦) قوله في القول ٣ (من جهة البرهان الجلي والسمع المرضي والقياس العقلي…)
راجع من جهة القياس العقلي والبرهان الجلي إلى كتبه قده في الإمامة منها الافصاح في الإمامة والشافي للسيد المرتضى وتلخيصه للشيخ الطوسي و كتب العلامة وغيرها.
وكذلك النصوص من القرآن والحديث لم يرد في حق أحد ما يكون متفقا عليه بين الشيعة والسنة وجميع الفرق مثل ما ورد فيه عليه السلام.
وكذلك الإجماع على الإمامة، نعم إن أريد به إجماع فرقة خاصة واتباع شخص خاص فكل حزب بما لديهم فرحون وكلهم يدعون الإجماع على معتقداتهم، وأما إجماع جميع المسلمين من سني أشعري أو معتزلي أو ظاهري أو خارجي أو شيعي إمامي أو زيدي أو غير ذلك فلم يحصل في حق أحد إلا في حقه عليه السلام أما بقية المسلمين غير الخوارج فواضح، وأما الخوارج فهم يعتقدون صحة إمامته إلى زمان تحكيم الحكمين وينكرونها بعده، فيدخلون في الإجماع أيضا.
وكل ما ذكرناه في أمير المؤمنين (ع) موجود في بقية الأئمة الاثنا عشر، و ذلك فإن كون الأئمة (ع) وأوصياء النبي (ص) اثنا عشر من الأمور الثابتة عن النبي (ص) بالتواتر وقد أورد أكثرها سيدنا الأستاذ النجفي المرعشي في ذيل المجلد الثالث عشر من إحقاق الحق، وغيره في غيره.
وإذا ثبت أن أوصياء النبي أو الأئمة اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل
(١٧)
في القول ٥ نقل العلامة الچرندابي عبارة عن المفيد في كتاب الجمل تحتاج إلى توضيح فنقول قال الشيخ المفيد في الافصاح ص ٦٨ طبعة مكتبة المفيد: قد كان بعض متكلمي المعتزلة رام الطعن في هذا الكلام بأن قال: قد ثبت أن القوم الذين فرض الله (تعالى) قتالهم بدعوة من أخبر عنه، كفار خارجون عن ملة الاسلام، بدلالة فوله (تعالى) (تقاتلونهم أو يسلمون) فأهل البصرة والشام و النهروان فيما زعم لم يكونوا كفارا بل كانوا من أهل ملة الاسلام… على أنه يقال للمعتزلة والمرجئة والحشوية جميعا: لم أنكرتم إكفار محاربي أمير المؤمنين؟ وقد فارقوا إطاعة الإمام العادل وأنكرواها وردوا فرائض الله (تعالى) عليه وجحدوها واستحلوا دماء المؤمنين وسفكوها، وعادوا أولياء الله المتقين في طاعته، ووالوا أعدائه الفجرة الفاسقين في معصيته، وأنتم قد أكفرتم مانعي أبي بكر الزكاة، و
ومرة أخرى شرح المسألة شرحا كاملا في كتاب الإفصاح فقال في جواب من سأل أنه (ع) لم عمل معهم معاملة أهل البغي لا الكفار؟ بهذه العبارة:
… ألا ترون إن أحكام الكافرين تختلف: فمنهم من يجب قتله على كل حال، و منهم من يجب قتله بعد الامهال، ومنهم من تؤخذ منه الجزية ويحقن دمه بها ولا يستباح، ومنهم من لا يحل دمه ولا تؤخذ منه الجزية على حال، ومنهم من يحل نكاحه، ومنهم من يحرم بالاجماع، فكيف يجب اتفاق الأحكام من الكافرين؟..) الافصاح ص ٧٧ فمراد الشيخ أن ثبوت بعض أحكام الاسلام لصنف من أصناف الكفار لا يدل على إسلامهم، كما إن جماعة من الفقهاء و جميع الأخباريين يحكمون بطهارة أهل الكتاب، والكل مجمعون على جواز نكاح نسائهم متعة، وغير ذلك فهل تدل هذه الفتاوى وثبوت هذه الأحكام على إن اليهود والنصارى مسلمون؟ كلا وكذلك الأحكام التي رتبها أمير المؤمنين (ع) على محاربيه لا تدل على إسلامهم.
(١٨) قوله في القول ٥ (كالمتلاعنين الخ)
ليت شعري هل المتلاعنين لا يمكن تشخيص الحق منهما، ولا يمكن قيام دليل على إن أحدهما حق والآخر باطل ظالم، ألم يسمعوا قول الله (تعالى) (فمن حاجك فيه من بعد ما جائك من العلم إلى قوله فنجعل لعنة الله على
(١٩) قوله في القول ٧ (إن العقول تعمل بمجردها من السمع)
جعل العلامة الزنجاني النزاع في حسن تأييد العقل بالسمع والتحقيق أن الخلاف بيننا وبينهم في أن تأييد العقل بالسمع واجب أم لا؟ وأما حسنه و كونه مؤكدا في هداية البشر فلا خلاف فيه. وعلى هذا نقول إن هذا الانسان الظلوم الجهول مع تأييد عقله بالشرع ومساعدة الأنبياء للعقلاء والمصلحين وصل أمره إلى ما نرى ورأينا من أول العالم إلى هذا اليوم وكان كما تنبأت الملائكة قبل آلاف السنين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء – فكيف بهم إذا لم تؤيد عقولهم بالشرايع، إلا أن يقولوا بأنهم لو لم يأتهم الأنبياء كانوا أقرب إلى الحق منهم مع الأنبياء، وهذا فضيحة من القول وهم أيضا لا يقولونه.
(٢٠) قوله في القول ٨ (لحصولهم الخ)
مراده بالمعنى الذي حصل للأنبياء إما الوحي كما يأتي في القول ٤٢ أو رؤية الملك كما يأتي في القول ٤٤ وأيا منهما كان فالقرآن والحديث يصرحان في موارد كثيرة باثبات الوحي أو رؤية الملك أو سماع صوته لغير الأنبياء، وتأويل جميعها على خلاف ظواهرها كما عن بعض لا وجه له.
ففي القرآن في سورة الكهف: (قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبهم…) وفي
إذا عرفت ما ذكرنا فنحن بين يقينين ظاهرهما متناقضان:
الأول ما ذكرنا من الآيات والروايات المتواترة المثبة للوحي أو لنزول الملك أو رؤيته على من ليس بنبي، أو من هو كافر، بحيث يلزم من إنكاره إنكار القرآن أو تأويل آيات كثيرة صريحة على خلاف ظواهرها.
والتحقيق إن ارتباط إنسان مع عالم الغيب ونزول الوحي إليه إما بواسطة الملك أو بدونها، قد يكون نزولا رسميا يأتي إليه بحكم يكون بمنزلة إعطاء منصب إلهي هي النبوة ولكنها تستلزم الوحي والإلهام مثل أمراء الملك و حكامه في البلاد فالنبي من كلف بإحياء شريعة الله وتوحيده على وجه الأرض كمنصب رسمي من قبله (تعالى) أو كسفير بينه وبين عباده ونزول الوحي أو الملك إليه بمنزلة الأحكام والأوامر الرسمية التي تصدر من ناحية الملك إلى وزرائه وأمرائه.
وقد يكون ارتباط إنسان مع الله (تعالى) بالوحي أو بنزول الملك لا بعنوان أن يكون نبيا ينبأ عن الله (تعالى) أو رسولا وسفيرا بينه وبين خلقه بل لتسديده في نفسه أو ليلتذ بمناجاة ربه لأنه يحبهم ويحبونه، أو يعلمه (تعالى) وظائفه الشخصية وإن كانت وظيفته تكميل دين نبيه وحفظ الأمة عن الضلال.
والفرق بين المكتوب الرسم الذي يرسله الملك إلى بعض أمرائه بيد خادمه الخصوص وبين ما يرسله إلى أولاده وأصدقائه وأقربائه لإظهار المحبة ونحوها واضح، وليس الفرق بينهما في كيفية حصول الربط أو الشخص الذي يكون واسطة بينهما، بل الفرق في نوعي الرسالتين والمكتوبين وخصوصية الارتباطين.
أحدها أن يكون تبليغ رسالته (تعالى) إلى عباده وهذا يختص بالأنبياء عليهم السلام.
الثاني أن يكون لإظهار حبه (تعالى) له ومناجاته معه وتسديده ونحو ذلك وهذا هو الذي ذكرناه في أم موسى ومريم وذا القرنين وما روي من نزول الملك إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر على الإمام المعصوم ونحو ذلك.
الثالث أن لا يكون شئ من الأمرين موجودا بل المصالح الإلهية اقتضت رؤية بعض الناس من الأفراد العادية أو الكفار للملك أو سماعهم صوته وذلك نظير ما يحكى من رؤية السامري جبرئيل ورؤية قوم لوط للملائكة بتصريح القرآن ونحو ذلك.
فالاجماع والضرورة تحققا على إن الوحي ونزول الملك بالمعنى الملازم للنبوة يختص بالأنبياء وإنهما انقطعا بعد وفات النبي (ص) بالكلية وإن من ادعى ذلك لغير الأنبياء فقد أخطأ وكفر كما ذكره الشيخ المفيد.
وأما بالمعنى الثاني والثالث فلم يقم إجماع على بطلانه بل ربما يؤدي إنكاره إلى إنكار صريح القرآن في آيات كثيرة وإنكار روايات متواترة وقضايا تاريخية واعتقادية ثابتة باليقين.
(٢١) قوله في القول ٩ (الذي يراك الخ)
(٢٢) قوله (وإن عمه أبا طالب ره مات مؤمنا)
لا يخالف أحد من المسلمين من الشيعة والسنة وغيرهما في أن أبا طالب رحمه الله آوى رسول الله (ص) في بيته ونصره في مقابل المشركين فإذا ضممنا إلى هذه الصغرى اليقينية كبرى قرآنية وهي: (والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا) ينتج عن طريق القياس البرهاني إن أبا طالب مؤمن حقا.
ومن غريب الأمر إصرار أهل السنة قديما وحديثا باثبات كفر آباء النبي وخصوصا أبي طالب وجعلهم الأحاديث والقصص الخرافية في هذا الباب، وبعكس ذلك اهتمام علماء الشيعة بالدفاع عنهم وعنه في طول التاريخ بحيث قلما تجد عالما من علماء الشيعة لم يكتب كتابا أو رسالة مستقلة في إيمان أبي طالب، مضافا إلى ما تعرضوا له في ضمن كتبهم الكلامية وغيرها، والسر في إصرار الشيعة بالدفاع عن آباء النبي وعمه وأمه حبهم له (ص) فإن الحب يسري إلى المنسوبين، وأما إصرار العامة على تكفير آباء النبي وأمه وعمه – على فرض صحته عندهم – لا مبرر له، إذ لم يكن من أصول الدين ولا من فروعه.
(٢٣) قوله في القول ١٠ (من جهة السمع دون القياس)
أقول: مراده إن إطلاق كلمة البداء سمعي لا عقلي، لا إن أصل مسألة البداء وإثبات صحته سمعي لا عقلي، فإن البداء الذي هو بمعنى الابداء والإظهار، لما كان معلوما عنده (تعالى) أمر ثابت عند العقل والشرع راجع القول ٥٨.
(٢٤) قوله في القول ١٠ (في معنى الرجعة اختلاف).
أقول: ظاهر العبارة إن الاختلاف بينهم اختلاف معتد به ولذا صرح الشيخ في القول ٥٥ بأن المتأولين لمعنى الرجعة بحيث لا يضر مخالفتهم لثبوت الإجماع ولذا قال في الفصل ٥٥ بعد توضيح معنى الرجعة وتفسيرها برجوع أعيان جماعة من الأموات وأحيائهم حقيقة بعد الموت: (وقد جاء القرآن بصحة ذلك وتظاهرت به الأخبار، والإمامية بأجمعها عليه إلا شذاذ منهم تأولوا ما ورد فيه مما ذكرناه على وجه يخالف ما ذكرناه).
يظهر من هذه العبارة أمرين:
الأول إن رجوع هؤلاء ورجعتهم بعد هذه الأدلة والاخبارات الموجودة في الكتاب والسنة أمر حتمي مقطوع به من دون شك وريب في وقوعه وفعليته، كما لا شك في إمكانه، وهذا هو المراد بالوجوب في عنوان الباب (اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات) يعني تحتم رجوعهم وكونه قطعيا، ومن ضروريات مذهب الشيعة.
وعليه فلا وجه لما عن العلامة الزنجاني من التشكيك في كلمة الوجوب وتبديلها بالجواز وما تكلف في هذا الصدد.
الثاني إن الإجماع والضرورة قامتا على الرجعة بالمعنى المرتكز في أذهان المتشرعة وهو رجوع أعيان الأموات، وإن الخالف في المسألة ليس بحيث يضر مخالفته للاجماع والضرورة، ولذا ادعى هنا الاتفاق من الإمامية وهناك قال (إن الإمامية بأجمعها عليه) مع تصريحه بلا فصل بقوله (إلا شذاذ منهم تأولوا) فيظهر أن المتأولين ليسوا على حد يضر بتحقق الإجماع والضرورة إذ كل أمر من
(٢٥) قوله في القول ١٠ (تأليف القرآن)
أقول: ظاهر كلام الشيخ في مسألة التحريف لا يخلو عن تهافت يعرف بالرجوع إلى ما ذكره في القول ٥٩ فإنه وإن أكد رأيه المذكور هيهنا في تأليف القرآن ولكنه تردد بل مال إلى عدم التحريف بمعنى الزيادة والنقصان فراجع.
(٢٦) قوله في القول ١١ (وأصحاب الحديث قاطبة).
أقول: هذا عطف على المرجئة لا على محمد بن شبيب يعني وافقهم على هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث فقالوا جميعا بأن الخلود خاص بالكفار دون أهل الصلاة وأما محمد بن شبيب فاختار الخلود للعصاة من المسلمين كالمعتزلة.
(٢٧) قوله في القول ١٣ (وإن ضم إلى فسقه كل ما عد تركه من الطاعات)
يعني وإن ضم إلى فسقه إطاعته (تعالى) في ترك كثير من المحرمات كترك الزنا وشرب الخمر ونحوهما مما يكون تركه من الطاعات، وفي بعض النسخ (ما عدا) يعني ضم إلى فسقه ما عدا تركه لوظيفته الذي أوجب فسقه سائر الطاعات.
(٢٨) قوله في القول ١٤ (وإن الفرق بين هذين المعنيين الخ)
كما إن الإيمان في اللغة أخص من الاسلام كذا في الشرع، وذلك أنه يصدق في اللغة إن فلانا أسلم أو سلم أو استسلم لفلان إذا أظهر الخضوع و الانقياد ظاهرا وإن لم يعلم استسلامه باطنا، بل ولو علم عدم تسليمه قلبا.
وهذا بخلاف أن يقال فلان آمن بفلان أو مؤمن بفلان فإنه لا يصدق إلا إذا آمن به قلبا.
(٢٩) قوله في القول ١٦ (في أصحاب البدع وما يستحقون عليه من الأسماء والأحكام)
أقول: المراد بأصحاب البدع أصحاب المذاهب الباطلة التي تدعي الاسلام، ولكنها زادت فيه أو نقصت بما جعلته مذهبا آخر غير الشيعة الإمامية التي هي الاسلام الصحيح وعليه فإن كان لشخص أو جماعة آراء شاذة قليلة في أمور من فروع الدين أو في جزئيات أصول الدين لا في أصلها بحيث لا يلزم إنكار ضروري الدين فهم ليسوا من أصحاب البدع، وإن كان لهم آراء مخالفة في فروع
(٣٠) قوله في القول ١٨ (اجتبيته أنا من الأصول)
أقول: إلى هنا كان البحث عن الفصل بين الشيعة والمعتزلة والمسائل الخلافية بينهما ومن هنا بدء في ذكر آرائه في جميع المسائل الكلامية من دون تقيد بأن يوافق أحدا أو يخالفه، بحيث أنه ربما يكون بعض آرائه مخالفا للمشهور بين الشيعة أيضا، وإن كان هذا قليلا.
(٣١) وأما قوله (نظرا ووفاقا لما جاء عن أئمة الهدى من آل محمد (ص))
فهذا إشارة إلى الخط الذي يمشي عليه في اتخاذ آرائه في هذا الكتاب، فإنه كما التزم على نفسه طريق التعقل والتفقه في المسائل الأصول والمحاربة مع الأخباريين بشدة، كذلك أخذ على نفسه التزاما أن يحارب الإفراط في التفلسف والبعد عن الكتاب والسنة أو التساهل فيهما وتأويلهما لتطبيقهما على الآراء العقلية الكلامية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا هو السبب في عنايته الخاصة بنقل آراء بني نوبخت وتفنيدها في أكثر الموارد.
(٣٢) قوله (واحد في الإلهية والأزلية)
إشارة إلى التوحيد الذاتي يعني ليس هنا إله آخر يكون قديما مثله. وقوله (وإنه فرد في المعبودية) إشارة إلى التوحيد في العبادة وإنه لا يستحق العبادة غيره.
(٣٣) وقوله (لا ثاني له على الوجوه كلها والأسباب)
لعله إشارة إلى المراحل الأربعة للتوحيد: التوحيد الذاتي، والتوحيد الصفاتي، والتوحيد الأفعالي والتوحيد في العبادة.
(٣٤) قوله (رجل من أهل البصرة يعرف بالأشعري) يظهر من هذا التعبير، ومن اكتفائه بتسفيه عقيدته وعدم تعرضه للجواب إلا أنه مخالف لعقيدة جميع المسلمين وعدم تعرضه لآرائه إلا في موارد قليلة من كتبه، إن عظمة الأشعري في ما بين أهل السنة حدثت بعد المأة الخامسة بمقتضى ميول سلاطين الجور وأهوائهم التي لم تكن تنطبق على مذاهب المعتزلة ولا سائر المذاهب مثل ما تنطبق وتوافق المذهب الأشعري و
(٣٥) قوله في القول ١٩ (حي لنفسه)
المراد بكلمة (لنفسه) الاتحاد بين الصفة والذات وعينيتهما في مقابل زيادة الصفة على الذات كما عليه المشبهة، وكونها لا عين الذات ولا غيرها كما عليه الأشعري، وكونها أحوالا كما اختاره الجبائي، والمراد الاتحاد من جهة الوجود والمصداق لا في مقام التصور والمفهوم.
(٣٦) قوله في القول ١٩ (ولا الأحوال المختلفات)
ذكر العلامة الزنجاني في مقام بيان معنى الأحوال توجيهات لا تنطبق على قول البهشمية ولا على الواقع من جملتها قوله (لا خلاف في إثبات تعلق بين الصفة والموصوف كالعالم والمعلوم والقادر والمقدور وغيرهما، وإنما الخلاف في أن ذلك التعلق هل هي بين الذات العالمة وبين المعلوم، أو بين صفة قائمة بالذات حقيقة مغايرة لها وبين المعلوم، فذهبت جماعة إلى أنها بين الذات وبين المعلوم، وذهبت جماعة إلى أنها بين الذات والصفة وسماها أبو هاشم حالا).
أقول: تمثيله للصفة والموصوف بالعالم والمعلوم والقادر والمقدور غريب جدا لأن الموصوف بالعالم والقادر هو ذات العالم والقادر لا المعلوم والمقدور إذ هما متعلقا العلم والقدرة لا موصوفهما وقوله (إنما الخلاف الخ) أيضا خروج
وعلة كونه أشنع من مقالة أصحاب الصفات أمرين:
أحدهما إن الصفاتية أثبتوا للعلم والقدرة مثلا وجودا مغايرا لذات المعلوم، وهذا له وجه، لأن العلم والقدرة ونحوها إعراض أو صفات خارجية، وأما أبو هاشم فقد أثبت التحقق للنسبة والاتصاف الذين هما أضعف وجودا من الصفات.
وثانيهما إن الصفاتية لما أرادوا التحرز من التعطيل ونفى الصفات قالوا بوجودات مستقلة للصفات، وأما أبو هاشم فادعى شيئا بين الوجود والعدم و هذا ارتفاع للنقيضين.
(٣٨) قوله في القول ١٩ (إن القرآن كلام الله)
(٣٩) قوله (ولا أوجب ذلك من جهة العقول)
أقول: قال المحقق الطوسي قده: وتخصيص بعض الممكنات بالايجاد في وقت يدل على إرادته) أقول: بل التخصيص بكم خاص وكيف خاص وزمان خاص ومكان خاص ووضع خاص… مع عموم علمه وقدرته يدل على وجود مخصص وليس إلا الإرادة، والحاصل أن الإرادة مما استدل ويمكن الاستدلال عليها بالعقل أيضا.
(٤٠) قوله (إرادة الله (تعالى) لأفعال نفسه هي نفس أفعاله)
مراده قده إن إرادة الأفعال متحدة مع نفس الأفعال مصداقا وإن اختلفا مفهوما، في مقابل الأشعري الذي جعلها صفة زائدة على الذات، وفي مقابل الفلاسفة الذين جعلوا الإرادة من صفات الذات فردهم بقوله (هي نفس أفعاله) ومراده بقوله (إلا من شذ منها) بعض المتفلسفين من الإمامية ذهبوا إلى أن الإرادة من صفات الذات، فردهم باثبات كونها من صفات الفعل.
(٤١) قوله (لا يجوز تسمية الباري (تعالى) إلا بما سمى به نفسه)
أقول: فيشكل الأمر في أمثال واجب الوجود ومصدر الأشياء والمبدء و نحو ذلك من الأسماء التي لم ترد في الكتاب والسنة.
(٤٢) قوله (وإن المعنى في جميعها العلم خاصة)
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله