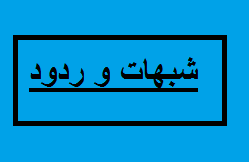أوائل المقالات في المذاهب والمختارات / الصفحات: ٣٦١ – ٣٨٠
(١٣١) قوله في القول ١٠٤ (لقولي في المحدث)
في العبارة إبهامات:
الأول إن قوله (الفعل الذي تسميه الفلاسفة النفس) الظاهر كون كلمة الفعل تصحيف (الشئ) أو (المكلف) لما مر في القول ٥٤ فراجع ولم يقل أحد من المتكلمين والفلاسفة بأن الانسان أو النفس فعل بل الأمر كما ذكرنا.
ولكن حيث أن الكلام في قسمي الفعل وهما المتولد وغيره، فيناسب أو يلزم إثبات كلمة (الفعل) هنا، وعليه فجملة (وهذا مذهب اختصرته أنا لقولي في المحدث) تكون جملة كاملة واضحة المعنى لأن تسمية الفعل بالمحدث لا غبار عليه، كما إن كونه مقسما للمتولد وغيره واضح.
غاية الأمر يبقى الكلام في قوله (الفعل الذي تسميه الفلاسفة النفس) كما مر وحينئذ فراجع إلى ما ذكره الفلاسفة من المناسبات بين النفس والفعل قال صدر المتألهين في الأسفار ج ٨ ص ٦ (أما البرهان على وجودها – النفس –
أو يقال إنه أراد بالفعل قابليته ومبدء صدوره كما يستعمل كثيرا.
الثاني من الإبهامات تطبيق ما ذكره من التفسير على عقيدة الفلاسفة وقد تبين وجهه مما ذكرنا.
الثالث قوله (والأصل فيه الخ) أقول: هناك ثلث مسائل:
الأولى أصل كون الإرادة موجبة لمرادها وهذه اتضحت في القول ١٠٢.
الثانية إنها موجبة لمرادها سواء كان متصلا بها ويسمى غير المتولد أو غير متصل ويسمى بالمتولد، فكلاهما يستندان إلى الإرادة وكلاهما تصيران
(١٣٣) قوله في القول ١٠٥ (يولد أمثاله وخلافه)
أما أمثاله مثل توليد المعلم العلم في المتعلم وأما خلافه فمثل سرور العدو فإنه يولد الحزن في عدوه وبالعكس.
إلى هنا نهاية اللطيف من الكلام ومن هنا بدء في الجليل من الكلام وهو المسائل الأصلية إلى رقم ١٤١.
(١٣٤) قوله في القول ١٠٦ (ولست أعرف بين من أثبت التولد الخ)
هناك مسألتان كلامية وأصولية، فالأولى هو ما بحث عنه في القول ١٠٣ وهو إثبات صدور بعض الأفعال عن الانسان بالواسطة ويسمى بالتولد في مقابل من أنكر استناد هذه الأفعال إلى المريد وأنكر ترتبه على فعله كما مر و بعبارة أخرى الاعتراف بالأفعال التسبيبية وإنكارها والثانية، تعرض لها في هذه المسألة وهي أن الأمر بالسبب هل يلازم الأمر بالمسبب أم لا؟ وكذلك الأمر بالسبب هل يقتضي الأمر بالسبب أو لا؟
وحيث أنهما مبنيان على مسألة التولد فكان يتوهم الملازمة من الطرفين ولكن المفيد قده فصل بينهما فجعل الأمر بالمسبب أمرا بالسبب مطلقا، وأما
(١٣٥) قوله في القول ١٠٨ (والبصريون الخ)
في العبارة سقطات يشبه أن تكون هكذا: (والبصريون يقولون باتحاد معنى الشهوة، والدليل على تعدد معنى الشهوة إن أحد المعنيين موجود في كل حيوان بالضرورة والمعنى الآخر تعلق الأمر بإيجاده والنهي عنه فيلزمهم القول باتحاد الموجود والمطلوب وجوده أو الممنوع من وجوده وذلك محال، لأن الأمر لا يتعلق إلا بما كان اختياريا وكذلك النهي إذ هو نقيض الأمر).
(١٣٦) قوله في القول ١٠٩ (ولا أقول في حال الإيمان…)
أقول: البحث في أن القدرة تتعلق بأحد الطرفين أو هي متساوية النسبة إلى الطرفين، وبالنتيجة البحث في أن الإيمان والكفر مقدوران أو لا.
وشبهة الجبرية هنا نظير شبهة الملحدين في إنكار الخالق حيث قالوا:
الخالق إما أن يعطى الوجود للموجود أو للمعدوم، فإن أعطى الوجود للموجود لزم إيجاد الموجود واجتماع الوجودين لهوية واحدة وكذا إن أعدم المعدوم فإن إعدام المعدوم وإيجاد الموجود محالان، وإن أعطى الوجود للمعدوم، أو أعدم الموجود لزم اجتماع الوجود ولعدم في شئ واحد.
وهنا قالوا بنظير الشبهة وهو إن الذي اختار الإيمان هل كان قادرا على أن
وأقول هناك ثلث مسائل، إحديها ضروري الامكان، الثاني ضروري البطلان، الثالث محل خلاف.
فالذي لا خلاف في إمكانه أن نحكم على من هو مؤمن فعلا بأنه يمكن أن يصير كافرا في المستقبل بأن يكون الكفر في المستقبل بدلا عن الإيمان الفعلي، وبالعكس بأن يكون الإيمان في المستقبل بدلا عن الكفر فعلا. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أخيرا (فأما القول بأنه يجوز من الكافر الإيمان في مستقبل أوقات الكفر…) وحكمه بالإمكان بمعنى الإمكان الذاتي وإلا فبالنظر إلى أدلة الموافاة يعتقد الشيخ عدم وقوعه.
وأما الذي لا خلاف في بطلانه فهو ملاحظة حال المؤمن بوصف أنه مؤمن وأنه بهذا اللحاظ وبقيد اتصافه بالإيمان هل يمكن كون الكفر بدلا من إيمانه أم لا وبالعكس وهو أن الكافر بقيد كونه كافرا هل يمكن اتصافه بالإيمان، وهذا يكفي تصوره في إنكاره والحكم باستحالته، وذلك لأن ثبوت الإيمان للمؤمن بقيد كونه مؤمنا والكفر للكافر بقيد كونه كافرا ضروري بشرط
(١٣٧) قوله (وذلك أن جواز الضد هو تصحيحه وصحة إمكانه وارتفاع استحالته الخ)
أقول: إشارة إلى القاعدة المسلمة من أن المحال كما لا يحكم بوقوعه لا يحكم بإمكانه أيضا، وأنه كما لا يعلم لا يحتمل أيضا فاجتماع النقيضين والضدين لا يحكم بجوازه ولا يصحح ولا يجوز.
(١٣٨) قوله في القول ١١٢ (من أصحاب الأصلح)
أقول: إشارة إلى أن الحكم بعدم جواز اخترام هذين الشخصين لا يبتني
(١٣٩) قوله في القول ١١٣ (لمن يستصلح به غيره)
أقول: خلاصة البحث أن إيلام شخص لشخص آخر على أربعة أقسام:
لأن صاحب الألم إما مؤمن أو كافر وصاحب المصلحة أيضا إما مؤمن أو كافر.
أما إيلام المؤمن لمصلحة مؤمن آخر فلا إشكال في جوازه كما لا إشكال في وجوب العوض عليه (تعالى)، كما لا إشكال في إيلام الكافر لمصلحة المؤمن مع عدم العوض، وأما إيلام المؤمن لمصلحة الكافر فظاهر الشيخ المفيد جوازه و وجوب العوض عليه (تعالى)، وأما إيلام الكافر لمصلحة الكافر فأصل ثبوته، الظاهر جوازه وأما ثبوت العوض عليه فمحل إشكال.
وأما بناؤه على نفي الاحباط فلأن كل عمل خيرا كان أو شرا إذا كان سببا لإحباط ما سبقه من ضده فحينئذ لا يمكن توجيه ألم شخص لشخص آخر مؤمنا كان أو كافرا إذ لا حساب ولا موازنة على هذا القول وإلى هذا القول أشار بقوله دون من وافقني في العدل والإرجاء، وأما بناء على نفي الاحباط كما عليه الشيعة وإن الأعمال الصادرة من المكلفين لها حساب ميزان ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فيستقيم هذا القول وإلى هذا أشار
(١٤٠) قوله في القول ١١٦ (وبجميعه أيضا)
يعني قد يعاقبهم في الدنيا في مقابل بعض معاصيهم ويبقي جزاء الباقي إلى الآخرة، وقد يجازيهم جميع معاصيهم في الدنيا فلا يبقى شئ إلى الآخرة بل يدخلون الجنة فيها.
(١٤١) قوله في القول ١١٥ (وأما كونه ثوابا فلأن أعمالهم أوجبت في جود الله وكرمه الخ)
أقول، ظاهر العبارة الاستناد في كونه ثوابا على جوده (تعالى) وكرمه، مع أن ما يصل إلى العبد من طريق الجود والكرم يكون عين التفضل لا الثواب، مضافا إلى أن العطاء المستند إلى الجود والكرم لا يشترط بالأعمال.
وهناك احتمال آخر وهو أن الله (تعالى) حيث أنه تعهد ووعد الثواب في مقابل الأعمال وهو لا يخلف الميعاد لقبحه، فالجزاء يجب عليه في مقابل الأعمال ثوابا لوجوبه عليه (تعالى)، والقرينة على إرادة هذا الاحتمال قوله (أعمالهم أوجبت).
وأما ذكر الجود والكرم للاحتراز عن الوجوب من جهة عدله.
(١٤٢) قوله في قوله ١١٧ (وقد يعبر…)
(١٤٤) قوله في القول ١١٩ (وقد أطلق بعض أهل النظر)
قد وردت روايات وعبارات في أدعيتهم عليهم السلام تؤيد بعض ما ذكره هذا البعض، منها ما رواه الكليني في باب أن الإرادة من صفات الفعل، الحديث الثالث، بسند صحيح عن أبي الحسن (ع) (… الإرادة من الخلق الضمير و ما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله (تعالى) فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروى ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك بقوله له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما إنه لا كيف له.
(١٤٥) قوله في القول ١٢١ (وهذا مذهب كافة أهل العدل من الشيعة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والزيدية والمجبرة بأجمعهم على خلافه)
لا إشكال في أن الشيعة والمعتزلة تفسيران لكلمة أهل العدل، كما إنه لا إشكال في أن المجبرة مبتدأ خبر ما بعده، وأما المرجئة والخوارج والزيدية فإن جعلناها معطوفة على المعتزلة يكون الجميع تفسيرا لكلمة أهل العدل مع إنه لم يعهد عد المرجئة والخوارج من العدلية وإن كانت الزيدية منهم.
وإن كان الواو في قوله والمرجئة استينافا فالمحذور يرفع من هذه الجهة و لكن يبقى الكلام في نسبته المخالفة في المعنى المذكور إلى الخوارج والزيدية فإنهما يوافقان الشيعة في المعنى المذكور للشهادة. نعم المرجئة لا يبعد مخالفتهم معنا في هذا المعنى.
والأولى أن تكون المعتزلة عطفا على الشيعة فتكونان تفسيرين لكلمة
(١٤٦) قوله في القول ١٢٣ (ولا يوالي من يصح أن يعاديه)
أقول: النسخ التي بأيدينا اتفقت على زيادة لا في (لا يوالي) والظاهر أنها زائدة لأن الفقرتين إنما يحكيهما الشيخ للرد:
إحديهما قوله (فأما القول بأن الله سبحانه قد يعادي من يصح موالاته له من بعد) يعني أن من كان ظاهره فعلا الكفر ولكن الله (تعالى) يعلم أنه يصير في المستقبل مؤمنا محبا لله (تعالى) فالقول بأن الله يعاديه الآن لفسقه أو لكفره الظاهر فعلا يظهر بطلانه مما ذكرنا في باب الموافاة وقلنا بأن من كان آخر أمره الإيمان فإن الله (تعالى) يحبه طول حياته.
والفقرة الثانية قوله (فأما القول بأن الله… لا يوالي من يصح أن يعاديه فقد سلف قولنا فيه في باب الموافاة) أقول: كلمة (لا يوالي) مترادف أو متلازم لقوله يعادي فكأنه قال (وأما القول بأن الله يعادي من يصح أن يعاديه فقد سلف قولنا فيه في باب الموافاة) ومعلوم أن سياق نقله لهاتين الفقرتين أنه في مقام الرد عليهما بما ذكره في باب الموافاة، مع أن الفقرة الثانية على فرض وجود كلمة (لا) في أولها يكون عين ما ذكره في باب الموافاة، لأن معناه على هذا: إن الله (تعالى) يعادي العبد الذي كان ظاهره الإيمان والتقوى إذا علم أنه في المستقبل يصير من أعدائه، وهذا عين عقيدته في باب الموافاة.
وأما إذا أسقطت كلمة لا فالمعنى أنه (تعالى) يوالي الآن من ظاهره فعلا
وأما ربطها بالعدل فلأنا لو قلنا بأن من ظهر منه الإيمان والعمل الصالح في مدة من الزمان، وكان إيمانه واقعيا حينذاك، وإن كفره حدث بعد ذلك فكيف يصح الاغماض عن إيمانه وعمله الصالح في تلك البرهة من الزمان، و المعاملة معه معاملة من كان كافرا طول عمره، إلا على ما اختاره في باب الموافاة من أنه لم يؤمن طرفة عين فحينئذ يكون منطبقا على العدل.
وأما ربطه بالارجاء فلأن الارجاء عبارة عن جعل الملاك الأصلي هو العقيدة دون العمل كما عليه الخوارج والمعتزلة، فحينئذ يستقيم الحكم بمن ختم له بالكفر، أن يكون الله (تعالى) عدوا له طول عمره مع ما هو عليه من ظاهر الإيمان والأعمال الصالحة، وذلك لكونه في الباطن غير مؤمن بل كافرا، والمهم هو العقيدة.
ويستقيم أيضا الحكم بأن الله يوالي من يختم له بخير وإن كان كثيرا من عمره على ظاهر الكفر والفسق لكونه في الباطن مؤمنا تمام عمره.
وقد علم سابقا أن كلمة الارجاء عند الشيخ ليس بمعنى سقوط العمل رأسا كما عند المرجئة، بل بمعنى أصالة العقيدة وفرعية العلم وعدم دخله في الإيمان والكفر لا عدم دخله في الثواب والعقاب أصلا.
(١٤٧) قوله في القول ١٢٤ (إنها قد تجب الخ)
(١٤٨) وقوله (ولا فيما يغلب أو يعلم أنه استفساد في الدين)
أقول: لما كانت مسألة التقية من مصاديق باب التزاحم يراعي المرجحات المذكورة هنا وحيث أن الدين أهم من نفس المؤمن فقاعدة الأهم والمهم يقتضي ترجيح حفظ الدين على حفظ النفس.
(١٤٩) قوله (وهذا مذهب يخرج عن أصول أهل العدل وأهل الإمامة خاصة…)
أقول: يخرج بالتشديد، مراد قده أنه يستخرج على أصول أهل العدل و الإمامة دون غيرهم وعليه فكلمة (عن) إما تصحيف (على) أو بمعناه.
(١٥٠) قوله في القول ١٢٥ (كما تقدم في الصفة)
أقول: هذا البحث مر منه في موارد من كتابه، منها في القول ١٨ والقول ١٩ ولكن البحث في الأول عن صفاته (تعالى) بالنسبة إلى ذاته، لا مطلق الصفة مع موصوفها، وفي مقابله المشبهة والأشاعرة كما أشار إليهما الشيخ في المسألتين.
وبحث عنها في الأسفار ج ٦ ص ١٣٣ وفي شرح المواقف ج ٨ ص ٤٤ وفي شرح المقاصد ج ٥ ص ٦٨.
وفي الثاني أعني القول ١٩ عن الصفة والموصوف بقول مطلق وعلى
وقد يبحث عن صفاته (تعالى) على الخصوص وإنها هل هي عين المسمى أو غيره كما يظهر من نسبة الخلاف إلى أهل التشبيه.
وهذا هو الذي أطال البحث فيه المتكلمون بعنوان البحث عن الاسم و المسمى. فراجع شرح المقاصد ج ٥ ص ٣٣٧ وغيره في غيره وكذا أجود التقريرات ج ١ ص ٨٤ بحث المشتق والكفاية ج ١ ص ٨٥ ولكن مع مغايرة جهة البحث في الأصول والكلام.
(١٥١) قوله في القول ١٢٦ (وهذا مذهب متفرع على القول بالعدل والإمامة)
وأما على قول الشيعة فلأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ولكن باللسان والأزيد منه مشروط بإذن الإمام المعصوم (ع)، ومن هنا ظهر أن مراده بالسلطان الإمام المعصوم إذ لا معنى لاشتراطه بإذن سلطان الجور.
ولو أريد بالسلطان غير المعصوم فلا يحصل له بسط اليد إلا بعد وجود السلطان الجديد وإلا فلا معنى للخروج على سلطان بإذنه، والمفروض أنه لا سلطان لهم إلا بعد بسط اليد فيتوقف كل من بسط اليد وإذن السلطان على الآخر وبطلانه دليل على إرادة الإمام من السلطان.
(١٥٢) قوله في القول ١٢٧ (وإن تعلق بالوجود بأفعال قبيحة…)
وهذا هو الذي يعبر عنه في الفقه بشرائط القبول وإن شارب الخمر والعاق لوالديه وفلان وفلان لا تقبل صلاتهم ويفرقون بينها وبين شرائط الصحة.
(١٥٣) قوله في القول ١٢٨ (واستعماله على الأغلب في العصيان)
عطف على كلمة (ظاهر) يعني لا بأس به إذا لم يكن بضرر أهل الإيمان ولا يكون استعماله على الأغلب في العصيان.
وحاصله أن المتابعة معهم يجوز بشرطين، أحدهما عدم تضرر أهل الإيمان، الثاني أن لا يكون مشوبا بكثرة المعصية بحيث يكون غالبا مبتلى بالمعصية كما هو شأن بساط أهل الجور من كثرة الفسق والفجور والظلم.
وهنا بحث لازم وهو الفرق بين هذه العناوين الخمسة المذكورة في عبارة المفيد قده فنقول: المعاونة عبارة عن تهيئة الأسباب والمقدمات لفعل الظالم مثل
وأما المتابعة لهم فهو قبول رئاستهم وعدم الخروج عن تحت رايتهم وكونه رعية وتبعا لهم بحيث يعد من اتباع حكومته فحكم بجوازه بشرطين كما أشرنا.
وأما الاكتساب منهم فهو يحتمل معنيين، أحدهما مطلق الصناعة والتجارة معهم مثل أن يكون بناء يبني لهم الدار كغيرهم وتاجرا يبيع منهم المتاع كغيرهم.
الثاني أن يختص بهم بحيث يقال مثلا بناء الحكومة أو نجارها أو الذي يشتري أو يبيع للحكومة فقط كما أشار إليه الشيخ الأنصاري.
وأما الانتفاع بأموالهم فهو مثل أخذ جائزتهم أو شراء الأموال التي كانت بأيديهم من دون وجود شئ من العناوين المذكورة سابقا.
ولتفصيل البحث راجع مبحث معاونة الظالمين ومبحث جوائز السلطان من كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري.
(١٥٤) قوله (ولست أعرف لهم موافقا لأهل الحلاف)
أي من أهل الخلاف والسبب في اختصاص هذه الأحكام بأهل الإمامة و عدم وجود موافق لهم من المخالفين ص اختصاصهم باشتراط العصمة في حاكم المسلمين وإمامهم، ولازمه كون كل من جلس مجلسهم ظالما غاصبا وكل من شاركه في ظلمه شريكا معه، وأما أهل الخلاف فلا يوجد فيهم من يشترط
(١٥٥) قوله في القول ١٢٩ (لاستحالة حصوله إلا وهو فيه)
لا خلاف بين الشيعة في أن ملاك حجية الإجماع كشفه عن قول المعصوم (ع) ولكن يمكن تفسير هذا بمعنى أن حجية الإجماع يتوقف على إحراز اشتماله على قول المعصوم (ع) فالواجب لمن يدعي الإجماع إحراز أمرين: الأول إحراز اتفاق العلماء، الثاني إحراز وجود رأي المعصوم (ع) فيهم وحينئذ يأتي إشكالات عديدة تعرضوا لها في علم الأصول أهمها إن من أحرز رأي المعصوم فلا حاجة له إلى آراء البقية وهل نسبة آرائهم إلى الحجة الواقعية إلا كنسبة الحجر إلى الإنسان، ومن لم يحرز رأيه فلما ذا يتكلف لجمع آراء الفقهاء، و يمكن تفسيره على نحو لا يرد عليه هذا الاشكال بأن آراء العلماء إمارة عقلائية وشرعية تكشف عن رأي المعصوم (ع) كشفا نوعيا مثل كون خبر الثقة ونحوه كاشفا عنه وعليه فإحراز الإجماع إحراز لرأي المعصوم (ع) بالملازمة، إلا أن يقوم دليل في مورد على عدم كون الإجماع فيه كاشفا، وإلا فالأصل في الإجماع اشتماله على رأي المعصوم (ع) وإلى هذا أشار الشيخ المفيد قده بقوله (لاستحالة حصوله إلا وهو فيه).
(١٥٦) قوله (ويخالفهم فيه الخ)
(١٥٧) قوله في القول ١٣٠ (ما يدل على صدق راويه)
أقول: ذكر الراوي لا يدل على اختصاص دليل الصدق على القرائن السندية مثل الوثاقة ونحوها بل المراد كل دليل من سند الرواية أو متنها مثل كونه موافقا للكتاب ومخالفا للعامة أو نحو ذلك مما ذكروا.
كما إن دلالته على صدق الخبر أعم من الدلالة الشخصية أو النوعية بأن تفيد الاطمينان النوعي وغير ذلك فليس مراده ما نسب إلى السيد المرتضى من إنكار حجية الخبر الواحد.
والقرينة على ما ذكرت إسناده رأيه إلى جميع الشيعة بل جميع المسلمين غير متفقهة العامة وأصحاب الرأي.
إذ لو كان رأيه في الخبر الواحد رأي السيد المرتضى لكان رأيه مخالفا لجمهور الشيعة ولجمهور المسلمين أيضا وموافقا لمتفقهة العامة وأصحاب الرأي فإنهم يفرطون في رد الأخبار الآحاد.
(١٥٨) قوله في القول ١٣١: (إن حكاية القرآن قد يطلق عليه اسم القرآن.)
وقع البحث بين العدلية وغيرهم في قدم كلام الله (تعالى) الذي أوحى به
(١٥٩) قوله في القول ١٣١ (ويخالف فيه)
أقول: قال العلامة الزنجاني (فالألفاظ والعبارات المنزلة على الأنبياء على السن الملائكة دلالات على ذلك الكلام الأزلي القديم فالمدلول عنده قديم والدلالة محدثة). أقول: هذا ما فسر المتأخرون من الأشاعرة كلام شيخهم الأشعري أو بالأصح أن نقول إنهم أولوا كلامه واعتذروا عما يلزمه من المناقضات بهذه التوجيهات.
ولكن الدقة في كلامه كلام المتبحرين في فهم مذهبه يؤيد ما صرح به هو في كتبه واتباعه المخلصون له: من أن كلام الله الذي هو قديم هو عين المكتوب في المصاحف والمقروء على الألسن وأن المقروء والمكتوب قديمان والقراءة والكتابة حادثتان ولتوضيح المطلب ننقل عبارة شرح المواقف حتى يتضح
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله