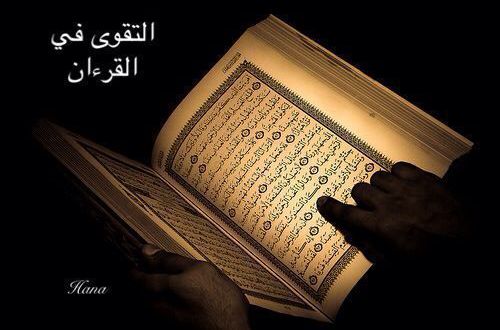من الامور الواضحة، أنّ المجتمعات الانسانية لا يمكن لها تحصيل السعادة، إلاّ من خلال القانون، ولا يمكن للقانون أن يسود إلاّ إذا كان متكئاً على إيمان بالله الواحد الاحد، ولا يمكن لهذا الايمان أن يترسّخ إلاّ من خلال الاخلاق الكريمة. فالتوحيد هو الاصل الذي تنمو عليه شجرة السعادة الانسانية، وتتفرّع منها الاخلاق الكريمة، وهذه الفروع هي التي تثمر ثمراتها الطيّبة في المجتمع الاسلامي.
قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الاَْمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الاَْرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار)( [64]) حيث جعلت الايمان بالله تعالى كشجرة لها أصل ثابت وهو التوحيد بلا ريب، وأكل تؤتيه كلّ حين بإذن ربّها وهو العمل الصالح، وفرع وهو الخلق الكريم كالعفّة والشجاعة والعدالة والرحمة ونظائرها.
بيان هذه الحقيقة «أنّ الانسان لا يتمّ كماله الذي من أجله خُلق، ولا يسعد في حياته إلاّ بالاجتماع مع أفراد آخرين يتعاونون على أعمال الحياة، على ما فيها من الكثرة والتنوّع، وليس يقوى الانسان بمفرده على الاتيان بها جميعاً.
وهذا هو الذي أحوج الانسان الاجتماعي إلى أن يضع السنن والقوانين، لكي يحفظ بها حقوق الافراد من الضياع والفساد. ومن المسلّم أنّ هذه السنن والقوانين لا يمكن أن تؤثِّر إلاّ بواسطة مجموعة من القوانين الجزائية التي تترتّب على المتخلّفين والمتعدّين على حقوق الآخرين، وتخوّفهم بالسيئة قِبال السيّئة، وبأُخرى تشوّقهم وترغّبهم في عمل الخيرات. ولا يمكن أن يتحقّق ذلك إلاّ من خلال قوّة حاكمة تحكم في المجتمع بالعدل والصدق.
وإنّما تتحقّق هذه الاُمنية إذا كانت القوّة المنفّذة للقانون:
أوّلاً: عالمة بالجرم.
ثانياً: قادرة على معاقبة المجرم.
أمّا إذا جهلت ووقع الاجرام على جهل منها أو غفلة ـ وكم له من وجود ـ فلا مانع من تحقّق الجرم، والقوانين بنفسها لا أيدي لها تبطش بها. وكذا إذا ضعفت الحكومة بفقد القوّة اللازمة، أو تساهلت في الامر، فظهر عليها المجرم، أو كان أشدّ قوّة، عند ذلك تضيع القوانين وتفشو التخلّفات والتعدّيات على حقوق الناس.
وتشتدّ البلوى إذا تمركزت هذه القوّة في أيدي الجهاز الحاكم ومن يتولّى أزمّة جميع الامور، عند ذلك تستضعف الناس وتسلب منهم القدرة على ردّها إلى العدل وتقويمها بالحقّ. والتاريخ مملوء من قصص الجبابرة والطواغيت وتحكّماتهم الجائرة على الناس. وهو ذا نصب أعيننا في أكثر أقطار الارض.
إذن فالقوانين والسنن وإن كانت عادلة في حدود مفاهيمها، وأحكام الجزاء وإن كانت بالغة في شدّتها، فإنّها لا تجري على رسلها في المجتمع، ولا تسدّ طريق التخلّف عنها. من هنا يأتي دور الاخلاق الفاضلة الانسانية لتقطع دابر الظلم والفساد، كملكة اتباع الحق واحترام الانسانية والعدالة والكرامة والحياة ونشر الرحمة ونظائرها. وهذا معناه أنّ السنن والقوانين الاجتماعية لا تأمن التخلّف والضياع إلاّ إذا تأسّست وقامت على أخلاق كريمة إنسانية، واستظهرت بها.
لكن الاخلاق بمفردها لا تفي بإسعاد المجتمع، ولا تسوق الانسان إلى صلاح العمل، إلاّ إذا اعتمدت على التوحيد، وهو الايمان بأنّ للعالم ومنه الانسان إلهاً واحداً سرمدياً، لا يعزب عن علمه شيء، ولا يُغلب في قدرته عن أحد، خَلَقَ الاشياء على أكمل نظام لا لحاجة منه إليها، وسيعيدهم إليه فيحاسبهم، فيجزي المحسن بإحسانه، ويعاقب المسيء بإساءته، ثمّ يخلدون منعَّمين أو معذَّبين.
ومن المعلوم أنّ الاخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة، لم يبق للانسان همّ إلاّ مراقبة رضاه تعالى في أعماله، وكانت التقوى رادعاً داخلياً عن ارتكاب الجرم، ولولا ارتضاع الاخلاق من ثدي هذه العقيدة، عقيدة التوحيد لم يبق للانسان غاية في أعماله الحيوية إلاّ التمتّع بمتاع الدنيا الفانية والتلذّذ بلذائذ الحياة المادّية»( [65]).
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله