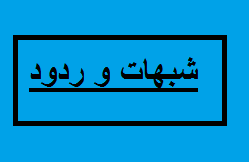عوامل التربية (2)
الإحسان ـ تقوية شعور البحث عن الحقيقة ـ المراقبة والمحاسبة
من المسائل التي طرحت بشأن التعليم والتربية الإسلامية، مسألة المحبة والعنف. ما يقابل المحبة هو البغض دائماً، لكن أثر المحبة هو الإحسان واللين، وأثر البغض هو الخشونة والعنف.
إن البعض ينظر إلى هذا النوع من التربية والتعليم الإسلامي بعين الانتقاد ويقول: لم يعتن الإسلام كثيراً بمسألة المحبة وأثرها وهو الإحسان واللين. وان وجدت مسألة محبة الناس والاحسان إليهم واللين والتواضع لهم، فكذلك توجد في مقابلها العداوة، وابداء الخشونة والغلظة، وبعبارة واحدة: الإساءة إلى الآخرين أيضاً. ونعلم بأن الذين يؤكدون على المحبة كثيراً هم المسيحيون وقساوسة المسيح. هؤلاء يتحدثون كثيراً عن المحبة ويقولون: إن عيسى المسيح كان يدعو إلى المحبة فقط، ولم يستثن أحداً في المحبة بأن يكون مؤمناً بالله أم لا، بل كان يقول: إبدوا المحبة للجميع.
قرأت في أحد كتب تاريخ الأديان ـ أو في مقالة مترجمة ـ أن هناك عبارة مشتركة في جميع الأديان العظمى في الدنيا، ومتحدة المآل لديها تواجد في دين المسيح، واليهود، ودين زرادشت، والدين الإسلامي، ودين بوذا، وهي: “احبب للآخرين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك” ولنا أحاديث كثيرة في الإسلام بهذا المضمون منها: “أحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك” فهذا الدستور الموجود في الإسلام هو دستور عام ومطلق. ولكن هل وضع الإسلام استثناء لهذه القاعدة العاُمة لا يوجد في الأديان الأخرى؟ وهل يقول الإسلام: احبب للناس ما تحب لنفسك إلا بعضهم أم: أحبب للناس ما تحب لنفسك إلا في بعض الأمور؟ ان الاختلاف بين الإسلام والمسيحية[1] هو في تفسير المحبة لا في هذا الأصل العام.
نوعان من المحبة
نبدأ البحث بهذا السؤال: هل حب شيء للنفس منطقي دائماً؟ يمكن أن تقولوا: في الواقع اننا نشكل على هذا الأمر، لأنه يقول أحبب للناس ما تحب لنفسك. فيحتمل أن يحب الإنسان لنفسه شيئاً لا ينبغي له أن يحبه؛ فإن كون الشيء محبوباً للإنسان غير كونه مصلحة له. فلو كان الإنسان مصاباً بمرض السكر، فإن العسل مضر له، لكنه يحب العسل، فهل يقال له: بما أنك تحب العسل لنفسك مع أنه مضر لك، فاحببه لجميع الناس حتى لمن لم يضره العسل.
لابد أن يكون المراد بالمحبة هنا هو المحبة العقلائية والمنطقية التي تساوي المصلحة، والمقصود هو ما يكون فيه مصلحة وخير وسعادة حقاً، كما أنك تريد الخير والسعادة لنفسك دائماً، فهكذا أحبب الخير والسعادة لعاُمة الناس. فإرادة الخير والسعادة للناس تختلف عن المحبة التي يقول بها المسيحيون وعاُمة الناس وهي المحبة الظاهرية، أي القيام بعمل يجلب رضا المقابل. مثلاً إن أباً وأمّاً يحبان ابنهما ويريدان له الخير والسعادة، فيمكن تجلي هذه الإرادة لخير الطفل وسعادته بصورتين: الوالدان الجاهلان المحبان لولدهما يجعلان مقايس المحبة هو ما يريد هذا الطفل، فنعطيه إياه؛ ولا نعطيه ما يكره. كإعطائه الطعام الفلاني، وأنا أحب ابني ولا أستطيع أن أمنع عنه الشيء الذي يحبه، أما الدواء والتلقيح الذي يكرهه الطفل فلا أعطيه إياه ولا أزعجه أبداً.
هذه صورة للمحبة. والصورة الأخرى لها هي المقرونة بالمنطق، أي المحبة الموافقة للمصلحة الحالية والمستقبلية، فالمحبة هي إحسان حقيقي يمكن أن تكون موافقة لميل الطفل وطبعه أو غير موافقة له. فلو أردنا تفسير هذا الدستور العام المذكور في جميع الأديان. بأن المقصود من المحبة هنا هو معاملة الناس بما يحبون، وبعبارة أخرى: عاملوا الناس بالنحو الذي تحبون أن يعاملوكم به؛ ففي هذه الحال يجب القول: إن دستور الأديان هذا هو دستور خاطئ ـ والعياذ بالله ـ فالمحبة والاحسان وإيصال الخير للناس والمجتمع لا يمكن أن يقوم على أساس محبتهم هم للأشياء. إن بعض مؤسسات التلفزيون قد سألت الناس: ماذا تحبون لنقدم لكم، وأي البرامج تفضلون؟ فيمكن أن يحب الناس شيئاً تؤدي رؤيته إلى فسادهم وضلالهم. بينما لو كانت المحبة واقعية وحقيقية فيجب أن لا يتبع العدد والكثرة. فليس الميل كالمصلحة وهكذا محبة ذلك الأب والأم العميقة والعقلائية والمنطقة، لا يمكن أن تتحدد بمثل وإرادة الطفل؛ بل يجب أن يلتفتا ويهتما بالمستقبل أيضاً.
مصلحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد
مضافاً إلى ذلك، فتارة يتعلق الأمر بالفرد، وأخرى بالجماعة، نذكر مثال الأب والأم أيضاً اللذين لهما عدة بنات وبنين، وهما يحبان الجميع. لكن أحد هؤلاء الأطفال متفوق على الآخرين. وان الوالدين لا يتصرفان طبقاً لميل هذا الطفل. فلو كان الميل مقياساً أيضاً، فعليهما الاهتمام بميول بقية الأطفال أيضاً. أي أن من يريد أن يتعامل مع أولاده بكمال المحبة يجب أن تكون لديه المصلحة هي المقياس، وهكذا تكون مصلحة الجماعة مقياساً لا مصلحة الفرد. وكما نرى موارد لا تتفوق فيها مصالح الفرد ومصالح الجماعة، فلو بذلنا اهتمامنا لتحقيق مصلحة الفرد، فإن مصالح بقية الأفراد، بل مصلحة ذلك المجتمع الذي يكون الفرد جزءاً منه ستنعدم، وسيتضرر ذلك الفرد نفسه أيضاً. لهذا يضحي في بعض الموارد بمصلحة الفرد لصالح الجماعة. ومن هنا فإن المحبة ـ التي ذكرنا أن أصلها هو قصد الخير والإحسان ـ توجب عدم اللين، وتستدعي ما يتصوره الإنسان ضرراً وسوءاً لنفسه، كالإعدام مثلاً عندما تكون فيه مصلحة الجماعة.
فلسفة القصاص
انظروا إلى تعبير القرآن بشأن مسألة القصاص، إن القرآن يدافع عن القصاص في قانونه الجزائي، في الموارد التي يقتل فيها الإنسان شخصاً بريئاً دون مسوغ، فإن الإسلام يجوز القصاص بإعدام القاتل. ويأتي هنا سؤال وهو أنه لو كان القتل أمراً قبيحاً، فلماذا نكرر نحن هذا العمل القبيح بعنوان القصاص؟ إننا بإعدام القاتل نكون قد كررنا قتل إنسان مرة ثانية. والجواب هو ما يقوله القرآن: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) [2] فالاعدام لا يمكن اعتباره قتلاً وإماتة، بل هو حياة. ولكن ليس للفرد بل للجماعة. أي أنكم تحفظون حياة المجتمع والأفراد الآخرين بالقصاص من شخص متجاوز، فلو لم تمنعوا القاتل عن فعله فإنه سوف يقتل فرداً آخر، وسيوجد أمثاله ممن يقتلون الكثير من الناس. إذاً لا تعتبروا ذلك اضمحلالاً للمجتمع، بل هو حفظ وبقاء له؛ ولا تعتقدوا بأنه إماتة، بل هو حياة؛ فالقصاص لا يعني كراهية الإنسان ومعاداته، بل يعني محبة الإنسان.
حب الإنسان
ونذكر هنا موضوعاً آخر وهو: يقال: “حب الناس” وهو كلام صحيح طبعاً، لكن يجب توضيحه. فالإنسان في (حب الإنسانية) يراد به الإنسان بما هو إنسان، أي يجب عليه حب الإنسان بسبب أنه إنسان، وبالمصطلح المعاصر (الإنسان بقيمة الإنسانية). فمرة نقول في تعريف الإنسان: انه حيوان ذو رأس وأذنين ومستقيم القاُمة ومتكلم. فإن كان هذا هو الإنسان فالذين أرادوا صلب عيسى (ع) هم أناس بمقدار ما كان عيسى إنساناً، فهم كانوا يتكلمون مثله، ولم يختلفوا عنه في هذه الناحية. ولكن ليس هذا هو المقصود، بل المقصود هو الإنسان لأجل قيمة الإنسانية، فلو وضعنا عيسى (ع) إلى جانب أعدائه، سيكون هناك نوعان مختلفان، فهذا شيء وذلك شيء آخر، أي يمكن أن يكون هذا إنساناً بلحاظ القيم الإنسانية، وذلك ليس إنساناً، بل حتى ليس حيواناً، وبتعبير القرآن هو أضل من الحيوان بمراتب. فيجب حب الإنسان لأجل الإنسانية، لا لأجل هيكله وشكله، وبعبارة أخرى يجب حب الإنسانية.
فلو أصبح الإنسان عدواً للإنسانية وضد البشر، واصبح مانعاً في طريق تكامل البشرية، فلا يسوغ لنا أن نحبه؟ انه بصورة إنسان ولكنه خال من محتوى الإنسانية. وبتعبير أمير المؤمنين (ع): “الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان” ولا يسوغ أن نخون الإنسانية ونعاديها باسم حب الإنسان، إذن بغض النظر عن هذه المسألة، وهي أن المحبة ليست مراعاة للميول، بل هي مراعاة المصلحة وخير وسعادة المقابل. وبغض النظر عن أن مصلحة الفرد ليست مقياساً وملاكاً، بل يجب الالتفات إلى مصلحة الجماعة، فإن مسألة حب الناس هي حب الإنسانية، وإلا لو كان المراد في الإنسان هو إنسان علم الأحياء فلا فرق حينئذٍ بين الإنسان والحيوان ـ فلماذا لا نحب الأغنام والخيول بقدر ما نحب الإنسان؟ فذلك حيوان ذو روح وهذا موجود ذو روح أيضاً. فإن كان الملاك هو وجود الروح والإحساس باللذة والألم فإنه موجود في الإنسان بمقدار ما هو موجود في غيره من الحيوانات.
إذن يجب إرجاع المسألة إلى حب الإنسانية. ومعنى حب الإنسانية هو رعاية مصالح الناس ـ لا مراعاة الميول فقط ـ فيتبين أن تفسير محبة الناس وفق التعامل حسب ما يرضي هذا أو ما يحبه ذاك، هو منطق وتفسير خاطئ، بل ان المحبة المنطقية هي التي تكون في بعض الأحيان مقترنة بالخشونة، والجهاد والمحاربة، والقتل، ووجوب القضاء على من يشكل عائقاً ومانعاً في طريق الإنسانية.
الاحسان إلى الكافر
القرآن يوصي بالمحبة والاحسان لجميع الناس حتى الكفار. ولكن بشرط أن يكون لهذا الاحسان أثر حسن. وان لم يكن له ذلك الأثر فذلك الاحسان سوء بهيئة إحسان. فمثلاً يقول تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم) [3] .
أي أن الله لا ينهى المسلمين عن الاحسان إلى الكفار المسالمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم (كقريش حيث فعلت ذلك بالمسلمين. فعندما يقول لا تحسنوا إلى الكفار يعني أولئك المحاربين. فاحسان المسلمين إليهم هو عين الإساءة لأنفسهم).
العدالة مع الكفار
هل يجب العدل والقسط حتى مع الكفار المحاربين للمسلمين؟ أم ينهانا الله سبحانه عن العدل معهم كما نهانا عن الإحسان إليهم؟
الجواب: ما جاء في بداية سورة المائدة: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) [4] وفي آيات أخرى من القرآن الكريم، إن لمحاربة الكفار حدوداً، فلو تجاوز المسلمين الحد المعين في قتالهم للأعداء، فذلك اعتداء وتجاوز للحدود بتعبير القرآن، يقول تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) [5] .
مثلاً لو رمى العدو سلاحه أرضاً وسلم نفسه لكم، فلا تقتلوهم، ولا تتعرضوا لأطفالهم ونسائهم وشيوخهم وبيوتهم وزرعهم وعيون مائهم. تلك الأوامر التي كان الرسول (ص) يعطيها لجنوده حينما يعزمون على الحرب. فعندما يتعلق الأمر بالعدالة والظلم فإنه يقول: لا تتجاوزوا الحدود مع الكافرين أيضاً ولا تظلموهم واعدلوا معهم.
فتجب مراعاة العدالة على أي حال، والاحسان إلى الكفار بشرط أن يكون له تأثير حسن، أما لو كان له تأثير سيئ ـ على المسلمين ـ فلا يجيزه الإسلام أبداً. فيقول مثلاً: لا تبيعوا سلاحاً للكافر. مع علمكم أو احتمالكم بأن بيع السلاح للكافر يقويه وسيحاربكم به، ولكن لا مانع من بيع شيء للكافر ليس له أثر سيئ[6] .
الإمام الصادق (ع) والرجل الكافر
رأى الإمام الصادق (ع) في سفره رجلاً إلى جانب شجرة في حالة تبين حزنه وتألمه. فقال (ع) لمن معه: لنذهب إلى هناك، كأن لهذا الرجل مشكلة وهو لا يتكلم ولا يطلب العون من أحد. وحينما ذهبوا إليه عرفوا من لباسه أنه رجل غير مسلم: إذ كانوا يلبسون ملابس خاصة يعرفون بها، وقد تبين أن هذا المسكين وحيد في الصحراء وجائع وظمآن. فأمر الإمام (ع) بإعطائه ماءً وطعاماً ونجى من الموت. فقال من كان مع الإمام (ع): إنه كافر، فهل يمكننا أن نعطف على الكافر ونعينه؟ قال (ع) نعم، العطف الذي يوصل له الخير فقط. فإنه لا يضر في شيء، فهل عاديتم المسلمين بالإحسان إلى هذا؟
الإحسان في مقابل الإساءة
هناك آيتان: توصي إحداهما بالإحسان الذي له أثر حسن يقول تعالى: (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) (سورة فصلت، الآية: 34). ويتبين بالقرينة أن المراد هو الإحسان للناس والإساءة إليهم، أي أن الإحسان يختلف عن أثر الإساءة (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) [7] أي لو أساء إليك شخص فأحسن إليه.
يقول سعدي: “اعف أيها الفتى فإن الإنسان يمكنه بالإحسان أن يصطاد ويكبل الوحش”.
من البديهي أن الأوامر الأخلاقية ليست عامة. وأن مواردها مشخصة فمرة يقولون أحسن ليمكنك أن تغير قلب المقابل بالاحسان، فلو أردنا أن نحسن ونعلم بأن أثر هذا الاحسان هو التخلص من العدو وجذبه إلينا. إن أحد موارد صرف الزكاة هم المؤلفة قلوبهم. وهم الكفار الذين أظهروا الإسلام وهم ضعيفو الإيمان، فتجب حمايتهم والحفاظ عليهم بالمحبة والاحسان المالي.
الصبر على اساءة المشركين
والآية الثانية هي: (ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) (سورة آل عمران، الآية: 189).
فالحديث هنا عن الصبر والتقوى، وليس حول الاحسان. فهنا منع عن رد الفعل السيئ، وهو ما يعده البعض عملاً غير منطقي. لكنه بتعبير القرآن من عزم الأمور. أي عمل قائم على أساس العقل والمنطق والعزم، وليس عملاً قائماً على أساس الميول والاحساسات غير المنطقية.
التفسير الصحيح للمحبة
وإن لم يكن المجال مورداً لـ(ادفع بالتي هي أحسن السيئة) (سورة المؤمنون، الآية: 96). بل كان الاحسان سبباً للاساءة للإنسانية، فهنا يأمرنا الإسلام باستعمال القوة، التي أشدها الجهاد في الأمور الجماعية. والقصاص في الأحكام الجزئية. لكن كل هذا ناتج عن حب الخير والصلاح والسعادة للآخرين. وليس استنثاءً من القانون العام في جميع الأديان بأن “أحبب للناس ما تحب لنفسك، وابغض لهم ما تبغض لنفسك” بل هو اختلاف في أسلوب الاحسان.
سابقاً عندما لم يتعود المزارعون على رش السموم في مزارعهم، فكانوا يرون موظف الدولة عدواً لهم، فعندما كان يذهب المسؤولون لرش السموم في المزارع (وهذا العمل لصالح المزارعين وخيرهم) كان المزارعون يعطونهم الرشاوى لكي يغادروا المزارع بدون رش السموم: وكانوا يشترون أدويتهم وسمومهم ثم يدفنونها في مكان بعيد.
فلو كان الناس لحد الآن هكذا، فهل نقول: لا يجب علينا أن نؤذي الآخرين، وبما أنهم يتألمون ويبغضون رش السموم فعلينا أن نفعل ذلك؟ كلاّ، فالمسألة ليست مسألة التألم والانزعاج، بل يجب توعية الناس ولو بالقوة وايصال الخير والصلاح لهم؛ وانهم سيدركون ذلك الخير والصلاح في آخر المطاف.
إذن مسألة الاحسان والمحبة هي احدى المسائل التربوية الإسلامية، بل هي موجودة في جميع الأديان، ولكن بفارق وجوب الدقة في تفسير المحبة والاحسان؛ لكي لا نخلط هذا الاحسان بذلك الاحسان السطحي.
تقوية شعور البحث عن الحقيقة
المسألة الأخرى في باب التربية هي تقوية شعور البحث عن الحقيقة. ويقال: إن هذا الغريزة موجودة عند كل إنسان بنسبة معينة، وأنه متفحص وباحث عن الحقيقة. ويقال، هي التي تدفع الإنسان لطلب العلم وهذا من الغرائز والاحساسات التي يجب تقويتها في الإنسان، ولا داعي لاطالة الكلام هنا: لأن الكل يعلم بأن الإسلام دعا كثيراً لطلب العلم، ويحكي تاريخ الإسلام ـ وايده أشخاص غير معرضين ـ بأن ظهور الحضارة الذي بدأ منذ القرن الأول ـ بل بدات القراءة والكتابة والتعلم والتعليم وتعلم اللغات المختلفة منذ زمن الرسول (ص) وان العلم الذي بدأ بالعلوم الدينية ووصل إلى العلوم الطبيعية والفلسفية والطب وغيره ـ كان أساسه وأصله تشجيع الإسلام ودعوته إلى تحصيل العلم، وكان ذلك أمراً مقدساً عند المسلمين.
التعصب سدّ في طريق العلم
إن التعصب من أهم العقبات التي تحول دون تقدم العلم. ونحن نعلم أن الإسلام حارب التعصب. وتوجد خطبة في نهج البلاغة من أكبر خطب الإمام أمير المؤمنين (ع) تسمى (القاصعة) ومحورها هو التعصب والتكبر، وقد حارب الإمام الأعراب لتعصبهم الشديد، وبين أضرار التعصب وأكد أنه لو كان لابد من تعصب الإنسان لشيء “فليكن تعصبكم لمكارم الخصال” فتعصبوا للفضائل، لا لهذه الأمور، وانه لماذا ادرس عند فلان في حين أنه ابن فلان وأنا ابن فلان، وكان أبوه خادماً لأبي. ان التعصب قسوة وشدة، والقسوة من عدم النضج. ثم يقول: “أيها الكرام ان هذا الكون كشجرة، ونحن فيه كثمار غير ناضجة، ان التعصب والتشدد حمق كشرب دم الطفل الصغير”.
عوامل التربية
بعد أن عرفنا كيف يجب أن يكون الإنسان من وجهة نظر الإسلام، وكيف يكون بنظر العقل والإرادة والبعض العبادي وتربية الجسم وسلامته، وكيف يكون بالنسبة للاحسان، نتحدث عن العوامل التي تحقق هذا الهدف بأفضل نحو، ونشخص العوامل المضادة لها؟ ونذكر عوامل خاصة أكدها الإسلام. وقد ذكرنا سابقاً أن العبادة بنفسها عامل تربوي في النظرة الإسلامية وأنها مدرسة للتربية.
المراقبة والمحاسبة
المسألة التي اريد ذكرها توجد في التعليم والتربية الدينية، ولا توجد في غيرها، بل ولا يمكنها أن توجد. يذكر علماء الأخلاق وتؤكد المتون الإسلامية موضوع المراقبة والمحاسبة، ولا توجد هكذا مفاهيم في التعاليم غير الدينية ولكن بما أن الأساس في التعليم والتربية الدينية هو الله وعبادة الحق، فإن هذه المسائل تطرح في الدين. هناك آية في القرآن الكريم وقد ذكرتها تكراراً، لأننا حينما كنا في الدرس في قم في فترة ما، كان مدرس الأخلاق يهتم كثيراً بهذه الآية وبما أننا سمعناها وفكرها بها كثيراً فقد كان لها وقع خاص في ذهني، وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون)( سورة الحشر ـ الآيتان: 18 ـ 19).
ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قصدي من المراقبة والمحاسبة هو هذه الكلمة. أي أن جميع أعمال الإنسان تعتبر (مقدمة) في القرآن. وكثير من الآيات هي بهذا الصدد (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله)[8] وقد صاغ سعدي هذا المضمون شعراً بقوله: اجمع متاعاً وارسله إلى قبرك، فإن أحداً لن يبعث لك شيئاً بعد ذلك وعليك أن تقدم أنت”.
تعبير التقديم هو من نفس القرآن. فكل أعمال الإنسان هي مقدمات. أي أن الإنسان يرسل متاعاً وبضاعة إلى المحل الذي سيرحل إليه قبل رحيله ثم يلتحق به بعد ذلك. فعليكم أن تنظروا وتدققوا في هذه المقدمات عندما تريدون إرسال شيء إلى مكان معين فإنكم تفحصونه وتتأكدون منه قبل إرساله. فيجب أن تفعلوا مثل ذلك بالنسبة لما تقدمونه لآخرتكم.
ثم يقول: (إن الله خبير بما تعملون) كأنه يريد أن يقول: إنكم لم تنظروا، فهناك عين دقيقة جداً ترى في جميع الأحوال. فقد يرسل الإنسان شيئاً قبل سفره ثم يقول: حسناً فليكن ما يكون ممن ينظر ويدقق؟ فيقال له: كلا، ليس الأمر هكذا. إن الله خبير وعليم بكل ما تفعلون.
قال بعض من كان حاضراً عند السيد البروجردي رضوان الله عليه قبل وفاته بعدة أيام. لقد رأيناه حزيناً جداً وانه قال: وأخيراً انتهى عمرنا وسوف نرحل ولم نستطع أن نقدم لأنفسنا خيراً.
تصور أحد الجالسين المتملقين، أن هناك محلاً للتملق فقال: لماذا تقول هذا يا سيدي؟ نحن المساكين يجب أن نقول هذا، فأنتم تركتم آثاراً خيرة كثيرة بحمد الله وخرّجتم طلاباً كثيرين، وكتبتم كتباً كثيرة، وبنيتم مسجداً عظيماً، ومدارس، فقال السيد: “خلّص العمل فإن الناقد بصير” فماذا تقول أنت؟ انك تصورت أن ما يوجد عند الناس وفي منطقهم هو كذلك عند الله تعالى.
إن الله خبير بما تعملون. وهنا يستفيد علماء الأخلاق المسلمون مسألة مهمة من هذه الآية. “وتلك هي المراقبة” والمراقبة تعني أن تتعامل مع نفسك كشريك لا تطمئن له. ويجب أن تراقبه دائماً. أي اعتبر نفسك كدائرة وأنت المسؤول عنها. فيجب عليك مراقبتها وتفتيشها. أي يجب أن يكون حال الإنسان حال المراقب دائماً.
قلنا أن هناك دستوراً آخر يسمى المحاسبة وجاء ذلك في التعاليم الإسلامية أيضاً. فانظروا إلى نهج البلاغة، وكم لجمله وعباراته. من روح ومعنى؟
يقول أمير المؤمنين (ع):” حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا “[9] . زنوا أنفسكم هنا، وانظروا هل انكم خفاف أم ثقال؟ فان كنتم خفافاً فأنتم لا شيء، وان كنتم ثقالاً فانكم تأمون مكتملون. لا تقولوا: إن الإنسان يمكن أن يمتلئ بالذنوب. لا، بل ان ميزان يوم القيامة طبقاً للقرآن هو ميزان يزن الحسنات فقط؛ فإن كان فيه حسنات فهو ثقيل، وإلا فهو خفيف. (فأما من ثقلت موازينه، فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه، فأمه هاوية). (سورة القارعة، الآيتان: 6 ـ 9).
يعطي الإمام هنا دستوراً عاماً للمحاسبة، وتفسير ذلك في رواياتنا هو: “ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كل يوم”. فالمحاسبة في عمل الإنسان هي من امتيازات الإسلام. وقد ألفت كتب في مجال محاسبة النفس. ومنها كتاب “محاسبة النفس” للسيد ابن طاووس ومثله للكفعمي، وقد طرحت مسألة مراقبة النفس ومحاسبتها في أغلب أو جميع الكتب الأخلاقية الإسلامية.
المشارطة، المعاتبة، المعاقبة
لو أراد الإنسان تربية نفسه إسلامياً، فالشرط الأول هو المراقبة. ولكن يقال ان هناك شيئاً قبل المراقبة والمحاسبة وشيئاً بعدها. فقبل المراقبة “المشارطة” أي على الإنسان أن يقطع عهداً على نفسه. لأنه إن لم تحصل المشارطة أولاً، ولم يجعل لنفسه برنامجاً فانه سوف لا يعرف كيف يراقب نفسه. فليتعهد مع نفسه في البداية على تحديد طعامه نوعاً وكماً، وتحديد نومه، وكلامه، وما يجب أن يقوم به لنفسه، وما يجب أن يقوم به لخلق الله. وعلى كيفية تقسيم أوقاته. فإنه يشخص هذه الأمور في ذهنه، ويعاهد نفسه بأن يعمل طبقاً لهذا البرنامج، وبعد ذلك يراقب نفسه دائماً ويحاسبها على فعل ما تعهدت به، مرة في كل يوم وليلة، فإن كل قد عمل بتعهداته، تأتي مرحلة الشكر والحمد لله والسجود شكراً له. وان لم يفعل. تأتي مسألة المعاتبة وتعني لوم النفس إذا كانت المخالفة قليلة، وتأتي المعاقبة عندما تزداد المخالفة والعقوبة تكون بالصوم وبالأعمال الشاقة والصعبة، وهذه من الأصول المسلمة في الأخلاق والتربية الإسلامية.
——————————————————————————–
[1] التعاليم المسيحية هنا هي تعاليم القساوسة والرهبان، وليست تعاليم عيسى (ع).
[2] سورة البقرة، الآية: 179.
[3] سورة الممتحنة، الآيتان: 8 ـ 9.
[4] سورة المائدة، من الآية: 8.
[5] سورة البقرة، من الآية: 190.
[6] ولا يختص بالسلاح، بل يشمل كل ما يقوي بنية الكافر.
[7] سورة فصلت، الآية: 34.
[8] سورة البقرة، من الآية: 110.
[9] نهج البلاغة، من الخطبة: 89.
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله