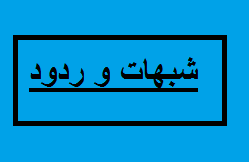ـ تفسير الميزان للطباطبائي ج 8 ص 305 ـ 331
قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا . . . .
أخذ الشيء من الشيء يوجب انفصال المأخوذ من المأخوذ منه واستقلاله دونه بنحو من الاَنحاء ، وهو يختلف باختلاف العنايات المتعلقة بها والاِعتبارات المأخوذة فيها كأخذ اللقمة من الطعام وأخذ الجرعة من ماء القدح ، وهو نوع من الاَخذ ، وأخذ المال والاَثاث من زيد الغاصب ، أو الجواد أو البائع أو المعير ، وهو نوع آخر ، أو أنواع مختلفة أخرى ، وكأخذ العلم من العالم وأخذ الاَهبة من المجلس وأخذ الحظ من لقاء الصديق ، وهو نوع ، وأخذ الولد من والده للتربية ، وهو نوع .. إلى غير ذلك .
( 39 )
فمجرد ذكر الاَخذ من الشيء لا يوضح نوعه إلا ببيان زائد ، ولذلك أضاف الله سبحانه إلى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم الدال على تفريقهم وتفصيل بعضهم من بعض : قوله من ظهورهم ، ليدل على نوع الفصل والاَخذ ، وهو أخذ بعض المادة منها بحيث لا تنقص المادة المأخوذ منها بحسب صورتها ولا تنقلب عن تمامها واستقلالها ، ثم تكميل الجزء المأخوذ شيئاً تاماً مستقلاً من نوع المأخوذ منه ، فيؤخذ الولد من ظهر من يلده ويولده وقد كان جزء ، ثم يجعل بعد الاَخذ والفصل إنساناً تاماً مستقلاً من والديه بعد ما كان جزء منهما . ثم يؤخذ من ظهر هذا المأخوذ مأخوذ آخر وعلى هذه الوتيرة حتى يتم الاَخذ وينفصل كل جزء عما كان جزء منه ويتفرق الاَناسي وينتشر الاَفراد وقد استقل كل منهم عمن سواه ، ويكون لكل واحد منهم نفس مستقلة لها ما لها وعليها ما عليها .
فهذا مفاد قوله : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، ولو قال أخذ ربك من بني آدم ذريتهم أو نشرهم ونحو ذلك ، بقي المعنى على إبهامه .
وقوله : وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، ينبيء عن فعل آخر إلَهي تعلق بهم بعد ما أخذ بعضهم من بعض ، وفصل بين كل واحد منهم وغيره ، وهو إشهادهم على أنفسهم ، والاِشهاد على الشيء هو إحضار الشاهد عنده وإراءته حقيقته ليتحمله علماً تحملاً شهودياً ، فإشهادهم على أنفسهم هو إراءتهم حقيقة أنفسهم ليتحملوا ما أريد تحملهم من أمرها ، ثم يؤدوا ما تحملوه إذا سئلوا .
وللنفس في كل ذي نَفَس جهات من التعلق والاِرتباط بغيرها يمكن أن يستشهد الاِنسان على بعضها دون بعض ، غير أن قوله : ألست بربكم ، يوضح ما أشهدوا لاَجله وأريد شهادتهم عليه ، وهو أن يشهدوا ربوبيته سبحانه لهم فيؤدوها عند المسألة .
فالاِنسان وإن بلغ من الكبر والخيلاء ما بلغ وغرته مساعدة الاَسباب ما غرته واستهوته ، لا يسعه أن ينكر أنه لا يملك وجود نفسه ولا يستقل بتدبير أمره ، ولو
( 40 )
ملك نفسه لوقاها مما يكرهه من الموت وسائر آلام الحياة ومصائبها ، ولو استقل بتدبير أمره لم يفتقر إلى الخضوع قبال الاَسباب الكونية والوسائل التي يرى لنفسه أنه يسودها ويحكم فيها ، ثم هي كالاِنسان في الحاجة إلى ماوراءها والاِنقياد إلى حاكم غائب عنها يحكم فيها لها أو عليها ، وليس إلى الاِنسان أن يسد خلتها ويرفع حاجتها.
فالحاجة إلى رب مالك مدبر حقيقة الاِنسان ، والفقر مكتوب على نفسه ، والضعف مطبوع على ناصيته ، لا يخفى ذلك على إنسان له أدنى الشعور الاِنساني ، والعالم والجاهل والصغير والكبير والشريف والوضيع في ذلك سواء . فالاِنسان في أي منزل من منازل الاِنسانية نزل ، يشاهد من نفسه أن له رباً يملكه ويدبر أمره ، وكيف لا يشاهد ربه وهو يشاهد حاجته الذاتية ، وكيف يتصور وقوع الشعور بالحاجة من غير شعور بالذي يحتاج إليه .
فقوله : ألست بربكم بيان ما أشهد عليه ، وقوله : قالوا بلى شهدنا ، اعتراف منهم بوقوع الشهادة وما شهدوه .
ولذا قيل إن الآية تشير إلى ما يشاهده الاِنسان في حياته الدنيا أنه محتاج في جميع جهات حياته من وجوده وما يتعلق به وجوده من اللوازم والاَحكام ، ومعنى الآية إنا خلقنا بني آدم في الاَرض وفرقناهم وميزنا بعضهم من بعض بالتناسل والتوالد وأوقفناهم على احتياجهم ومربوبيتهم لنا ، فاعترفوا بذلك قائلين بلى شهدنا أنك ربنا . وعلى هذا يكون قولهم بلى شهدنا من قبيل القول بلسان الحال أو إسناداً للازم القول إلى القائل بالملزوم ، حيث اعترفوا بحاجاتهم ولزمهم الاِعتراف بمن يحتاجون إليه .
والفرق بين لسان الحال والقول بلازم القول ، أن الاَول انكشاف المعنى عن الشيء لدلالة صفه من صفاته وحال من أحواله عليه ، سواء شعر به أم لا ، كما تفصح آثار الديار الخربة عن حال ساكنيها وكيف لعب الدهر بهم وعدت عادية الاَيام عليهم فأسكنت أجراسهم وأخمدت أنفاسهم ، وكما يتكلم سيماء البائس المسكين عن
( 41 )
فقره ومسكنته وسوء حاله . والثاني انكشاف المعنى عن القائل لقوله بما يستلزمه أو تكلمه بما يدل عليه بالاِلتزام .
فعلى أحد هذين النوعين من القول أعني القول بلسان الحال والقول بالاِستلزام يحمل اعترافهم المحكي بقوله تعالى : قالوا بلى شهدنا ، والاَول أقرب وأنسب فإنه لا يكتفي في مقام الشهادة إلا بالصريح منها المدلول عليه بالمطابقة دون الاِلتزام .
ومن المعلوم أن هذه الشهادة على أي نحو تحققت فهي من سنخ الاِستشهاد المذكور في قوله : ألست بربكم ، فالظاهر أنه قد استوفى الجواب بعين اللسان الذي سألهم به ، ولذلك كان هناك نحو ثالث يمكن أن تحمل عليه هذه المساءلة والمجاوبة ، فإن الكلام الاِلَهي يكشف به عن المقاصد الاِلَهية بالفعل والاِيجاد ، كلام حقيقي ، وإن كان بنحو التحليل كما تقدم مراراً في مباحثنا السابقة فليكن هنا قوله : ألست بربكم ، وقولهم : بلى شهدنا ، من ذاك القبيل ، وسيجيء للكلام تتمة .
وكيف كان ، فقوله : وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية يدل على تفصيل بني آدم بعضهم من بعض وإشهاد كل واحد منهم على نفسه ، وأخذ الاِعتراف على الربوبية منه ، ويدل ذيل الآية وما يتلوه أعني قوله : أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ، على الغرض من هذا الاَخذ والاِشهاد . و هو على ما يفيده السياق إبطال حجتين للعباد على الله ، وبيان أنه لولا هذا الاَخذ والاِشهاد وأخذ الميثاق على انحصار الربوبية كان للعباد أن يتمسكوا يوم القيامة بإحدى حجتين يدفعون بها تمام الحجة عليهم في شركهم بالله والقضاء بالنار على ذلك من الله سبحانه .
والتدبر في الآيتين وقد عطفت إحدى الحجتين على الاَخرى بأو الترديدية ، وبنيت الحجتان جميعاً على العلم اللازم للاِشهاد ، ونقلتا جميعاً عن بني آدم المأخوذين المفرقين ، يعطي أن الحجتين كل واحدة منهما مبنيه على تقدير من تقديري عدم الاِشهاد كذلك .
( 42 )
والمراد إنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم وأشهدناهم على أنفسهم فاعترفوا بربوبيتنا فتمت لنا الحجة عليهم يوم القيامة ، ولو لم نفعل هذا ولم نشهد كل فرد منهم على نفسه بعد أخذه فإن كنا أهملنا الاِشهاد من رأس ، فلم يشهد أحد نفسه وأن الله ربه ، ولم يعلم به ، لاَقاموا جميعاً الحجة علينا يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين في الدنيا عن ربوبيتنا ، ولا تكليف على غافل ولا مؤاخذة ، وهو قوله تعالى : أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين .
وإن كنا لم نهمل أمر الاِشهاد من رأس وأشهدنا بعضهم على أنفسهم دون بعض ، بأن أشهدنا الآباء على هذا الاَمر الهام العظيم دون ذرياتهم ثم أشرك الجميع كان شرك الآباء شركاً عن علم بأن الله هو الرب لا رب غيره ، فكانت معصية منهم ، وأما الذرية فإنما كان شركهم بمجرد التقليد فيما لا سبيل لهم إلى العلم به لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، ومتابعة عملية محضة لآبائهم ، فكان آباؤهم هم المشركون بالله العاصون في شركهم لعلمهم بحقيقة الاَمر ، وقد قادوا ذريتهم الضعاف في سبيل شركهم بتربيتهم عليه وتلقينهم ذلك ، ولا سبيل لهم إلى العلم بحقيقة الاَمر وإدراك ضلال آبائهم وإضلالهم إياهم ، فكانت الحجة لهؤلاء الذرية على الله يوم القيامة لاَن الذين أشركوا وعصوا بذلك وأبطلوا الحق هم الآباء فهم المستحقون للمؤاخذة والفعل فعلهم ، وأما الذرية فلم يعرفوا حقاً حتى يؤمروا به فيعصوا بمخالفته فهم لم يعصوا شيئاً ولم يبطلوا حقاً ، وحينئذ لم تتم حجة على الذرية فلم تتم الحجة على جميع بني آدم . وهذا معنى قوله تعالى : أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون .
فإن قلت : هنا بعض تقادير أخر لا يفي بها البيان السابق ، كما لو فرض إشهاد الذرية على أنفسهم دون الآباء مثلاً ، أو إشهاد بعض الذرية مثلاً ، كما أن تكامل النوع الاِنساني في العلم و الحضارة على هذه الوتيرة يرث كل جيل ما تركه الجيل السابق ويزيد عليه بأشياء ، فيحصل للاحق ما لم يحصل للسابق .
( 43 )
قلت : على أحد التقديرين المذكورين تتم الحجة على الذرية أو على بعضهم الذين أشهدوا ، وأما الآباء الذين لم يشهدوا فليس عندهم إلا الغفلة المحضة عن أمر الربوبية ، فلا يستقلون بشرك إذ لم يشهدوا ، ولا يسع لهم التقليد إذ لم يسبق عليهم فيه سابق ، كما في صورة العكس فيدخلون تحت المحتجين بالحجة الاَولى ( إنا كنا عن هذا غافلين ) .
وأما حديث تكامل الاِنسان في العلم والحضارة تدريجاً فإنما هو في العلوم النظرية الاِكتسابية التي هي نتائج وفروع تحصل للاِنسان شيئاً فشيئاً ، وأما شهود الاِنسان نفسه وأنه محتاج إلى رب يربه فهو من مواد العلم التي إنما تحصل قبل النتائج ، وهو من العلوم الفطرية التي تنطبع في النفس انطباعاً أولياً ثم يتفرع عليها الفروع . وما هذا شأنه لا يتأخر عن غيره حصولاً ، وكيف لا ونوع الاِنسان إنما يتدرج إلى معارفه وعلومه عن الحس الباطني بالحاجة ، كما قرر في محله .
فالمتحصل من الآيتين أن الله سبحانه فصل بين بني آدم بأخذ بعضهم من بعض ، ثم أشهدهم جميعاً على أنفسهم وأخذ منهم الميثاق بربوبيته ، فهم ليسوا بغافلين عن هذا المشهد وما أخذ منهم من الميثاق ، حتى يحتج كلهم بأنهم كانوا غافلين عن ذلك لعدم معرفتهم بالربوبية ، أو يحتج بعضهم بأنه إنما أشرك وعصى آباؤهم وهم برآء .
ولذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد بهذا الظرف المشار إليه بقوله : وإذ أخذ ربك ، هو الدنيا والآيتان تشيران إلى سنة الخلقة الاِلَهية الجارية على الاِنسان في الدنيا ، فإن الله سبحانه يخرج الذرية الاِنسانية من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم ومنها إلى الدنيا ، ويشهدهم في خلال حياتهم على أنفسهم ويريهم آثار صنعه وآيات وحدانيته ووجوه احتياجاتهم المستغرقة لهم من كل جهة ، الدالة على وجوده ووحدانيته ، فكأنه يقول لهم عند ذلك ألست بربكم ، وهم يجيبونه بلسان حالهم بلى شهدنا بذلك وأنت ربنا لا رب غيرك ، وإنما فعل الله سبحانه ذلك لئلا يحتجوا على
( 44 )
الله يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين عن المعرفة ، أو يحتج الذرية بأن آباءهم هم الذين أشركوا وأما الذرية فلم يكونوا عارفين بها وإنما هم ذرية من بعدهم نشأوا على شركهم من غير ذنب .
وقد طرح القوم عدة من الروايات تدل على أن الآيتين تدلان على عالم الذر ، وأن الله أخرج ذرية آدم من ظهره فخرجوا كالذر فأشهدهم على أنفسهم وعرفهم نفسه ، وأخذ منهم الميثاق على ربوبيته ، فتمت بذلك الحجة عليهم يوم القيامة . وقد ذكروا وجوهاً في إبطال دلالة الآيتين عليه وطرح الروايات بمخالفتها لظاهر الكتاب .
1 ـ أنه لا يخلو إما أنه جعل الله هذه الذرية المستخرجة من صلب آدم عقلاء أو لم يجعلهم كذلك ، فإن لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أن يعرفوا التوحيد وأن يفهموا خطاب الله تعالى ، وإن جعلهم عقلاء وأخذ منهم الميثاق وبنى صحة التكليف على ذلك وجب أن يذكروا ذلك ولا ينسوه ، لاَن أخذ الميثاق إنما تتم الحجة به على المأخوذ منه إذا كان على ذكر منه من غير نسيان ، كما ينص عليه قوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . ونحن لا نذكر وراء ما نحن عليه من الخلقة الدنيوية الحاضرة شيئاً ، فليس المراد بالآية إلا موقف الاِنسان في الدنيا وما يشاهده فيه من حاجته إلى رب يملكه ويدبر أمره وهو رب كل شيء .
2 ـ أنه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير والجم الغفير من العقلاء أمراً قد كانوا عرفوه وميزوه حتى لا يذكره ولا واحد منهم ، وليس العهد به بأطول من عهد أهل الجنة بحوادث مضت عليهم في الدنيا وهم يذكرون ما وقع عليهم في الدنيا كما يحكيه تعالى في مواضع من كلامه كقوله : قال قائل منهم إني كان لي قرين ، إلى آخر الآيات : الصافات ـ 51 وقد حكى نظير ذلك عن أهل النار كقوله : وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الاَشرار . صَ ـ 62 إلى غير ذلك من الآيات .
ولو جاز النسيان على هؤلاء الجماعة مع هذه الكثرة لجاز أن يكون الله سبحانه قد كلف خلقه فيما مضى من الزمن ثم أعادهم ليثيبهم أو ليعاقبهم جزاء لاَعمالهم في
( 45 )
الخلق الاَول وقد نسوا ذلك ، ولازم ذلك صحة قول التناسخية أن المعاد إنما هو خروج النفس عن بدنها ثم دخولها في بدن آخر لتجد في الثاني جزاء الاَعمال التي عملتها في الاَول .
3 ـ ما أورد على الاَخبار الناطقة بأن الله سبحانه أخذ من صلب آدم ذريته وأخذ منهم الميثاق بأن الله سبحانه قال : أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم ، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهره ، وقال ذريتهم ولم يقل ذريته ، ثم أخبر بأنه إنما فعل بهم ذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، الآية . وهذا يقتضي أن يكون لهم آباء مشركون فلا يتناول ظاهر الآية أولاد آدم لصلبه .
ومن هنا قال بعضهم إن الآية خاصة ببعض بني آدم غير عامة لجميعهم ، فإنها لا تشمل آدم وولده لصلبه وجميع المؤمنين ، ومن المشركين من ليس له آباء مشركون ، بل تختص بالمشركين الذين لهم سلف مشرك .
4 ـ إن تفسير الآية بعالم الذر ينافي قولهم كما في الآية : إنما أشرك آباؤنا لدلالته على وجود آباء لهم مشركين ، وهو ينافي وجود الجميع هناك بوجود واحد جمعي .
5 ـ ما ذكره بعضهم أن الروايات مقبولة مسلمة غير أنها ليست بتأويل للآية ، والذي تقصه من حديث عالم الذر إنما هو أمر فعله الله سبحانه ببني آدم قبل وجودهم في هذه النشأة ليجروا بذلك على الاَعراق الكريمة في معرفة ربوبيته ، كما روي أنهم ولدوا على الفطرة ، وكما قيل إن نعيم الاَطفال في الجنة ثواب إيمانهم بالله في عالم الذر . وأما الآية فليست تشير إلى ما تشير إليه الروايات ، فإن الآية تذكر أنه إنما فعل بهم ذلك لتنقطع به حجتهم يوم القيامه : إنا كنا عن هذا غافلين ، ولو كان المراد به ما فعل بهم في عالم الذر لكان لهم أن يحتجوا على الله فيقولوا ربنا إنك أشهدتنا على أنفسنا يوم أخرجتنا من صلب آدم فكنا على يقين بأنك ربنا ، كما أنا اليوم وهو يوم القيامة على يقين من ذلك لكنك أنسيتنا موقف الاِشهاد في الدنيا التي
( 46 )
هي موطن التكليف والعمل ووكلتنا إلى عقولنا ، فعرف ربوبيتك من عرفها بعقله وأنكرها من أنكرها بعقله ، كل ذلك بالاِستدلال ، فما ذنبنا في ذلك وقد نزعت منا عين المشاهدة وجهزتنا بجهاز شأنه الاِستدلال وهو يخطيء ويصيب .
6 ـ أن الآية لا صراحة لها فيما تدل عليه الروايات لاِمكان حملها على التمثيل ، وأما الروايات فهي إما مرفوعة أو موقوفة ولا حجية فيها.
هذه جملة ما أوردوه على دلالة الآية وحجية الروايات ، وقد زيفها المثبتون لنشأة الذر وهم عامة أهل الحديث وجمع من غيرهم من المفسرين بأجوبة :
فالجواب عن الاَول ، أن نسيان الموقف وخصوصياته لا يضر بتمام الحجة وإنما المضر نسيان أصل الميثاق وزوال معرفة وحدانية الرب تعالى وهو غير منسي ولا زائل عن النفس ، وذلك يكفي في تمام الحجة ، ألا ترى أنك إذا أردت أن تأخذ ميثاقاً من زيد فدعوته إليك وأدخلته بيتك وأجلسته مجلس الكرامة ثم بشرته وأنذرته ما استطعت ولم تزل به حتى أرضيته فأعطاك العهد وأخذت منه الميثاق ، فهو مأخوذ بميثاقه مادام ذاكراً لاَصله وإن نسي حضوره عندك ودخوله بيتك وجميع ما جرى بينك وبينه وقت أخذ الميثاق ، غير أصل العهد .
والجواب عن الثاني ، أن الاِمتناع من تجويز نسيان الجمع الكثير لذلك مجرد استبعاد من غير دليل على الاِمتناع ، مضافاً إلى أن أصل المعرفة بالربوبية مذكور غير منسي كما ذكرنا وهو يكفي في تمام الحجة ، وأما حديث التناسخية فليس الدليل على امتناع التناسخ منحصراً في استحالة نسيان الجماعة الكثيرة ما مضى عليهم في الخلق الاَول ، حتى لو لم يستحل ذلك صح القول بالتناسخ ، بل لاِبطال القول به دليل آخر كما يعلم بالرجوع إلى محله ، وبالجملة لا دليل على استحالة نسيان بعض العوالم في بعض آخر .
والجواب عن الثالث ، أن الآية غير ساكتة عن إخراج ولد آدم لصلبه من صلبه فإن قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم ، كاف وحده في الدلالة عليه فإن فرض بني
( 47 )
آدم فرض إخراجهم من صلب آدم من غير حاجة إلى مؤونة زائدة ، ثم إخراج ذريتهم من ظهورهم بإخراج أولاد الاَولاد من صلب الاَولاد وهكذا ، ويتحصل منه أن الله أخرج أولاد آدم لصلبه من صلبه ثم أولادهم من أصلابهم ثم أولاد أولادهم من أصلاب أولادهم حتى ينتهى إلى آخرهم ، نظير ما يجري عليه الاَمر في هذه النشأة الدنيوية التي هي نشأة التوالد والتناسل .
وقد أجاب الرازي عنه في تفسيره بأن الدلالة على إخراج أولاده لصلبه من صلبه من ناحية الخبر ، كما أن الدلالة على إخراج أولاد أولاده من أصلاب آبائهم من ناحية الآية ، فبمجموع الآية والخبر تتم الدلالة على المجموع ، وهو كما ترى .
وأما الاَخبار المشتملة على ذكر إخراج ذرية آدم من صلبه وأخذ الميثاق منهم ، فهي في مقام شرح القصة لا في مقام تفسير ألفاظ الآية حتى يورد عليها بعدم موافقه الكتاب أو مخالفته . وأما عدم شمول الآية لاَولاد آدم من صلبه لعدم وجود آباء مشركين لهم وكذا بعض من عداهم فلا يضر شيئاً ، لاَن مراد الآية أن الله سبحانه إنما فعل ذلك لئلا يقول المشركون يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا لا أن يقول كل واحد واحد منهم إنما أشرك آبائي ، فهذا مما لم يتعلق به الغرض البتة ، فالقول قول المجموع من حيث المجموع لا قول كل واحد ، فيؤول المعنى إلى أنا لولم نفعل ذلك لكان كل من أردنا إهلاكه يوم القيامة يقول لم أشرك أنا وإنما أشرك من كان قبلي ولم أكن إلا ذرياً وتابعاً لا متبوعاً .
والجواب عن الرابع ، يظهر من الجواب عن سابقه ، قد دلت الآية والرواية على أن الله فصل هناك بين الآباء والاَبناء ثم ردهم إلى حال الجمع .
والجواب عن الخامس ، أنه خلاف ظاهر بعض الروايات وخلاف صريح بعض آخر منها ، وما في ذيله من عدم تمام الحجة من جهة عروض النسيان ، ظهر الجواب عنه من الجواب عن الاِشكال الاَول .
والجواب عن السادس ، أن استقرار الظهور في الكلام كاف في حجيته ، ولا
( 48 )
يتوقف ذلك على صفة الصراحة ، وإمكان الحمل على التمثيل لا يوجب الحمل عليه ما لم يتحقق هناك مانع عن حمله على ظاهره ، وقد تبين أن لا مانع من ذلك .
وإما أن الروايات ضعيفة لا معول عليها فليس كذلك ، فإن فيها ما هو الصحيح وفيها ما يوثق بصدوره كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، في البحث الروائي التالي .
هذا ملخص ما جرى بينهم من البحث فيما استفيد من الآية من حديث عالم الذر إثباتاً ونفياً ، واعتراضاً وجواباً . واستيفاء التدبر في الآية والروايات ، والتأمل فيما يرومه المثبتون بإثباتهم ويدفعه المنكرون بإنكارهم ، يوجب توجيه البحث إلى جهة أخرى غير ما تشاجر فيه الفريقان بإثباتهم ونفيهم .
فالذي فهمه المثبتون من الرواية ثم حملوه على الآية وانتهضوا لاِثباته محصله : أن الله سبحانه بعد ما خلق آدم إنساناً تاماً سوياً أخرج نطفه التي تكونت في صلبه ثم صارت هي بعينها أولاده الصلبيين إلى الخارج من صلبه ، ثم أخرج من هذه النطف نطفها التي ستتكون أولاداً له صلبيين ففصل بين أجزائها والاَجزاء الاَصلية التي اشتقت منها ، ثم من أجزاء هذه النطف أجزاء أخرى هي نطفها ثم من أجزاء الاَجزاء أجزاءها ، ولم يزل حتى أتى آخر جزء مشتق من الاَجزاء المتعاقبة في التجزي . وبعبارة أخرى : أخرج نطفة آدم التي هي مادة البشر ووزعها بفصل بعض أجزائه من بعض إلى ما لا يحصى من عدد بني آدم بحذاء كل فرد ما هو نصيبه من أجزاء نطفة آدم ، وهي ذرات منبثة غير محصورة ، ثم جعل الله سبحانه هذه الذرات المنبثة عند ذلك أو كان قد جعلها قبل ذلك كل ذرة منها إنساناً تاماً في إنسانيته هو بعينه الاِنسان الدنيوي الذي هو جزء المقدم له ، فالجزء الذي لزيد هناك هو زيد هذا بعينه والذي لعمرو هو عمرو هذا بعينه ، فجعلهم ذوي حياة وعقل و جعل لهم ما يسمعون به وما يتكلمون به وما يضمرون به معاني فيظهرونها أو يكتمونها ، وعند ذلك عرفهم نفسه فخاطبهم فأجابوه وأعطوه الاِقرار بالربوبية ، إما بموافقة ما في ضميرهم لما في لسانهم أو بمخالفة ذلك .
( 49 )
ثم إن الله سبحانه ردهم بعد أخذ الميثاق إلى مواطنهم من الاَصلاب حتى اجتمعوا في صلب آدم وهي على حياتها ومعرفتها بالربوبية وإن نسوا ما وراء ذلك مما شاهدوه عند الاِشهاد وأخذ الميثاق ، وهم بأعيانهم موجودون في الاَصلاب حتى يؤذن لهم في الخروج إلى الدنيا فيخرجون ، وعندهم ما حصلوه في الخلق الاَول من معرفة الربوبية ، و هي حكمهم بوجود رب لهم من مشاهدة أنفسهم محتاجة إلى من يملكهم ويدبر أمرهم .
هذا ما يفهمه القوم من الخبر والآية ويرومون إثباته وهو مما تدفعه الضرورة وينفيه القرآن والحديث بلا ريب ، وكيف الطريق إلى اثبات أن ذرة من ذرات بدن زيد وهو الجزء الذري الذي انتقل من صلب آدم من طريق نطفته إلى ابنه ثم إلى ابن ابنه حتى انتهى إلى زيد هو زيد بعينه وله إدراك زيد وعقله وضميره وسمعه وبصره ، وهو الذي يتوجه إليه التكليف وتتم له الحجة ويحمل عليه العهود والمواثيق ويقع عليه الثواب والعقاب ، وقد صح بالحجة القاطعة من طريق العقل والنقل أن إنسانية الاِنسان بنفسه التي هي أمر وراء المادة حادث بحدوث هذا البدن الدنيوي ، وقد تقدم شطر من البحث فيها .
على أنه قد ثبت بالبحث القطعي أن هذه العلوم التصديقية البديهية والنظرية ، ومنها التصديق بأن له رباً يملكه ويدبر أمره ، تحصل للاِنسان بعد حصول التطورات ، والجميع تنتهي إلى الاِحساسات الظاهرة والباطنة ، وهي تتوقف على وجود التركيب الدنيوي المادي ، فهو حال العلوم الحصولية التي منها التصديق بأن له رباً هو القائم برفع حاجته .
على أن هذه الحجة إن كانت متوقفة في تمامها على العقل والمعرفة معاً فالعقل مسلوب عن الذرة حين أرجعت إلى موطنها الصلبي حتى تظهر ثانياً في الدنيا ، وإن قيل إنه لم يسلب عنها ما تجري في الاَصلاب والاَرحام فهو مسلوب عن الاِنسان ما بين ولادته وبلوغه أعني أيام الطفولية ، ويختل بذلك أمر الحجة على الاِنسان وإن
( 50 )
كانت غير متوقفة عليه ، بل يكفي في تمامها مجرد حصول المعرفة ، فأي حاجة إلى الاِشهاد وأخذ الميثاق ، وظاهر الآية أن الاِشهاد وأخذ الميثاق إنما هما لاَجل إتمام الحجة ، فلا محالة يرجع معنى الآية إلى حصول المعرفة فيؤول المعنى إلى ما فسرها به المنكرون .
وبتقرير آخر إن كانت الحجة إنما تتم بمجموع الاِشهاد والتعريف وأخذ الميثاق سقطت بنسيان البعض وقد نسي الاِشهاد والتكليم وأخذ الميثاق ، وإن كان الاِشهاد وأخذ الميثاق جميعاً مقدمة لثبوت المعرفة ثم زالت المقدمة ولزمت المعرفة وبها تمام الحجة ، تمت الحجة على كل إنسان حتى الجنين والطفل والمعتوه والجاهل ، ولا يساعد عليه عقل ولا نقل ، وإن كانت المعرفة في تمام الحجة بها متوقفة على حصول العقل والبلوغ ونحو ذلك وقد كانت حصلت في عالم الذر فتمت الحجة ثم زالت وبقيت المعرفة حجة ناقصة ثم كملت ثانياً لبعضهم في الدنيا فتمت الحجة ثانياً بالنسبة إليهم ، فكما أن لحصول العقل في الدنيا أسباباً تكوينية يحصل بها وهي الحوادث المتكررة من الخير والشر ، وحصول الملكة المميزة بينهما من التجارب حصولاً تدريجياً ينتهي من جانب إلى حد من الكمال ومن جانب إلى حد من الضعف لا يعبأ به ، كذلك المعرفة لها أسباب إعدادية تهيَ الاِنسان إلى التلبس بها وليست تحصل قبل ذلك ، وإذا كانت تحصل في ظرفنا هذا بأسبابها المعدة لها كالعقل ، فأي حاجة إلى تكوينه تكويناً آخر في سالف من الزمان لاِتمام الحجة والحجة تامة دونه وماذا يغني ذلك .
على أن هذا العقل الذي لا تتم حجة ولا ينفع إشهاد ولا يصح أخذ ميثاق بدونه حتى في عالم الذر ، المفروض هو العقل العملي الذي لا يحصل للاِنسان إلا في هذا الظرف الذي يعيش فيه عيشة اجتماعية فتتكرر عليه حوادث الخير والشر وتهيج عواطفه وإحساساته الباطنية نحو جلب النفع ودفع الضرر فتتعاقب عليه الاَعمال عن
( 51 )
علم وإرادة فيخطيء ويصيب ، حتى يتدرب في تمييز الصواب من الخطأ والخير من الشر والنفع من الضر .
والظرف الذي يثبتونه أعني ما يصفونه من عالم الذر ليس بموطن العقل العملي إذ ليس فيه شرائط حصوله وأسبابه ، ولو فرضوه موطناً له وفيه أسبابه وشرائطه كما يظهر مما يصفونه تعويلاً على ما في ظواهر الروايات أن الله دعاهم هناك إلى التوحيد فأجابه بعضهم بلسان يوافقه قلبه وأجابه آخرون وقد أضمروا الكفر وبعث إليهم الاَنبياء والاَوصياء فصدقهم بعض وكذبهم آخرون ، ولا يجري ما هاهنا إلا على ما جرى به ما هنالك ، إلى غير ذلك مما ذكروه ، كان ذلك إثباتاً لنشأة طبيعية قبل هذه النشأة الطبيعية في الدنيا نظير ما يثبته القائلون بالاَدوار والاَكوار ، واحتاج إلى تقديم كينونة ذرية أخرى تتم بها الحجة على من هنالك من الاِنسان ، لاَن عالم الذر على هذه الصفة لا يفارق هذا العالم الحيوي الذي نحن فيه الآن ، فلو احتاج هذا الكون الدنيوي إلى تقديم إشهاد وتعريف حتى تحصل المعرفة وتتم الحجة لاحتاج إليه الكون الذري من غير فرق فارق البتة .
على أن الاِنسان لو احتاج في تحقق المعرفة في هذه النشأة الدنيوية إلى تقدم وجود ذري يقع فيه الاِشهاد ويوجد فيه الميثاق حتى تثبت بذلك المعرفة بالربوبية ، لم يكن في ذلك فرق بين إنسان وإنسان ، فما بال آدم وحواء استثنيا من هذه الكلية ، فإن لم يحتاجا إلى ذلك لفضل فيهما أو لكرامة لهما ففي ذريتهما من هو أفضل منهما وأكرم ، وإن كان لتمام خلقتهما يومئذ فأثبتت فيهما المعرفة من غير حاجة إلى إحضار الوجود الذري ، فلكل من ذريتهما أيضاً خلقة تامة في ظرفه الخاص به ، فلم لم يؤخر إثبات المعرفة فيهم ولهم إلى تمام خلقتهم بالولادة حتى تتم عند ذلك الحجة ، وأي حاجة إلى التقديم .
فهذه جهات من الاِشكال في تحقق الوجود الذري للاِنسان على ما فهموه من الروايات لا طريق إلى حلها بالاَبحاث العلمية ، ولا حمل الآية عليه معها حتى بناء
( 52 )
على عادة القوم في تحميل المعنى على الآية إذا دلت عليه الرواية وإن لم يساعد عليه لفظ الآية ، لاَن الرواية القطعية الصدور كالآية مصونة عن أن تنطق بالمحال .
وأما الحشوية وبعض المحدثين ممن يبطل حجة العقل الضرورية قبال الرواية ويتمسك بالآحاد في المعارف اليقينية ، فلا بحث لنا معهم .
هذا ما على المثبتين. بقي الكلام فيما ذكره النافون أن الآية تشير إلى ما عليه حال الاِنسان في هذه الحياة الدنيا ، وهو أن الله سبحانه أخرج كلا من آحاد الاِنسان من الاَصلاب والاَرحام إلى مرحلة الاِنفصال والتفرق وركب فيهم ما يعرفون به ربوبيته واحتياجهم إليه كأنه قال لهم إذا وجه وجوههم نحو أنفسهم المستغرقة في الحاجة : ألست بربكم ، وكأنهم لما سمعوا هذا الخطاب من لسان الحال قالوا : بلى أنت ربنا شهدنا بذلك ، وإنما فعل الله ذلك لتتم عليهم حجته بالمعرفة وتنقطع حجتهم عليه بعدم المعرفة ، وهذا ميثاق مأخوذ منهم طول الدنيا جار ما جرى الدهر والاِنسان يجري معه .
والآية بسياقها لا تساعد عليه ، فإنه تعالى افتتح الآية بقوله : وإذ أخذ ربك الآية ، فعبر عن ظرف هذه القضية بإذ وهو يدل على الزمن الماضي أو على أي ظرف محقق الوقوع نحوه ، كما في قوله : وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ءأنت قلت للناس ، إلى أن قال : قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . المائدة ـ 119 فعبر بإذ عن ظرف مستقبل لتحقق وقوعه .
وقوله : وإذ أخذ ربك خطاب للنبي ( ص ) أو له ولغيره كما يدل عليه قوله : أن تقولوا يوم القيامة الآية ، إن كان الخطاب متوجهاً إلينا معاشر السامعين للآيات المخاطبين بها والخطاب خطاب دنيوي لنا معاشر أهل الدنيا ، والظرف الذي يتكي عليه هو زمن حياتنا في الدنيا أو زمن حياة النوع الاِنساني فيها وعمره الذي هو طول إقامته الاَرض ، والقصة التي يذكرها في الآية ظرفها عين ظرف وجود النوع في الدنيا فلا مصحح للتعبير عن ظرفها بلفظه إذ الدالة على تقدم ظرف القصة على ظرف
( 53 )
الخطاب ، ولا عناية أخرى في المقام تصحح هذا التعبير من قبيل تحقق الوقوع ونحوه وهو ظاهر . فقوله : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، في عين أنه يدل على قصة خلقه تعالى النوع الاِنساني بنحو التوليد ، وأخذ الفرد من الفرد وبث الكثير من القليل ، كما هو المشهود في نحو تكون الآحاد من الاِنسان وحفظهم وجود النوع بوجود البعض من البعض على التعاقب ، يدل على أن للقصة وهي تنطبق على الحال المشهود نوعاً من التقدم على هذا المشهود من جريان الخلقة وسيرها .
وقد تقدمت استحالة ما افترضوا لهذا التقدم من تقدم هذه الخلقة بنحو تقدماً زمانياً بأن يأخذ الله أول فرد من هذا النوع فيأخذ منه مادة النطفة التي منها نسل هذا النوع فيجزؤها أجزاء ذرية بعدد أفراد النوع إلى يوم القيامة ، ثم يلبس وجود كل فرد بعينه بحياته وعقله وسمعه وبصره وضميره وظهره وبطنه ويكسيه وجوده التي هي له قبل أن يسير مسيره الطبيعي فيشهده نفسه ويأخذ منه الميثاق ، ثم ينزعه منها ويردها إلى مكانها الصلبي ، حتى يسير سيره الطبيعي وينتهي إلى موطنها الذي لها من الدنيا ، فقد تقدم بطلان ذلك وأن الآية أجنبية عنه .
لكن الذي أحال هذا المعنى هو استلزامه وجود الاِنسان بماله من الشخصية الدنيوية مرتين في الدنيا واحدة بعد أخرى ، المستلزم لكون الشيء غير نفسه بتعدد شخصيته ، فهو الاَصل الذي تنتهي إليه جميع المشكلات السابقة .
وأما وجود الاِنسان أو غيره في امتداد مسيره إلى الله ورجوعه إليه في عوالم مختلفة النظام متفاوتة الحكم فليس بمحال ، وهو مما يثبته القرآن الكريم ولو كره ذلك الكافرون الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فقد أثبت الله الحياة الآخرة للاِنسان وغيره يوم البعث وفيه هذا الاِنسان بعينه ، وقد وصفه بنظام وأحكام غير هذه النشأة الدنيوية نظاماً وأحكاماً . وقد أثبت حياة برزخية لهذا الاِنسان بعينه وهي غير الحياة الدنيوية نظاماً وحكماً . وأثبت بقوله : وإن
( 54 )
من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم . الحجر ـ 21 أن لكل شيَ عنده وجوداً وسيعاً غير مقدر في خزائنه وإنما يلحقه الاَقدار إذا نزله إلى الدنيا مثلاً ، فللعالم الاِنساني على سعته سابق وجود عنده تعالى في خزائنه ، أنزله إلى هذه النشأة .
وأثبت بقوله : إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيَ . يس ـ 83 وقوله : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . القمرـ50 وما يشابههما من الآيات أن هذا الوجود التدريجي الذي للاَشياء ومنها الاِنسان هو أمر من الله يفيضه على الشيء ويلقيه إليه بكلمة كن ، إفاضة دفعية وإلقاء غير تدريجي . فلوجود هذه الاَشياء وجهان : وجه إلى الدنيا وحكمه أن يحصل بالخروج من القوة إلى الفعل تدريجاً ومن العدم إلى الوجود شيئاً فشيئاً ، ويظهر ناقصاً ثم لا يزال يتكامل حتى يفنى ويرجع إلى ربه .
ووجه إلى الله سبحانه وهي بحسب هذا الوجه أمور تدريجية وكل ما لها فهو لها في أول وجودها من غير أن تحتمل قوة تسوقها إلى الفعل .
وهذا الوجه غير الوجه السابق وإن كانا وجهين لشيء واحد ، وحكمه غير حكمه وإن كان تصوره التام يحتاج إلى لطف قريحة ، وقد شرحناه في الاَبحاث السابقة بعض الشرح ، وسيجيء إن شاء الله استيفاء الكلام في شرحه .
ومقتضى هذه الآيات أن للعالم الاِنساني على ما له من السعة وجوداً جميعاً عند الله سبحانه ، وهو الذي يلي جهته تعالى ويفيضه على أفراده لا يغيب فيها بعضهم عن بعض ولا يغيبون فيه عن ربهم ولا هو يغيب عنهم ، وكيف يغيب فعل عن فاعله أو ينقطع صنع عن صانعه ، وهذا هو الذي يسميه الله سبحانه بالملكوت ، ويقول : وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والاَرض وليكون من الموقنين . الاَنعام ـ 75 ويشير إليه بقوله : كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين . التكاثر ـ 7 .
( 55 )
وأما هذا الوجه الدنيوي الذي نشاهده نحن من العالم الاِنساني ، وهو الذي يفرق بين الآحاد ويشتت الاَحوال والاَعمال بتوزيعها على قطعات الزمان وتطبيقها على مر الليالي والاَيام ويحجب الاِنسان عن ربه بصرف وجهه إلى التمتعات المادية الاَرضية واللذائذ الحسية ، فهو متفرع على الوجه السابق متأخر عنه . وموقع تلك النشأة وهذه النشأة في تفرعها عليها موقعاً كن ويكون في قوله تعالى : أن نقول له كن فيكون. يس ـ 82 .
ويتبين بذلك أن هذه النشاة الاِنسانية الدنيوية مسبوقة بنشأة أخرى إنسانية هي هي بعينها غير أن الآحاد موجودون فيها غير محجوبين عن ربهم يشاهدون فيها وحدانيته تعالى في الربوبية بمشاهدة أنفسهم ، لا من طريق الاِستدلال بل لاَنهم لا ينقطعون عنه ولا يفقدونه ويعترفون به وبكل حق من قبله . وأما قذارة الشرك وألواث المعاصي فهو من أحكام هذه النشأة الدنيوية دون تلك النشأة التي ليس فيها إلا فعله تعالى القائم به ، فافهم ذلك .
وأنت إذا تدبرت هذه الآيات ثم راجعت قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، الآية ، وأجدت التدبر فيها وجدتها تشير إلى تفصيل أمر تشير هذه الآيات إلى إجماله ، فهي تشير إلى نشأة إنسانية سابقة فرق الله فيها بين أفراد هذا النوع وميز بينهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا .
ولا يرد عليه ما أورد على قول المثبتين في تفسير الآية على ما فهموه من معنى عالم الذر من الروايات على ما تقدم ، فإن هذا المعنى المستفاد من سائر الآيات والنشأة السابقة التي تثبته لا تفارق هذه النشأة الاِنسانية الدنيوية زماناً ، بل هي معها محيطة بها لكنها سابقة عليها السبق الذي في قوله تعالى كن فيكون ، ولا يرد عليه شيء من المحاذير المذكورة .
ولا يرد عليه ما أوردناه على قول المنكرين في تفسيرهم الآية بحال وجود النوع الاِنساني في هذه النشأة الدنيوية من مخالفته لقوله : وإذ أخذ ربك ، ثم التجوز في
( 56 )
الاِشهاد بإرادة التعريف منه وفي الخطاب بقوله : ألست بربكم بإرادة دلالة الحال ، وكذا في قوله : قالوا بلى ، وقوله : شهدنا ، بل الظرف ظرف سابق على الدنيا وهو غيرها ، والاِشهاد على حقيقته والخطاب على حقيقته .
ولا يرد عليه أنه من قبيل تحميل الآية معنى لا تدل عليه ، فإن الآية لا تأبى عنه وسائر الآيات تشير إليه بضم بعضها إلى بعض .
وأما الروايات فسيأتي أن بعضها يدل على أصل تحقق هذه النشأة الاِنسانية كالآية، وبعضها يذكر أن الله كشف لآدم عليه السلام عن هذه النشأة الاِنسانية وأراه هذا العالم الذي هو ملكوت العالم الاِنساني وما وقع فيه من الاِشهاد وأخذ الميثاق ، كما أرى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والاَرض .
رجعنا إلى الآية ، قوله : وإذ أخذ ربك ، أي واذكر لاَهل الكتاب في تتميم البيان السابق ، أو واذكر للناس في بيان ما نزلت السورة 20 : لاَجل بيانه ، وهو أن لله عهداً على الاِنسان وهو سائله عنه وأن أكثر الناس لا يفون به وقد تمت عليهم الحجة ، أذكر لهم موطناً قبل الدنيا أخذ فيه ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فما من أحد منهم إلا استقل من غيره وتميز منه فاجتمعوا هناك جميعاً وهم فرادى فأراهم ذواتهم المتعلقة بربهم وأشهدهم على أنفسهم فلم يحتجبوا عنه وعاينوا أنه ربهم ، كما أن كل شيَ بفطرته يجد ربه من نفسه من غير أن يحتجب عنه ، وهو ظاهر الآيات القرآنية كقوله: وإن من شيَ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . إسراء ـ 44 .
ألست بربكم ، وهو خطاب حقيقي لهم لا بيان حال ، وتكليم إلَهي لهم فإنهم يفهمون مما يشاهدون أن الله سبحانه يريد به منهم الاِعتراف وإعطاء الموثق ، ولا نعني بالكلام إلا ما يلقى للدلالة به على معنى مراد ، وكذا الكلام في قوله : قالوا بلى شهدنا .
وقوله : أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، الخطاب للمخاطبين بقوله ألست بربكم القائلين بلى شهدنا ، فهم هناك يعاينون الاِشهاد والتكليم من الله
( 57 )
والتكلم بالاِعتراف من أنفسهم ، وإن كانوا في نشأة الدنيا على غفلة مما عدا المعرفة بالاِستدلال ، ثم إذا كان يوم البعث وانطوى بساط الدنيا وانمحت هذه الشواغل والحجب عادوا إلى مشاهدتهم ومعاينتهم ، وذكروا ما جرى بينهم وبين ربهم .
ويحتمل أن يكون الخطاب راجعاً إلينا معاشر المخاطبين بالآيات أي إنما فعلنا ببني آدم ذلك حذر أن تقولوا أيها الناس يوم القيامة كذا وكذا ، والاَول أقرب ويؤيده قراءة أن يقولوا بلفظ الغيبة .
وقوله : أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ، هذه حجة الناس إن فرض الاِشهاد وأخذ الميثاق من الآباء خاصة دون الذرية ، كما أن قوله أن تقولوا الخ ، حجة للناس إن ترك الجميع فلم يقع إشهاد ولا أخذ ميثاق من أحد منهم .
ومن المعلوم أن لو فرض ترك الاِشهاد وأخذ الميثاق في تلك النشأة كان لازمه عدم تحقق المعرفة بالربوبية في هذه النشأة إذ لا حجاب بينهم وبين ربهم في تلك النشأة ، فلو فرض هناك علم منهم كان ذلك إشهاداً وأخذ ميثاق ، وأما هذه النشأة فالعلم فيها من وراء الحجاب وهو المعرفة من طريق الاِستدلال ، فلو لم يقع هناك بالنسبة إلى الذرية إشهاد وأخذ ميثاق كان لازمه في هذه النشأة أن لا يكون لهم سبيل إلى معرفة الربوبية فيها أصلاً ، وحينئذ لم يقع منهم معصية شرك بل كان ذلك فعل آبائهم وليس لهم إلا التبعية العملية لآبائهم والنشوء على شركهم من غير علم ، فصح لهم أن يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون .
قوله تعالى : وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ، تفصيل الآيات تفريق بعضها وتمييزه من بعض ليتبين بذلك مدلول كل منها ولا تختلط وجوه دلالتها ، وقوله : ولعلهم يرجعون ، عطف على مقدر والتقدير لغايات عالية كذا وكذا ولعلهم يرجعون من الباطل إلى الحق .
( ثم أورد صاحب الميزان رحمه الله رواية ابن الكوا المتقدمة ، وقال ) :
( 58 )
أقول والرواية كما تقدم وبعض ما يأتي من الروايات يذكر مطلق أخذ الميثاق من بني آدم من غير ذكر إخراجهم من صلب آدم وإراءتهم إياه . وكان تشبيههم بالذر كما في كثير من الروايات تمثيل لكثرتهم كالذر لا لصغرهم جسماً أو غير ذلك ، ولكثرة ورود هذا التعبير في الروايات سميت هذه النشأة بعالم الذر .
وفي الرواية دلالة ظاهرة على أن هذا التكليم كان تكليماً حقيقياً لا مجرد دلالة الحال على المعنى . وفيها دلالة على أن الميثاق لم يؤخذ على الربوبية فحسب ، بل على النبوة وغير ذلك . وفي كل ذلك تأييد لما قدمناه .
وفي تفسير العياشي عن رفاعة قال : سالت أبا عبدالله عن قول الله : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، قال نعم لله الحجة على جميع خلقه أخذهم يوم أخذ الميثاق هكذا وقبض يده .
أقول : وظاهر الرواية أنها تفسر الاَخذ في الآية بمعنى الاِحاطة والملك .
وفي تفسير القمي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ، قلت معاينة كان هذا قال نعم . . . . ( إلى آخر الرواية المتقدمة ) ..
أقول : والرواية ترد على منكري دلالة الآية على أخذ الميثاق في الذر تفسيرهم قوله : وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، أن المراد به أنه عرفهم آياته الدالة على ربوبيته ، والرواية صحيحة ومثلها في الصراحة والصحة ما سيأتي من رواية زرارة وغيره .
وفي الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة : أن رجلاً سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم .. إلى آخر الآية ، فقال وأبوه يسمع : حدثني أبي أن الله عز وجل قبض قبضه من تراب التربة التي خلق منها آدم فصب عليها الماء العذب الفرات ، ثم
( 59 )
تركها أربعين صباحاً ، ثم صب عليها الماء المالح الاَجاج ، فتركها أربعين صباحاً ، فلما اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً ، فخرجوا كالذر من يمينه وشماله ، وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار ، فدخلها أصحاب اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماً ، وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها .
أقول وفي هذا المعنى روايات أخر ، وكأن الاَمر بدخول النار كناية عن الدخول حظيرة العبودية والاِنقياد للطاعة .
وفيه بإسناده عن عبدالله بن محمد الحنفي وعقبه جميعاً عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله عز وجل خلق الخلق ، فخلق من أحب مما أحب ، فكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة ، وخلق من أبغض مما أبغض ، وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار ، ثم بعثهم في الظلال ، فقيل : وأي شيء الظلال قال : ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء ، ثم بعث معهم النبيين فدعوهم إلى الاِقرار بالله ، وهو قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ، ثم دعوهم إلى الاِقرار فأقر بعضهم وأنكر بعض ، ثم دعوهم إلى ولايتنا ، فأقر بها والله من أحب وأنكرها من أبغض ، وهو قوله : وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ، ثم قال أبوجعفر عليه السلام كان التكذيب ثَمَّ .
أقول : والرواية وإن لم تكن مما وردت في تفسير آية الذر غير أنا أوردناها لاشتمالها على قصة أخذ الميثاق وفيها ذكر الظلال ، وقد تكرر ذكر الظلال في لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام والمراد به كما هو ظاهر الرواية وصف هذا العالم الذي هو بوجه عين العالم الدنيوي وبوجه غيره ، وله أحكام غير أحكام الدنيا بوجه وعينها بوجه ، فينطبق على ما وصفناه في البيان المتقدم .
وفي الكافي وتفسير العياشي عن أبي بصير قال : قلت لاَبي عبدالله عليه السلام كيف أجابوا وهم ذر ؟ قال : جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه ، وزاد العياشي يعني في الميثاق .
أقول وما زاده العياشي من كلام الراوي ، وليس المراد بقوله جعل فيهم ما إذا
( 60 )
سألهم أجابوه دلالة حالهم على ذلك ، بل لما فهم الراوي من الجواب ما هو من نوع الجوابات الدنيوية استبعد صدوره عن الذر ، فسأل عن ذلك فأجابه عليه السلام بأن الاَمر هناك بحيث إذا نزلوا في الدنيا كان ذلك منهم جواباً دنيوياً باللسان والكلام اللفظي ، ويؤيده قوله عليه السلام ما إذا سألهم ولم يقل ما لو تكلموا ونحو ذلك .
وفي تفسير العياشي أيضاً عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام : في قول الله : ألست بربكم ، قالوا بألسنتهم ؟ قال نعم وقالوا بقلوبهم ، فقلت وأين كانوا يومئذ ؟ قال صنع منهم ما اكتفى به ..
أقول جوابه عليه السلام إنهم قالوا بلى بألسنتهم وقلوبهم مبني على كون وجودهم يومئذ بحيث لو انتقلوا إلى الدنيا كان ذلك جواباً بلسان على النحو المعهود في الدنيا ، لكن اللسان والقلب هناك واحد ، ولذلك قال عليه السلام نعم وبقلوبهم فصدق اللسان وأضاف إليه القلب . ثم لما كان في ذهن الراوي أنه أمر واقع في الدنيا ونشأة الطبيعة وقد ورد في بعض الروايات التي تذكر قصة إخراج الذرية من ظهر آدم تعيين المكان له وقد روى بعضها هذا الراوي أعني أبا بصير ، سأله عليه السلام عن مكانهم بقوله وأين كانوا يومئذ فأجابه عليه السلام بقوله صنع منهم ما اكتفى به ، فلم يجبه بتعيين المكان بل بأن الله سبحانه خلقهم خلقاً يصح معه السؤال والجواب ، وكل ذلك يؤيد ما قدمناه في وصف هذا العالم .
والرواية كغيرها مع ذلك كالصريح في أن التكليم والتكلم في الآية على الحقيقة دون المجاز ، بل هي صريحة فيه .
وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الاَصول ، وأبوالشيخ في العظمة ، وابن مردويه ، عن أبي إمامة أن رسول الله ( ص ) قال : خلق الله الخلق وقضى القضية ، وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء ، فأخذ أهل اليمين بيمينه ، وأخذ أهل الشمال بيده الاَخرى ، وكلتا يدي الرحمن يمين ، فقال : يا أصحاب اليمين ، فاستجابوا له فقالوا لبيك ربنا وسعديك ، قال ألست بربكم قالوا :
( 61 )
بلى . قال يا أصحاب الشمال ، فاستجابوا له فقالوا لبيك ربنا وسعديك ، قال ألست بربكم قالوا بلى . فخلط بعضهم ببعض فقال قائل منهم : رب لم خلطت بيننا ، قال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، ثم ردهم في صلب آدم ، فأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها .
فقال قائل يا رسول الله فما الاَعمال ؟ قال : يعمل كل قوم لمنازلهم ، فقال عمر بن الخطاب : إذاً نجتهد .
أقول قوله ( ص ) وعرشه على الماء ، كناية عن تقدم أخذ الميثاق وليس المراد به تقدم خلق الاَرواح على الاَجساد زماناً ، فإن عليه من الاِشكال ما على عالم الذر بالمعنى الذي فهمه جمهور المثبتين ، وقد تقدم .
وقوله ( ص ) يعمل كل قوم لمنازلهم ، أي أن كل واحد من المنزلين يحتاج إلى أعمال تناسبه في الدنيا ، فإن كان العامل من أهل الجنة عمل الخير لا محالة وإن كان من أهل النار عمل الشر لا محالة ، والدعوة إلى الجنة وعمل الخير لاَن عمل الخير يعين منزله في الجنة وإن عمل الشر يعين منزله في النار لا محالة ، كما قال تعالى : ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. البقره ـ 148 فلم يمنع تعين الوجهة عن الدعوة إلى استباق الخيرات ، ولا منافاة بين تعين السعادة والشقاوة بالنظر إلى العلل التامة ، وبين عدم تعينها بالنظر إلى اختيار الاِنسان في تعيين عمله ، فإنه جزء العلة وجزء علة الشيء لا يتعين معه وجود الشيء ولا عدمه بخلاف تمام العلة ، وقد تقدم استيفاء هذا البحث في موارد من هذا الكتاب ، وآخرها في تفسير قوله تعالى : كما بدأكم تعودون فريقاً هدى و فريقاً حق عليهم الضلالة ـ الاَعراف ـ 30 ، وأخبار الطينة المتقدمة من أخبار هذا الباب بوجه .
وفيه ، أخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبوالشيخ ، عن ابن عباس : في قوله إذ أخذ ربك من بني آدم الآية ، قال : خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه ، وكتب أجله ورزقه ومصيبته ، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة
( 62 )
الذر ، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم ، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم .
أقول : وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس بطرق كثيرة في ألفاظ مختلفة ، لكن الجميع تشترك في أصل المعنى وهو إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق منهم .
وفيه ، أخرج ابن عبدالبر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود وناس من الصحابة : في قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، قالوا : لما أخرج الله آدم من الجنة ، قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى ، فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر ، فقال لهم أدخلوا الجنة برحمتي ، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ادخلوا النار ولا أبالي ، فذلك قوله أصحاب اليمين وأصحاب الشمال . ثم أخذ منهم الميثاق فقال ألست بربكم قالوا بلى ، فأعطاه طائفة طائعين ، وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة : شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ، قالوا فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف الله أنه ربه وذلك قوله عز وجل : وله أسلم من في السماوات والاَرض طوعاً وكرهاً ، وذلك قوله : فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ، يعني يوم أخذ الميثاق .
أقول : وقد روى حديث الذر كما في الرواية موقوفة وموصولة عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كعلي عليه السلام وابن عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وسلمان وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد الخدري وعبدالله بن مسعود وعبدالرحمان بن قتادة و أبي الدرداء وأنس ومعاوية وأبي موسى الاَشعري .
كما روي من طرق الشيعة عن علي وعلي بن الحسين ، ( ومحمد بن علي ) ، وجعفر بن محمد ، والحسن بن علي العسكري عليهم السلام .
ومن طرق أهل السنة أيضاً عن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن
( 63 )
محمد بطرق كثيرة ، فليس من البعيد أن يدعي تواتره المعنوي.
واعلم أن الروايات في الذر كثيرة جداً ، وقد تركنا إيراد أكثرها لوفاء ما أوردنا من ذلك بمعناها . وهنا روايات أخر في أخذ الميثاق عن النبي صلى الله عليه وآله وسائر الاَنبياء عليهم السلام سنوردها في محلها إن شاء الله تعالى . انتهى .
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله