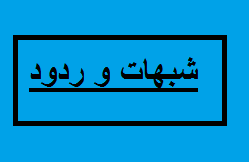يجب على الإنسان إن يخرج من العجب ـ والمقصود هو النفس الطبيعية ـ إن للخروج من دائرة العجب والغرور مراحل ومراتب. أولى مراحله هي حب الآخرين في الحقيقة كأن “الأنا” الإنسانية تتوسع وتكبر ـ بتعبير راسل في كتاب “الآمال الجديدة” إنه يتصور أنا “الأنا” هي الطبيعة فقط مثلاً إن الطفل يكون في نفسه الفردية فقط ويرى نفسه فقط، ويريد كل شيء لنفسه الفردية حتى أنه ينظر لأبويه بعين الآلة والوسيلة لنفسه. وفي مرحلة الشباب عندما يعشق ويختار زوجة فلأول مرة يحدث له إحساس بأنه يحب شخصاً آخر كما يحب نفسه. “طبعاص هذا واحد في الجميع” أي يخرج من نفسه، ويصبح الاثنان واحداً ويريد كل شيء لهذه النفساً الأوسع والأكبر، صار مجموع “النفسين” نفس واحدة. طبعاً هذا إذا تعلّق الإنسان حقيقة بالطرف المقابل، علاقة الأنس وبتعبير القرآن الود والرحمة، (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (سورة الروم، الآية: 21). فإذا كانت الرابطة بين الزوجين رابطة شهوية وجنسية سينظر كل منهما لصاحبه بعين الآلة. العلاقة الجنسية أمر حيواني وطبيعي. فلأجل إشباع الغريزة الجنسية تكون المرأة بالنسبة للرجل مجرد آلة لا أكثر وكذلك يكون الرجل بالنسبة للمرأة. ولكن مسألة الزوجين والجو العائلي وفلسفة الأسرة والروح الأسرية عبارة عن روح فوق الغريزة الجنسية، إنها تقوم بين شخصين، يحب كل منهما الآخر، وتستمر معهما المحبة والعلاقة الأسرية إلى سني الشيخوخة التي تضعف أو تنعدم فيها الغريزة الجنسية، بل تزداد هذه المحبة يوماً بعد يوم ويقول العلماء المعاصرون: أمثال “ويل دورانت” في كتاب “مباهج الفلسفة”: علاقة الزوجين تزداد بسبب المعاشرة والاتصال الدائم ويكون أثرها كبيراً بحيث أن شكليهما يتشابهان بالتدريج، أي أن روحيهما تتطابقان فيؤدي ذلك إلى تطابق جسميهما وتشابه شكليهما بالتدريج. وهذه أول مرحلة يخرج فيها الإنسان من نطاق النفس الفردية. ولهذا السبب اعتبر الزواج في الإسلام أمراً أخلاقياً مع أنه أمر شهواني. وهذا هو الأمر الوحيد الذي له جانب أخلاقي مع أنه يقوم على أساس طبيعي وشهواني، مثلاً ليس للأكل جانب أخلاقي، ولكن للزواج نفسه جانباً أخلاقياً. فمن بين غرائز الإنسان الشهوانية لا نجد أن اشباع غريزة يؤثر في الجانب المعنوي للإنسان إلا الغريزة الجنسية. ولهذا اعتبر الزواج في الإسلام سنة ومستحباً.
والسبب الأساسي هو أنه بمقدار ما تزداد الألفة بين الزوجين فانهما يخرجان من النفس الفردية بذلك المقدار. إن “النفس” بمقدار ما تكبر تصبح رقيقة كالسائل الغليظ الذي يتمدد ويصبح رقيقاً بإضافة الماء إليه. أثبتت التجربة أن الأفراد الذين باتوا مجردين لأهداف معنوية ولم يصمموا على الزواج كي لا يمنعهم الأطفال والزوجة عن الوصول إلى المعنويات. يوجد في جميعهم نوع من النقص، ولو بصورة عدم نضجهم. كأن للإنسان نوعاً من الكمال الروحي لا يمكن اكتسابه في أية مدرسة سوى مدرسة الأسرة، لا تحصل كل الكمالات الروحية في جميع المدارسة والمذاهب. كالشجاعة أمام الأعداء، إن الإنسان لا يحصل على الشجاعة بالاعتكاف والعزلة ومحاربة الأهواء النفسية؟ لا تحصل الشجاعة إلا في ميدان الجهاد العملي، وإذا أراد الإنسان إيجادها في روحه ونفسه فعليه أن يحققها عملياً ليستطيع اكتسابها.
حديث عن الرسول الأكرم
ورد حديث نبوي في روايات أهل السنة وهو: “من لم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق”[1] .
فمواجهة الأعداء لا تخرج شيئاً من روح الإنسان سوى هذه الشعبة من النفاق. تماماً “كالسباحة” فهل يصبح الإنسان سباحاً لو قرأ جميع الكتب التي كتبت في السباحة؟ كلا، إلا أن يسبح فترة من الزمن ويغوص في الماء مرات عديدة ويبتلع مقداراً من الماء، ويتألم ويتعب ليتعلم السباحة. ولا يمكن اكتساب الشجاعة عن طريق مواجهة الأخطار التي تواجه الإنسان أو مواجهة الأعداء فقط، بل يجب حصول حالة لدى الإنسان بحيث لو واجهه شخص مصمم على قتله فإنه يستعد للدفاع بشك تلقائي.
الرجل الزاهد والجهاد في سبيل الله
نقل الشاعر المولوي قصة، قال: كان أحد الزهاد يأتي بمختلف أعمال البر والخير واقاُمة الفرائض، وبقي عليه الجهاد فقط، قال لمجموعة من الجنود: “إذا نشبت الحرب مع الكفار فأخبروني”. أخبروه يوماً بأن استعدّ غداً، وبعد رحيلهم كانوا قد جلسوا تحت خيمة إذ أخبروهم بهجوم الأعداء، أما الذين كانوا على استعداد للحرب فقد وثبوا فوراً وركبوا الخيول وذهبوا إلى القتال، وأما هذا الرجل الزاهد فأخذ يبحث عن سلاحه ويقرأ الأدعية والأذكار حتى انتهت الحرب، وعاد الجنود. سألهم: ماذا حدث؟ قالوا: ذهبنا، وقاتلنا ورجعنا. قال: عجيب! إذاً ماذا علينا نحن؟ قالوا: لا شيء لقد انتهى القتال.
وأخيراً رقّ قلب أحدهم عليه، وكان معهم أسرى فأشار إلى أحدهم وقال: هل ترى هذا؟ إنه أحد أولئك الأعداء الذين هم الكفرة، وانه قتل كثيراً من فرساننا قبل أن نتمكن من أسره. ويجب قتله الآن؛ فخذ السيف واضرب عنقه. كان الأسير مقيداً، فأخذه الرجل الزاهد ليضرب عنقه. لكنه تأخر ولم يرجع، فذهبوا وراءه، ليجدوه طريحاً على الأرض والرجل الأسير بيديه المقيدتين قائم فوقه يعض رقبته، يريد قطع وريده. فأخذوا الأسير وقتلوه، وجاؤوا بالزاهد إلى الخيمة وصبوا عليه الماء، وعندما أفاق سألوه عن الحادث. قال: عندما غادرناكم نظر الأسير في وجهي، وفجأة صرخ فاغمي عليّ ولم أعد أعي شيئاً.
لا يمكن الحصول على الشجاعة في سكون الليل كما لا يمكن اكتساب آثار قيام الليل وإحيائه بعبادة الله في ساحة الحرب.
هناك قيم أخلاقية لا يمكن للإنسان اكتسابها إلاّ في مدرسة الأسرة “تكوين الأسرة” هو حب الآخرين. فإذا لم يتزوج الإنسان ولم يرزقه طفلاً يحرك عواطفه بشدة ويثيره عندما يمرض، وإذا لم يؤثر فيه تبسم الطفل، لا يحدث في نفسه حب الآخرين. إن هذا لا يتحقق بمطالعة الكتب لقد اثبتت التجربة أن الأخلاقيين والرياضيين الممارسين لأنواع الرياضات والذين لم يمروا بهذه المرحلة أصابتهم حالة من الخمول وعدم النضج ونوع من الطفولة استمرت بهم إلى آخر عمرهم. وهذا أحد الأسباب التي جعلت الزواج أمراً مقدساً وعبادياً في الإسلام، في حين أن التجرد من وجهة نظر المسيحية أمر مقدس وأن ازواج شر وفساد، وهم يجيزون الزواج فقط لمن لا يتحمل التجرد، أي أنهم إذا باتوا مجردين فانهم سينجرفون نحو الفساد، لذلك فهم يقولون: يجب الزواج من باب دفع الأفسد بالفاسد. لذا فإن “زعيم القساوسة” ينتخب من بين المجردين العزاب بحيث لم يتلوث بهذا بالزواج طيلة عمره. أما الإسلام فهو على العكس من المسيحية: “مِن أخلاق الانبياء حب النساء”[2] .
إذاً فالزواج هو المرحلة الأولى للخروج من النفس الطبيعية الفردية وتوسيع شخصية الإنسان. بعد الزواج لا يعمل لأجل “الأنا” فقط، بل تتبدل تلك “الأنا” إلى “نحن” بحيث يتعلق الإنسان بمصير الآخرين كما يتعلق بمصيره الشخصي، ويتعب ليعيشوا في راحة. وهذه درجة واحدة من “النفس” ولكن هل يكفي أن تتوسع النفس بهذا المقدار؟ كلا. فهذه درجة من الكمال بالنسبة إلى النفس الفردية الطبيعة، لكنها إذا توقفت عند هذا الحدّ، فمعنى ذلك أنها تتسع من الأنا الفردية وتصبح أنا باضافة الزوجة والأطفال، ولكنها تظل تنفي الآخرين، وهذا لا يكفي.
الأنا القبلية
يمكن أن تتسع “نفس” إنسان أكثر من هذا فتشمل الأقرباء. أي أن النفس الفردية تتجاوز النفس الأسرية إلى الأقارب والقبيلة، كما نشاهد كثيراً في القبائل البدوية وفي عرب الجاهلية، أنهم لا يفرقون بين أفراد القبيلة، فكأن هناك روحاً واحدة تحكم جميع الأفراد في القبيلة. “الأنا” الفردية هي “الأنا القبلية”، ففي داخل القبيلة توجد جميع الاُصول الإنسانية كالعفو، والإحسان والإيثار، ولكن على بُعد مسافة قليلة من القبيلة تنعدم هذه الروح. إذاً لا يكفي توسع “الأنا” الإنسانية بهذا المقدار فقط.
الأنا القومية:
تتسع “الأنا” أكثر فتبلغ مرحلة: “الأنا القومية” فيحب الإنسان وطنه، أي يحب جميع أفراد شعبه كحبه لنفسه وروحه، ولكن لا يكفي هذا أيضاً. لأنه إذا اجتاز ذلك الحد سيجيز كل شيء لنفسه. فالإيراني مثلاً لا يكذب على الإيراني ولا يخونه، وإنما يخدمه ويحسن إليه، لكنه يجوز الكذب على غير الإيراني والتجاوز على حقوقه، ويجوز الاستبداد، وهذه النفس هي الموجودة عند الأوروبيين، أي نمت وكبرت عندهم “النفس الشعبية والقومية” وتوسعت “الأنا الفردية” إلى “الأنا القومية”. إن الغربيين لا يخونون مواطنيهم إلى حدٍ ما، ولا يكذبون عليهم ولا يستبدون، ولكن لو اجتازت أقدامهم دائرة مواطنيهم إلى غيرهم أصبحوا ظالمين، يسوغون الكذب والخيانة لمصلحة قومهم، أي أنهم لم يرتكبوا الخيانة والجناية في داخل مملكتهم، لكنهم يرتكبون أبشع الجرائم مع الشعوب الأخرى. يسرقون أموال وثروات الشعوب لأجل شعوبهم، ويعتبرون ذلك فخراً لهم.
لاشك أن إنساناً كهذا لا يفضل نفسه في داخل بلاده على الآخرين، أي أنه يعيش هناك بصورة “نحن” وجماعة “لا بصورة أنا” فهو يكون أكمل من الإنسان المعجب بنفسه الفردية الذي لا يرى في الدنيا إلا شخصه. ولكن لا يمكن اعتبار ذلك من الأخلاق، فليس من المنطقي بناء الأخلاق على أساس أنه لا علاقة لي بالشعوب الأخرى وما لي والشعوب الأخرى.
حب البشر
حينما نرتفع عن هذا درجة نصل إلى حب البشر. لو كان الفرد محباً للبشر حقيقة فانه سوف يخدم جميع البشرية، ولا يخون أي إنسان، ولا يضيع حقوق أي إنسان. إن الحد النهائي الذي يمكن تصوره للخروج من التكبر هو أن يتسع الحب لكل الناس. في هذه الحال تكون “نفس” الإنسان هي كل الناس بسبب أنهم بشر.
يرد إشكال حول هذه “النظرية” أيضاً: لماذا نحب الإنسان ولا نحب الحيوان؟ لماذا هذا الحد؟ وهل من المنطق أن يتوقف الحد هنا وتحيط “النفس” ما حولها بحصار؟ أولا يمكن التقدم أكثر من هذا وتسميته عبودية الله وعبودية الحق؛ لأن الله تعالى ليس بموجود إلى جانب الموجودات الأخرى، ولكن في مسير عبودية الله يوجد كل شيء في هذه الدنيا.
أنا مسرور ومحب للعالم لأن العالم مسرور به “تعالى” عشقت جميع العالم لأن كل العالم منه.
نعود إلى السؤال بشان حب الإنسان، وهل أن حدّ النفس يتوقف هنا؟ أو أنه يتقدم ولا موجب لتوقفه. إضافة إلى سؤال آخر يطرح حول حب البشر وهو حينما نقول حب الإنسان فما هو المقصود من “الإنسان”؟ كل حيوان وكل جماد هو ذلك الشيء الموجود فعلاً. مثلاً حينما نقول “حب الورد”. الورد هو نفس هذا الشيء الموجود. وليس للورد اُصول، وهكذا الحيوان. ولكن لا يمكن تصور الإنسان بأن هذا هو الموجود الذي له رأس وأذنان فقط، ليقال: حب البشر هو أنه أينما وجد هذا الحيوان المستوي القاُمة وعريض الظفر تجب محبته. كلا، إن للإنسان إنسانية أيضاً. يمكن أن يوجد إنسان ضد البشر. لكن ليس لدينا حيوان هو ضد الحيوان. الحيوان دائماً حيوان. إن إنسانية الإنسان ترتبط بسلسة من المعاني والحقائق، لا يمكن عدّ الفاقد لها إنساناً. وهنا يأتي البحث عن أنه وجد إنسان ضد الإنسانية أو ضد بقية الناس كالذي يذل الآخرين ويظلمهم ويتجاوز على حقوقهم، فهل تجب محبته كالآخرين وعده إنساناً؟ أم يجب القضاء عليه. وفي الحالة الثانية، كيف تتفق هذه الحالة مع مسألة حب البشر؟
والجواب: إذا كان القصد من “حب البشر” هو حب هذا الحيوان المنتصب القامة، فمن هذه الناحية لا يختلف الإنسان الحقيقي عن الإنسان الذي هو ضد الإنسانية، أما إذا قلنا بأننا نفهم من الإنسانية معنى وأن الإنسان موجود ذو معنى فممكن أن يكون مملوءاً بمعنى الإنسانية، أو يكون خالياً من معناها أو ضده، حينئذ سيكون لمفهوم “حب الإنسان” معنى آخر، ويجب حب الإنسان لأجل الإنسانية، ولهذا السبب إذا وجد إنسان معاكس لمسير الإنسانية يجب محاربته بأعنف الوسائل أحياناً، والتعامل معه بالغلظة والشدة واعتباره عقبة في طريق الإنسانية، وهذا العمل شكل من أشكال حب البشر، أي أن محاربة الإنسان المخالف للإنسانية لأجل الإنسانية هي نوع من حب الإنسانية والبشرية.
النفس الدينية
قد يقال: إنك عددت “الأنفس” درجة درجة وقلت: النفس الفردية، النفس الأسرية، القومية، القبلية إلى أن وصلت إلى النفس الإنسانية. فماذا عن النفس الدينية؟ هل هي نفس أيضاً. هل يحتمل أن تكون هذه حصاراً لنا؟ نحن أنفسنا نقول أيضاً: يجب على المسلم أن يحب المسلم، وان لا يقيم مع غير المسلم علاقة الود: (أشداء على الكفار رحماء بينهم) (سورة الفتح، الآية: 29). إذا كان وضع الحدود قبيحاً، فهذا قبيح أيضاً، ومناف للأخلاق.
والجواب: إذا اتخذت المسألة طابع التعصب، فيتعصب للمسلمين ضد غيرهم فهذا في الحقيقة أمر قبيح يرفضه الإسلام. أراد الإسلام منا أن نطلب الخير لجميع أفراد البشر، حتى الكفار. إذا كانت معاداة الكافر من حيث إرادة الشر له فهذا مخالف للأخلاق، فعلينا أن لا نتمنى السوء للكافر أيضاً. بل يجب أن نكون كالنبي الأكرم (ص) الذي قال: “إنني أحزن وأتألم على هؤلاء، إذ لم ينالوا خيرهم وحقهم”.
ولكن حينما يكونون شوكة في طريق الحق، يجب اعتبارهم مانعاً، ولكن لا يجب ايذاؤهم. ولا يجب تمني السوء والشر حتى لأبي جهل أيضاً، كأن يقال: لا قدّر الله أن يسلم أبو جهل ثم يستشهد. حتى ان يزيد بن معاوية عندما يسأل الإمام زين العابدين (ع) بأنه لو تاب فهل يقبل الله توبته أم لا، يقول له الإمام: نعم تقبل توبتك. أي أنه لا يريد السوء حتى ليزيد وهو قاتل أبيه، ولا يتمنى عدم توفيقه للتوبة ليدخل جهنم، بل انه يريد الخير له أيضاً. والذي ننسبه لهؤلاء نسميه “السوء أو الشر” معناه، بما انهم ليسوا في طريق الخير وان وجودهم مضر للآخرين، فيجب اعتبارهم أعداء.
الإحسان إلى الكافر
معاداة الكافر تنشأ من محبة الآخرين وإرادة الخير لهم. ولا تنشأ من إرادة السوء له. يمكن الإحسان إلى الكافر بشرط أن لا يضر هذا الاحسان الآخرين والإنسانية (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم … إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) [3] . لأن الاحسان إلى هؤلاء المقاتلين في الدنيا هو تضعيف للمسلمين. مثلاً إذا باع الإنسان سلاحاً لعدوه الذي يحاربه، فانه بالطبع يساعد على هزيمة وانكسار نفسه. إن اعطاء القوة التي تساعد على تضعيف جبهة الإسلام والمسلمين حرام. أما الاحسان إلى الكافر الذي ليس محارباً فليس بحرام بل هو حسن أيضاً.
وهنا نصل إلى هذا المفهوم وهو أن دائرة خروج الإنسان عن حد التكبر لا تحدد بأي شيء حتى بالإنسان. بل تشمل جميع عالم الوجود. ولكن العالم في سير تكامله أي في سير عبودية الحق وإرادة الحق وما يريده الله للعالم “أي السعادة” هو أن يريد الإنسان ما يريده الله تعالى. وسيتحقق الخروج الحقيقي عن عبودية النفس والعجب والتكبر لا يوجد في الإسلام شيء يحدنا بالناس فقط، بعنوان حب الإنسان. بل توجد في الإسلام كلمة الله والحق فان الدائرة أوسع من هذا كله. وقد تكون محدودة أحياناً. لا بمعنى إيذاء الآخرين واضمار الشر لهم، على الرغم من انه لا يمكن التعامل مع جميع الناس بأسلوب واحد، فيجب التعامل مع الذين يريدون أن يكونوا سداً ومانعاً بوجه الحق والمطالبة به، بأسلوب آخر ومعاملتهم كالأعداء. كالسن المتسوس يجب قلعه، وهذا ليس بمعنى أن الإنسان يريد ضرر سنّه، بل إنه وصل إلى مرحلة إذا لم يقلع هذا العضو الفاسد فان البدن سيضرر ويتألم وستفسد بقية الأسنان.
الوجدان العام
وبناءً على هذا، فليس المقصود من “الوجدان العام” الذي ذكر سابقاً هو حب جميع الناس فحسب، بل أكثر من ذلك، حب جميع الأشياء، وفي الوقت نفسه رفع الموانع التي تسدّ طريق العمل في مسير التكامل. لأن الإنسان وكل العالم ليست موجودات ساكنة متوقفة عن الحركة. هناك أمثلة على أن الإسلام يهتم باُصول الإنسانية لا بالشخص والفرد. يقول القرآن مخاطباً المسلمين: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون).(سورة المائدة، الآية: 8). هذا الخطاب للمسلمين والأعداء هم كفّار الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام والذين كانوا ألدّ أعداء الإسلام، إضافة إلى عبادتهم للأصنام التي هي أسوأ خصلة لهم. إضافة إلى كل هذا فإن القرآن يقول: إنه لا يجوز ظلم هؤلاء؛ لأن العدالة أصل وليست أصلاً إنسانياً فحسب، بل إنها اصل عالمي. أي أن الإنسان المؤمن بالله لا يمكنه أن يكون ظالماً. فالظلم مرفوض حتى بالنسبة للعدو الكافر. ومثل هذا المفهوم عبارة أمير المؤمنين (ع) المعروفة التي يخاطب بها مالك الأشتر “ولا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فانهم صنفان إما أخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق”[4] . لأن العدل ليس أصلاً إنسانياً فحسب، بل هو عالمي.
مرّ أمير المؤمنين (ع) بشيخ كبير من أهل الذمة كان يتسول فقال (ع): لماذا يستجدي هذا؟ قالوا: إنه رجل يهودي كان يعمل عندما كان قوياً، والآن أصبح ضعيفاً فأخذ يستعطي. قال (ع): عجيب! إنه عمل بحد إمكانه واستطاعته، والآن يستجدي لأنه لا يستطيع العمل! ثم أمر أن يقرروا له من بيت المال شيئاً كحق التقاعد.
المهم أن الإحسان ومساعدة الكافر إذا لم يؤد إلى تضعيف جبهة الحق فهو جائز لا مانع منه، ولدينا كثير من الروايات بشأن كتابي يسلم، فيسال الإمام عن كيفية معاملته لوالديه. فيقول له الإمام: يجب أن تعاملهم كالسابق، بل يجب أن تكون معاملتك أفضل.
——————————————————————————–
[1] سنن أبي داوود “باب الجهاد.
[2] الكافي، ج5، ص320.
[3] سورة الممتحنة، الآيتان: 8 ـ 9.
[4] نهج البلاغة، الرسالة رقم: 53.
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله