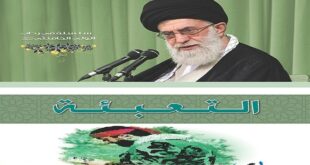نصُّ الموعظة القرآنية:
﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ .
إِنَّ مسألتي العدل الإلهي واختيار الإنسان من أهمّ المسائل الاعتقادية, إذ تشكّلان واحدة من أهمّ دعائم عقيدة المسلم، بل من أهمّ ركائز الفكر الإسلامي بشكل عام، وتترتّب على هذه العقيدة آثارٌ مهمّة على المستوى المسلكي، الأخلاقي والاجتماعي. ونظراً لأهمّيتها تعرّض القرآن لها في الكثير من المواضع بين تصريح وتلميح، وظهر ذلك بشكلٍ جليٍّ أيضاً في الأخبار الواردة عن النبي الأكرم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
وسنتناول في هذا الدرس عدّة أمور لها ربط بمطلبي العدل الإلهي والاختيار، انطلاقاً من الآية المباركة المذكورة أعلاه، وذلك ضمن العناوين الآتية:
قانون الاختيار في أفعال البشر
هذه الآية المباركة وقعت في سياق الكلام على محاربة الكفار والمشركين وتكذيبهم للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وكفرهم بآيات الله، ليختم جلّ وعلا هذه الفقرة بقانون عام،
وهو قانون الاختيار في أفعال البشر، وأنَّ الله قد بيّن لهم أحكامه عبر إرسال الأنبياء بالكتب السماوية، وبعد كونهم مختارين, فإنّ عملهم هو الذي سيحدّد مصيرهم من سعادة أو شقاء.
هذا على مستوى السياق، وأمّا إذا أتينا إِلَى نصّ الآية فنجدها مؤلّفة من جملتين شرطيتين تليهما جملة بمثابة تعليل للشرطيتين.
الشرطية الأولى: وهي قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾، أي إِنَّ الإنسان أوّلاً هو الذي يعمل، فهو مختار، فإنْ كان عمله صالحاً موافقاً لما يحبُّه المولى وما يأمر به، فهو الذي سيستفيد من آثار ونتائج هذا العمل الصالح والحسن في الدنيا والآخرة، وبالتالي هو مَنْ سيرسم طريق سعادته من خلال عمله.
الشرطية الثانية: وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا﴾, أيْ إِنَّ الإنسان إذا لم يمتثل أمر مولاه فهو الذي سيتكبّد آثار وتبعات عمله، وبالتالي سيخطّ بذلك مسيره إِلَى جهنم.
وأمّا الجملة التي تلي الشرطيتين فهي قوله عزّ من قائل: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾، وهي بمثابة تعليل للشرطيتين, وذلك لأنّ المولى جلّ وعلا عادلٌ يعطي كلّ ذي حقّ حقَّه، ولا يظلم أحداً، فلا يضيع عنده أجر المحسنين العاملين، ويكون عمل كلّ إنسان هو الذي يحدّد مصيره الأخروي من النعيم أو الجحيم.
وعليه، فلنا القول: إِنَّ الآية دليل على نفي الجبر, إذ إنّه لا يعني إلا أنّ الله قد أجبر الناس على ارتكاب الذنوب ومع ذلك عاقبهم، وهذا معناه أَنَّه ظالمٌ لعبيده، والحال أَنَّ هذه الجملة الأخيرة تنفي ذلك، وتردّ على تلك العقيدة الفاسدة، وتكذّبها.
فالله ـ بحسب الآية ـ قد أعطى القدرة للبشر ليختاروا بين الخير والشرّ، فإن خالفوا واختاروا الشرّ عاقبهم، وإن أطاعوا واختاروا الخير أثابهم. فهو لا يجبرهم على ارتكاب القبائح والذنوب ثمّ يعاقبهم عليها، وإلا لكان ظالماً لهم، وإلى هذا
المعنى أشار الخبر الوارد عن الرضا عليه السلام عندما سُئِل من قِبَل أحد أصحابه: هل يجبر الله عباده على الذنب؟ فأجابه عليه السلام: “لا، بل يخيّرهم ويمهلهم ليتوبوا”، فسأله كذلك فهل يكلّفهم ما لا يطيقونه؟ فأجابه عليه السلام: “كيف يفعل ذلك، وهو يقول: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾” .
وبالاستفادة من هذا الخبر نكون قد أجبنا على السؤال الذي قد يُطرح حول السبب الكامن في تعبيره جلّ وعلا: ﴿بِظَلَّامٍ﴾, إذ لو لم يعطِ الله عباده القدرة والاختيار، ومع ذلك عاقبهم على المعصية، لكان ظلّاماً تعالى عن ذلك علوّاً كبيرا.
وهذه العقيدة القرآنية ممّا يرشد إليها العقل أيضاً, إذ مع كون الإنسان مجبراً غير مختار يكون عقابه ظلماً, إذ هو غير قادر على الفعل أو الترك، وتكليف غير القادر ظلم، وهو قبيح بحكم العقل، والمولى جلّ وعلا لا يفعل القبيح.
وإن شئتَ فقل: إِنَّ الفاعل للظلم لا يخلو عن أربع صور، والله منزهٌ عنها جميعا:
الصورة الأولى: أن يكون الظلم قد صدر منه، وهو جاهلٌ بأنّه ظلم.
الصورة الثانية: أن يصدر منه مع علمه به، ولكنّه مجبورٌ على فعله.
الصورة الثالثة: أن يصدر منه مع علمه به وقدرته على تركه، فيفعله لاحتياجه إليه.
الصورة الرابعة: أن يصدر منه مع علمه به وقدرته على تركه وعدم الحاجة إليه، ولكنّه يفعله عبثاً ولهواً.
وربّنا تبارك وتعالى عالمٌ، وفاعلٌ مختارٌ مقتدر، وغنيٌّ عن العالمين، وحكيمٌ لا يفعلُ ما فيه لهوٌ ولعب.
فلمّا انتفت كلّ أسباب الظلم في حقّه تعالى، وكان إثبات أيٍّ منها له مستلزماً للنقص فيه، مع أنّه محض الكمال، نكون قد أثبتنا بطريق عقلي أنّه تعالى عادل.
ونثبت بعد ذلك اختيار الإنسان بقولنا: بما أَنَّ الله عادلٌ فلا يعقل أن يكون الإنسان مجبوراً, إذ لو عاقبه على معصيته كان ظلماً، والمفروض أَنَّه عادلٌ ليس بظلام للعبيد، وتتناسب هذه العقيدة أيضاً مع وجدان الإنسان القائل بأنّ الإنسان مختار. وهذا ما يدركه كلٌّ منّا بوجدانه. وتشير الروايات الواردة عن أهل بيت العترة عليهم السلام إلى هذا المعنى، وإليك نموذجاً منها:
– ما رواه الشَّيْخ الصدوق بإسناده إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَسَاسَ الدِّينِ التَّوْحِيدُ وَالْعَدْلُ وَعَلَمَهُ كَثِيرٌ، وَلَا بُدَّ لِعَاقِلٍ مِنْهُ, فَاذْكُرْ مَا يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَيَتَهَيَّأُ حِفْظُهُ، فَقَالَ: “أَمَّا التَّوْحِيدُ فَأَنْ لَا تُجَوِّزَ عَلَى رَبِّكَ مَا جَازَ عَلَيْكَ، وَأَمَّا الْعَدْلُ فَأَلَّا تَنْسُبَ إِلَى خَالِقِكَ مَا لَامَكَ عَلَيْهِ” .
وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما سُئِل عن التوحيد والعدل: “التَّوْحِيدُ أَلَّا تَتَوَهَّمَهُ، وَالْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ” .
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله