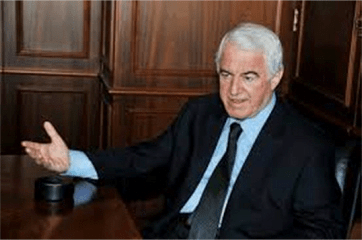مرّت ذكرى اغتيال ياسر عرفات على يد أرييل شارون فيما غزة في ذروة كفاحها ضدّ عدو صهيوني غاصب قرّر منذ زمن إعلاء شأن الأفكار العنصرية وهتك المبادئ الإنسانية التي تشكل حصناً للمجتمعات البشرية بوجه العصبيات القاتلة والغرائز البدائية.
وعندما قاتل ياسر عرفات ورفاقه شارون وجيوشه على الأرض الفلسطينية عام 2002 كان يشعر، تماماً كما أهل غزة اليوم، بحصار ثقيل على رام الله و»المقاطعة» التي تمّ عزلها عن العالم وتحويلها إلى حقل تجارب للسموم والأسلحة الإسرائيلية.
ولا بدّ أنّ ياسر عرفات في وحدته الأخيرة كان يعرف مصيره بعد أن تخلى عنه وعن قضيته ذوو القربى من أنظمة شديدة القسوة على شعوبها شديدة المرونة تجاه أعدائها. وإذا كانت غزة اليوم تدفع ثمناً غالياً بسبب دفاعها المستميت عن الأقصى المبارك والقدس وفلسطين وكرامة كلّ عربي وحرّ في العالم، فإنها في الوقت ذاته ترفع راية لن تُنكس مهما صبّ عليها الطيار الإسرائيلي من حمم يغرفها من البيوت الأميركية البيضاء والثكنات الأوروبية الصفراء التي اختارت احتضان المجزرة وإحياء شركاتها المتهالكة على حساب الدم الفلسطيني الذي يُسفك اليوم لتكتشف الإنسانية ذاتها بالضدّ من الانتقام الصهيوني الأميركي الأوروبي، وبالاتحاد مع أعظم قضية إنسانية في العصر الحديث.
لقد أصبح واضحاً أنّ دور واشنطن في هذه الحرب هو التماهي مع الموقف الإسرائيلي بكلّ أغراضه وإفرازاته مع تكليف خاص بتثبيت كلّ الأطراف، ومنعها من التحرك، ولو سياسياً، لدعم غزة كي يتسنّى للكيان الصهيوني أن يستكمل جريمته ضدّ فلسطين ويواصل حرب الإبادة والتهجير استجابة للحلم الصهيوني الشرير ودون الاكتراث بما تنطق به شوارع لندن وبرلين وواشنطن وسواها من العواصم الغربية بكلام حقّ يحاصر حكامها الذين فرّطوا بكلّ القيم التي ناضلت من أجلها الشعوب على مرّ الزمن.
وكلما تصاعدت هذه التظاهرات العالمية مندّدة بالعنصرية الصهيونية والانتهازية الأميركية ضاعفت تل أبيب من استخدامها للأسلحة المحرّمة دولياً من قنابل فوسفورية وقذائف مترعة بالنابالم واليورانيوم المنضب معلنة من فوهات المدافع انحطاط الحضارة الغربية وعودتها إلى أصولها الفاشية الاستعمارية. واذا كانت إدارة بايدن تحرّض تل أبيب وتشاركها الجريمة فلأنها تريد من خلال سحق غزة وتصفية القضية الفلسطينية هز العصا لكلّ الأصدقاء والحلفاء وحتى المعترضين همساً على السياسة الأميركية الإسرائيلية الجديدة التي تحتقر الحوار وحقوق الغير وتطلب من الجميع الإذعان والسكوت.
ومحاولة واشنطن تحقيق هذه الأهداف بهذه السرعة هي التي تفسّر ضيق الرأسمالية الأميركية من عجزها على متابعة دورها السابق الذي درجت عليه منذ تسلمت «الراية» الاستعمارية من فرنسا وبريطانيا. فالمحرقة توفر الوقت والاتصالات والتوصيات وتجعل من واشنطن أقوى على المسرح الدولي خاصة في صراعها المستميت ضدّ الصين التي بدأت تتفوّق عليها في ميادين الاقتصاد والبناء والتكنولوجيا.
أما على الجانب الإسرائيلي، فإنّ المحرقة الانتقامية التي يقودها تلامذة شارون وايتان ضدّ غزة الباسلة وأهلها الميامين فقد تخطت بحجمها ودمويتها مجزرة صبرا وشاتيلا (التي سقط فيها بيوم وليلة أكثر من ثلاثة آلاف شهيد فلسطيني ولبناني وسوري عام 1982).
وهذه المحرقة تكشف لجماعة الاستسلام والتطبيع أنّ «إسرائيل» الحقيقية ليست «إسرائيل» الديبلوماسية التي يلتقون معها في «المولات» والفنادق والمطارات، وإنما هي العقل المغلق والتعصّب المطلق، مثلما هي القنابل الرهيبة التي تُوجّه عمداً الى صدور المستشفيات والأطفال والأمهات لتذكير الجميع أنّ عليهم القبول بصداقة «إسرائيل» وإشرافها الأمني والتربوي مهما كلفهم ذلك من مشقة وإنكار للهوية وتزوير للحقيقة.
فالحقيقة ينطق بها الحمقى والغلاة وإنْ أحرجت الأصدقاء والحلفاء، هذا هو المستقبل الموعود وبديله الموت والدمار والدخان وإنْ شقّ حجب السماء.
أما أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية عام 1993 بتنازلات جوهرية فلم تحمل تل أبيب على تنفيذ «تعهّداتها» المقابلة، وإنما أخذت من الاتفاقية ما يناسبها لتنكّل بالشعب الفلسطيني وتقول له سواء قبلت أو رفضت فأنت مرفوض مرفوض، وليس أمامك سوى الهجرة أو الموت.
ولما أيقن ياسر عرفات انّ المنظمة وقّعت على وهم اسمه «أوسلو» عاد الى القتال مجدّداً مدركاً أنه متجه إلى موت محتوم يسبقه حصار لا تمتدّ يد للمساعدة فيه. اختار أن يمضي شهيداً وهو يعرف في قرارة نفسه أنّ فلسطين لن تحرّرها النداءات والخطابات والندوات، على أهميتها وضرورتها، وإنما النفوس المؤمنة المسلحة بالعلم والخبرة والمصمّمة على خوض معركة الحرية والاستقلال مهما كانت الآلام والتضحيات. كان اتكاله على شعبه بالدرجة الأولى وعلى طلائعه الشابة التي تفهم بالعمق ماهية المشروع الصهيوني ومشروعه الحقيقي الذي لا يترك مكاناً لأيّ «فلسطيني على أرض فلسطن». مع ذلك كان يرسل الرسائل والبرقيات رغم معرفته بأنّ أغلبية المرسل إليهم يتبرّمون من القضية الفلسطينية وأعبائها ومتطلباتها ومضاعفاتها، وما في علمهم أنّ إخضاع فلسطين – لا قدّر الله – هو مقدمة لإخضاع كلّ الدول العربية لسطوة كيان عنصري عدواني يعتبر نفسه فوق الدول والشعوب وغير معني بالمقاييس والمعايير الإنسانية أو الدولية وله أن يفعل ما يريد باسم معتقدات بالية نقضتها الحضارة الحديثة ونقضها العهد الجديد في كلّ كلمة نطق بها السيد المسيح.
إنّ غزة التي يتبارى أطراف غربيون في تعذيبها وإيذائها ونثر الملح على جراحاتها لا يمكن أن تسقط مهما انهالت عليها أطنان القنابل الأميركية التي يقودها طيارون من جنسيات متعددة، ولن تسقط مهما توغل الجيش الإسرائيلي في شوارعها وردهات مستشفياتها وباحات مدارسها، فهي أصبحت موجودة اليوم في كلّ بيت فلسطيني وفي كلّ بيت عربي وفي كلّ بيت حر يتمسك بقيم الحياة وحق الإنسان في الهواء والغذاء والدواء. إنّ غزة عصيّة على الموت، وكيف تموت وهي ترسم المستقبل بكلّ تفاصيله؟
* نائب ووزير سابق
.
أقرأ ايضا:
مشهد مصور عن حقائق من الميدان في غزة _ طوفان الاقصى
أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي
وإذا أراد الأميركي وقف العمليات ضده عليه وقف العدوان على غزة
#إِنّ_إِسْرائيلَ_تَجْنِي_فِي_جُنُونْ
ترويج الهدنة لشراء الوقت للعملية البرية وتنفيذها رهن بالفشل
الاحتلال الاستيطاني لفلسطين: طوفان الأقصى ليس من فراغ
مسؤول يمني كبير يكشف الأسلحة المستخدمة بقصف ‘إسرائيل’
المنهج الجديد في تربية الطفل
الشيعة وفلسطين _ الحلقة الاولى_ قراءة في عملية طوفان الاقصى
بناء المجتمع في دولة أمير المؤمنين عليه السلام
الثورة الإسلامية والغزو الثقافي
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله