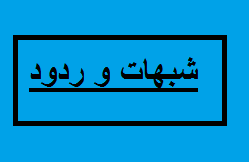الحديث طويل ومفصل جداً لكنني أذكر بعضه. ثم قال الإمام: لكن لا يجب الاكتفاء بالعقل وحده، بل يجب اقتران العقل والعلم؛ لأن العقل حالة غريزية وطبيعية توجد عند كل إنسان، لكن العلم، يربي العقل؛ فيجب أن يتربى العقل بالعلم. وفي حديث في نهج البلاغة يعبر عن العلم بالعقل المسموع، ويعبر عن العقل بالعلم المطبوع، أي يدعى العقل علماً والعلم عقلاً، بوجود فارق وهو أن أحدهما يسمى “مطبوع” أي فطري، والآخر “مسموع” أي مكتسب، وأكدّ كثيراً أن العقل المسموع والعلم المكتسب لا يكون مفيداً إلا أن يتحرك ويستعمل العقل المطبوع والعلم الفطري أي أن الإنسان الذي يأخذ فقط يكون كالمخزن. وهو مذموم في الروايات.
كلام “بيكن”
ننقل جملة مشهورة ورائعة عن “بيكن” يقول فيها: العلماء ثلاثة أصناف: فبعضهم كالنمل يجلب الحبوب من الخارج ويخزنها دائماً. فذهنهم مخزن، وفي الحقيقة انهم مسجل يسجل كل ما سمعوه. ومتى أردت ذكروا لك ما تعلموه. أما الصنف الثاني فهم كدودة القز تنسج من لعابها نسيجاً وتخرجه منها. وهذا أيضاً ليس عالماً حقيقياً لأنه لا يكتسب شيئاً من الخارج. يريد أن يصنع من خياله وباطنه، وعاقبته أن سيختنق داخل شرنقته. وأما الصنف الثالث فهم العلماء الحقيقيون. فهؤلاء كالنحلة، يمتصون رحيق الورد من الخارج ثم يصنعون العسل في داخلهم.
فمسألة العقل المسموع والمطبوع هي ما تبينها الرواية. فإذا لم يُضَمّ العلم المسموع إلى المطبوع لا يكفي ذلك. فما يكتسبه الإنسان من الخارج عليه أن يضيفه إلى القوة الباطنية وقوة التحليل ليصنع منه شيئاً مفيداً.
ثم قال الإمام (ع): “يا هشام! ثم بَيَّنَّ أن العقل مع العلم” أي يكون العقل ملازماً للعلم، ولهذا قال تعالى: (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون). (سورة العنكبوت، الآية: 43). أي يجب أن يكون الإنسان عالماً أولاً ويهيئ المواد الأولية، ثم على العقل أن يملل ويحقق. فلو كان لنا عقل قوي كابن سيناء، يقول القرآن ان “التاريخ” عبرة ودروس جيدة؛ لكنني لا أملك معلومات واطلاعاً عن التاريخ، فماذا يفهم عقلي؟ أو يقولون لنا: توجد علائم وآيات الله في عالم التكوين، إضافة إلى ذلك فإن عقلي من أقوى العقول أيضاً، لكنني جاهل بالمواد المستعملة في هذا البناء، فماذا أفهم بعقلي وكيف اكتشف آيات الله؟ يجب اكتشافها بالعلم وادراكها بالعقل.
مسألة التقليد
وهكذا قال (ع): يا هشام: “ثم ذم الذين لا يعقلون” فقال: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) (سورة البقرة، الآية: 170).
لقد حارب القرآن مسألة التقليد بشدة، وهي بالاصطلاح المعاصر “اتباع سنة الماضين أي قبول ما كان سابقاً وحالة الاتباع والتقليد الأعمى للآباء والأسلاف لمجرد أنهم آباء وأجداد. إن كل نبي في مواجهته لأمته كان يؤكد مسألة خاصة ويدعو الناس إليها، ولكن هناك عدة أشياء مشتركة بيّنها الأنبياء جميعاً. فمثلاً التوحيد من الأمور المثبتة والمشتركة التي أكدها الأنبياء. إن تقليد السلف أدى بالجميع إلى القول: “إننا لن نقبل كلامك لأنه جديد، وقد رأينا آباءنا على دين آخر، ونحن نتبع سبيل آبائنا” فحالة التسليم في مقابل الماضين هي حالة مضادة للعقل. يريد القرآن من الإنسان أن يختار طريقه بحكم العقل، فمحاربة القرآن للتقليد بمعنى “اتباع السنة الماضية” هي لحماية العقل.
اتباع الأكثرية
أما الموضوع الآخر فهو موضوع العدد، فكما ان الإنسان يتبع الماضين كفصيل الحيوان، فانه عندما يكون إمام الجماعة يسعى ليكون كالجماعة، يقولون “ان تخشى الفضيحة فكن كالجماعة”. عندما تكون الجماعة مفتضحة، فالكون كالجماعة مفتضح أيضاً. لكن ميل الإنسان ليصبح كالجماعة شديد. يكثر هذا الأمر عند الفقهاء، فيستنبط فقيه ما مسألة لكنه لا يجرؤ على ابرازها فيبحث آراء فقهاء عصره، ليرى هل يوجد من يوافق رأيه أم لا؟ وقليل من الفقهاء من لا يجرؤ على إظهار فتواه مع عدم وجود موافق لها. أي أنه يستوحش عندما يرى نفسه وحيداً في الطريق وكل الأمور كذلك؟
ولكن الانفراد بالرأي اصبح شائعاً الآن، وان الغربيين اشاعوا ذلك؛ وافرطوا فيه، كل يسعى لأن يكون بشكل خاص ليقال: إنه ذو فكر جديد. تماماً بعكس القدماء الذين يخشون إظهار رأيهم لو انفردوا فيه ولأجل أن لا يقال بانهم وحيدون يعلنون ان هناك مجموعة موافقة لرأيهم، يصرح ابن سينا بأن كل ما أقوله هو من لسان أرسطو، لأنني لو قلت أنه منّي فسوف لن يقبله أحد. يصر “الملا صدرا” على ذكر كلام القدماء ويوجه كلامه به؛ لأن اتباع الجماعة كان شائعاً في ذلك الوقت. أما الآن فبالعكس، إذا ذكر شخص كلاماً كان قد قاله غيره فليست له أية قيمة. وعلى أية حال فإن القرآن يذم اعتبار الكثرة هي الملاك ويقول الكثرة ليست هي المعيار.
يقول الإمام علي (ع): يذم القرآن الكثرة حين يقول: (وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون). (سورة الأنعام، الآية: 116). وهذا شكل آخر لاستقلال العقل والدعوة إلى أن يكون العقل هو المعيار.
عدم الاهتمام بتشخيص الناس
يعقب الإمام على هذا الموضوع ويقول: يا هشام! لا تبالِ بكلام الناس ولا بتشخيصهم، يجب أن يكون التشخيص والتمييز هو تمييزك. يا هشام لو كان في يديك جوزة وقال الناس إنها لؤلؤة، ما كان ينفعك، وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما كان يضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. أي عليك أن تتبع تشخيصك وعقلك وفكرك وتجعله دليلاً لك.
إلى هنا ينتهي بحث العقل. وسنطرح في البحث القادم مسألة الإرادة التي هي تتمة لبحث العقل.
تاريخ التعقل من وجهة نظر المسلمين
كان البحث حول تربية الاستعداد العقلي والفكري، وأوضحنا أن الإسلام يستمد العون من العقل دائماً، أي عندما يدعو الناس فإنه يحرك عقولهم أيضاً، فلا يقول: إذا آمنتم لا تفكروا ولا تتعقلوا فإن التعقل لا يوصل الإنسان إلى شيء، وان الإيمان هو مرحلة غير التعقل والتفكير، وان على الإنسان أن يسلم أمره لتنكشف له حقيقة الإيمان، وما أشبه ذلك من الكلام الذي نراه في المسيحية بكثرة.
ولكن هناك موضوع يحسن بحثه ذلك أننا نشاهد ما يعاكس هذا الكلام، ففي القرآن يقدّس العقل ويعظّم ويستعان به، ولكن كثيراً ما يشاهد في منطق المسلمين تحقير العقل والعلم.
يحقر العقل كثيراً في أدبنا العرفاني وغيره؛ إضافة إلى ذلك حدثت وقائع في تاريخ الإسلام عرضت مسألة العقل فيها؛ أحدها حديث الأشعري والمعتزلي والأخرى مخالفة قياس أبي حنيفة في الفقه والثالثة مسألة العرفان والتصوف. هذه الحوادث الثلاث يجب بحثها. نواجه هنا ثلاثة مذاهب كل واحد منها يخالف العقل بطريقة ووجهة خاصة به وعندما ننتهي من هذه المذاهب الثلاثة، نجد أحاديث متفرقة لها حكم المثل الشائع بين الناس ولهذه الأمور أثر تربوي عظيم. وسنبدأ أولاً من هذه المتفرقات وبعد ذلك نشرع بعرض تلك المذاهب الثلاثة.
تحقير العقل في الأدب والأمثال السائدة بين الناس
ينتقد العقل والفهم أحياناً في هذه المتفرقات بأنهما عدو للإنسان، بمعنى أنه يسلب الراحة والهدوء من الإنسان. لماذا؟ لأنه إن لم يكن للإنسان عقل وفهم فانه لا يشعر ولا يحس بالهموم والآلام. مثلاً يقول الشعر المعروف:
عدو روحي، عقلي وفهمي ليتها اغلقت عيني وأذني
ونقول أحياناً: “هنيئاً لفلان لأنه لا يفهم بعض الأمور” أو “هنيئاً لك، كم أنت مرتاح لعدم فهمك، أنا سيئ الحظ لأنني أحس وأفهم”. يقول القرخي اليزدي وهو من الشعراء الثوريين في النصف التالي للقرن الأخير:
رأت أموراً لم تحسن رؤيتها، والله إن قاتلي هي عيني الناظرة.
وهناك كثير من هذه النماذج. فهل هذا المنطق صحيح أم لا؟
لو أردنا أخذ ذلك بعين الجد والاعتبار فهو غير صحيح. ان أغلب القائلين بهذا الكلام باصطلاح علماء معاني البيان، أرادوا توضيح وبيان ما يلزم الموضوع لا بيان نفس الموضوع، أي أن الذي يقول “عدو روحي هو عقلي وفهمي، بل يريد أن يقول: “الألم” موجود ولكن عندما يريد أن يقول أن “موجبات الألم” موجودة، فيبين ذلك بهذا التعبير: “رأت الأشياء التي يحسن أن لا تراها، فوالله ان قاتلي هي عيني الباصرة”.
ينظر بذلك إلى الأمور الاجتماعية وأنه يرى القلة والنقصان في المجتمع. وهذه ستكون قاتلته، وقد قتلوه في النهاية. وانكم لو قلتم للسيد القرخي نفسه: هل ترجح أن تكون كفلان الذي لا يشعر ولا يدرك أي شيء وتحصل لك حالة عدم الاهتمام وعدم الاعتناء؟ لقال: كلا.
ويمكن أن يستدل بالعقل على ضد العقل، بان عقل الإنسان يسبب الاحساس بالألم والألم الذي هو سيئ وقبيح فكل شيء يسببه سيئ أيضاً.
والجواب عن هذا واضح: الألم الذي نسميه قبيحاً له فلسفة، الألم ليس حسناً بمعنى أن مسببه يجب أن لا يوجد. حينما نقول من الأفضل أن لا يوجد الألم نعني من الأفضل أن لا يوجد موجب الألم؛ وإلا فلو كان المسبب لكان النقص والمرض موجوداً. فالألم إعلان ومعرفة للإنسان. الألم الجسمي كذلك أيضاً. وإنما يحسن الإنسان بداءً في جسمه بسبب وجود ألم عنده، وبهذا المرض تعلن له الطبيعة (وجود نقص ما). كالضوء الأحمر الذي يضيء أمام السائق ويخبره بأن زيت السيارة قليل أو أن البترول على شرف الانتهاء. إن الإنسان يتالم عندما يقل زيت السيارة، سيحترق محرك السيارة الآن مثلاً. من البديهي أنه لا يمكن القول بأن إنارة الضوء الأحمر شيء قبيح، لأن هذا الضوء يخبر بوجود نقص في هذا المكان.
فإن لم يكن الألم، لم يشعر الإنسان بالنقص، وفي النتيجة لم يعالج العضو المريض. إذاً نفس الألم ليس قبيحاً، إنما القبيح هو ما يخبر عنه الألم. الألم هو سوط على الإنسان ليتابع العلاج. ولهذا فإن أسوأ الأمراض هو الذي لا ألم فيه، أي أنه يفاجئ ولا يخبر، كبعض الأمراض السرطانية التي يطلع عليها الإنسان في وقت متأخر لا فائدة فيه؛ ولو أنه علم به في اللحظة الأولى من الإصابة بالسرطان لكان قابلاً للعلاج.
عقل الإنسان وفهمه وإدراكه غير محكوم، لأنه منشأ الشعور بالألم. لأنه حاسة المعرفة والإعلان، وهو في النقطة المقابلة لعدم الاحساس. ولهذا فاننا نرى في أدبنا موضوعاً رائعاً جداً هو أننا لو اعتبرنا هذا “الانتقاد للعقل والفهم”، جدياً، فان ذلك، يقع في الطرف المقابل له، وهو مدح الألم: “إلهي أعطني قلباً عارفاً بالهموم والآلام”. لماذا مدحوا الألم في مواضع أخرى؟
إنهم التفتوا إلى أن وجود الألم يعني وجود المعرفة والاطلاع، فالتألم هو سوط لأجل الحركة والبحث عن العلاج، وعدم التألم وفقدان الألم هو السكون وعدم الشعور. شعر رائع لمولوي في هذا المجال يقول: “الحسرة والبكاء الذي في المرض، هو يقظة وصحوة وقت المرض”.
الآلام الموجودة حين المرض، وأحاسيس المريض، هي يقظة للمريض، تعلن للمريض أن اعلم ما بك مريض، ثم يقول: “إذاً اعلم أن هذا الأصل يا طالب الاُصول، ناله من هو مصاب بالألم”. إن أصحاب الألم ذاقوا الحقيقة. والذي لا يحس بالالم هو موجود عديم الإحساس وجماد. “من كان كثير الألم فهو كثير الذكاء والصحوة، ومن كان كثير العلم والاطلاع فهو كثير الاصفرار في الوجه”.
انتبهوا إلى هذه المسائل الإنسانية؛ فشخص لا أبالي، مشغول بحضيرته فقط. وكل ما يطرق سمعه لا يكترث به، ولا يهتم. وتمام همه أن يقضي أعماله وكما يقال: همه أن يعبر حماره الجسر. وعندما يعبر حماره “كما يقول جلال آل أحمد” لا يهمه انهدام الجسر؛ لأن حماره عبر على أية حال. ولكن تصوروا إنساناً متألماً ومريضاً في مقابل ذلك، فان الشيء الوحيد الذي لا يفكر به هو حماره.
تعبير أمير المؤمنين هنا هو “الألم” أيضاً يقول في الرسالة التي بعثها إلى عثمان بن حنيف:
وحسبك داءً ان تبيت ببطنةٍ وحولك اكباد تحن إلى القدِّ
فهناك إنسان [يحس بالألم] عندما يرى الآخرين جياعاً وهو شبعان وبتعبير الإمام (ع): “ولعل بالحجاز أو اليماُمة من لا طمع له في القرص”[1] . فهو شبعان في الكوفة في حين يوجد جائع في الحجاز على بعد مسافة أربعمائة فرسخ؛ إنه يحس بالألم لجوعه.
المرض والتألم ممدوح أم مذموم؟
والسؤال: هل وجود ذلك الألم أفضل أم الأفضل أن لا يشعر الإنسان بما يجري حوله، ولا يتأسف حتى وان ذبح جاره؟ إننا نعتبر الأول إنساناً متكاملاً لا الثاني، لأن ذلك التألم هو الاحساس والشعور وليس بمرض، ولا نقص، بل هو الكمال، أي أنه علاُمة ارتباطه مع الإنسان الآخر، يبين أنه في الحقيقة يشعر بأنه عضو من اعضاء جسد واحد، وأنه يتألم ويضطرب لأجل مرض وجرح العضو الآخر.
للرسول (ص) جملة بهذا الصدد صاغها الشاعر سعدي شعراً: “مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم “مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”[2] . فعندما يتألم أحد الأسنان، فلا تقول سائر الأعضاء لا علاقة لنا بك، تحمل الألم وحدك حتى الموت. كلا، بل حينما يتألم عضو فإن سائر الأعضاء ستواسيه. كيف تواسيه؟ بالسهر والحمى. فعندما يتألم موضع فإن جميع البدن سيصاب بالحمى والسهر. يقول (ص): المؤمنون هكذا، مواساة وشعور، ولهذا لا وجود للنقص، بل هو عين الكمال.
فالمنطق المؤيد لعدم الشعور والإحساس بحجة أن الإحساس هو منشأ المرض والألم، منطق خاطئ، ومضاد للإنسانية، وإن الإسلام يرفضه ويثني على هذا النوع من الألم. ولكن إذا لم يكن الكلام جدياً، بل يريد الشخص بيان الموضوع على نحو الكناية، ويريد القول بأن في الخارج كذا وكذا، لكنه يبين ذلك بالعبارة المذكورة [فلا إشكال في ذلك في هذه الحالة]. كما نقول أحياناً: ليتني عميت ولم أر الشيء الفلاني” فالمقصود هو أن ذلك الشيء مؤلم جداً، بحيث أتمنى أن أفقد بصري ولا أراه، انه في الحقيقة يريد بيان قبح الشيء وفظاعته.
التعقل في رأي المعتزلة والأشاعر
لننتقل الآن إلى الحوادث التي أدت إلى ظهور مذاهب منها، المذهب الأشعري والمعتزلي. وان أكبر الضربات التي وجهت إلى تعقل المسلمين في تاريخ الإسلام كان من هذين المذهبين.
في أواسط القرن الثاني للهجرة ظهرت في عالم الإسلام حركتان حول التفكر في اُصول العقائد الإسلامية. ذهب بعض إلى أن العقل يمكنه أن يكون مقياساً وحده لإدراك اُصول العقائد الإسلامية. وعلينا أن نعرض جميع المسائل، المربوطة بالله والمعاد، والملائكة، والنبوة والأحكام وغيرها على العقل أولاً، وان العقل مقياس قطعي للإنسان. سميت هذه المجموعة ـ التي لها جذور تاريخية ـ بالمعتزلة. والمجموعة التي تقابلهم، هم الجماعة التي سميت “الأشاعرة” القائلين بضرورة التعبد والتسليم الكامل. وأنه لا يحق للعقل أن يتدخل في مسائل الإسلام.
الحسن والقبح العقليين
يرجع أصل هذا الكلام إلى موضوع “الحسن والقبح العقليين” المعروف. فاعتقد المعتزلة بأن للأفعال في حد ذاتها حسناً ذاتياً أو قبحاً ذاتياً، وان عقل الإنسان يدرك ذلك الحسن والقبح ومن هنا يكتشف حكم الإسلام؛ لأن حكم الإسلام لا يمكن أن يختلف عن العقل.
أقوى أمثلتهم على ذلك مسألة العدل والظلم. قالوا: العقل، يدرك حسن العدالة وأنه أمر ذاتي وليس مجهولاً، فلم يجعل أحد للعدالة حسناً كما لم يضع أحد للعدد أربعة خاصية الزوجة.
إن حسن العدل وقبح الظلم كذلك. والآن نأتي إلى الأفعال: هذا العمل ظلم، وبما أنه ظلم فهو قبيح قطعاً، ولأن الله تعالى لا يقبل القبيح إذاً فهو منهي عنه حتماً.
قال الأشاعرة: ليس للاشياء حسن وقبح ذاتي أبداً. ولا حكم للعقل في مثل هذه المسائل، الحسن والقبح أمران شرعيان. فكل ما أمر الله فهو حسن، لأن الله أمر به، لا أن الله أمر به لأنه حسن وكل ما نهى عنه تعالى، فإنه قبيح، لأن الله نهى عنه، وليس لكونه قبيحاً، فان الله نهى عنه.
قال المعتزلة: كل ما أمر به الله بما أنه كان حسناً فأمر به الله، إذاً حسنه مقدم على أمر الله، وحسنه علة لأمر الله. وقال الأشاعرة: كلا، بما أنه أمر به الله فهو حسن، وأمر الله هو علة الحسن، فعندما نقول: إن هذا العمل حسن يعني أن الله أمر به، وهكذا في النهي.
——————————————————————————–
[1] نهج البلاغة، الرسالة 45.
[2] الجامع الصغير، ج2، ص155.
 الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله
الولاية الاخبارية موقع اخباري وثقافي لمن يسلك الطريق الی الله